
اليابانيون والمصريون بينهما مفارقات عديدة على آفاقٍ شتى. وسأتطرق فى هذا المقالِ لواحدٍ فقط من هذه المفارقات وهى مفارقة ثقافية. فالمصرى الذى لا يجيد واحدةً من اللغاتِ الأوروبية الأساس لا يمكن أن يكون ذَا محصول معرفي/ ثقافي/أدبي/ فنى ثرى ومتكامل ومتوازن.
والسبب هو أن مجتمعَه ترجم القليل جدا من الإبداعاتِ الإنسانية خارج مجالات العلوم التطبيقية وأقصد روائع مجالاتِ التاريخ والفلسفة والآداب والفنون وسائر العلوم الاجتماعية بشتى تجلياتها. لذلك، فمهما كان المثقف الذى لا يقرأ إلاّ بالعربية دؤوبا ومهما كان قارئا نهما، فمن المستحيلات أن يصبح مثقفا كبيرا.
ومعروفٌ أن طه حسين كان من غلاةِ المؤمنين بأن ثقافةَ المصرى لا تكتمل بدون أن يكون قارئًا بواحدة من اللغات الأوروبية الأساس. والذى لم يقله طه حسين أن هذا المطلب يختفي/ ينعدم إذا كان مجتمعُنا يُؤْمِن/ ويوفر وجود ترجمات باللغة العربية لكافة الإبداعات فى سائر مناحى العلوم الإجتماعية والإنسانية. وحال الإنسان اليابانى ليست فقط مختلفة بل هى نقيض حال الإنسان المصري. وليست الميزة للمواطن اليابانى وإنما لمجتمعه.
وكاتب هذه السطور كان محظوظًا إذ أتاحت له ظروف حياته أن يزور اليابان كثيرًا وأن يلتقى ويتحاور مع يابانيين من قمة المجتمع (أمراء، وزراء، رؤساء مؤسسات كبرى) لمختلف القطاعات الأكاديمية والتعليمية والثقافية والفنية، وأن يتحاور مع الكثير من المواطنين العاديين.
وقد لمستُ بشكلٍ مباشر وواضحٍ أمرين: الأول هو الثراء المعرفى والثقافى مقارنة بالأوروبيين، والثانى هو كون السواد الأعظم منهم لا يجيد لغة غير لغته الأم. وذات يوم كنت مدعوًا على العشاء بمنزل مدير مكتب مصر للطيران فى موسكو والذى كنت أعرفه هو والسيدة زوجته من قبل معرفة شخصية وطيدة (هو حسين عبدالناصر شقيق الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر وقرينته نوال ابنة نائب رئيس مِصْرَ الأسبق عبدالحكيم عامر وهى شقيقة زميل الدراسة صديقى جمال عبدالحكيم عامر).
وبجانب حضور سفيرة مصر باليابان وقتها (السفيرة الجليلة مرڤت التلاوي) فقد تكرّم يومها الأستاذُ حسين عبدالناصر بدعوةِ عددٍ من رؤساءِ الجامعات والمفكرين والأدباء والصحفيين اليابانيين وهو ما جعل السهرةَ بمثابةِ صالون ثقافي.
وكانت السلبيةُ الوحيدة هى أن معظمَ الحاضرين كانوا لا يجيدون أية لغةٍ غير اللغة اليابانية - لذلك شارك فى الجلسة عددٌ من المترجمين. ليلتها لمستُ بنفسى كون الحاضرين موسوعيين وأنهم قرأوا كلاسيكيات وإبداعات البشرية من هوميروس (القرن الثامن قبل الميلاد) لأحدث أدباء وشعراء ومفكرى وفلاسفة عصرنا.
وعناصر الصورة السلبية لهذه المعضلة فى مِصْرَ الآنية هى:
- قلة المترجمات للعربية فى كل مجالات الأدب والفلسفة والسياسة وعلم الإجتماع وباقى فروع العلوم الإجتماعية والانسانية.
- أن أبناء معظم الطبقات باستثناء الطبقة العليا يتعلمون فى مدارس لا تجعلهم قادرين على القراءة بلغات أجنبية.
- أن أبناء الطبقة العليا يتقنون لغة أو لغتين أوروبيتين، ولكنهم لا يقرأون بالعربية (لا يستطيعون، وأحيانًا لا يحبون).
وبتوافر هذه الظواهر المجتمعية الثلاث تكتمل المعضلة/الإشكالية!.
ولا أستطيع أن أختم هذا المقال دون أن أتطرق لبعدٍ آخر هو علاقة معظم المصريين الحاليين باللغة العربية (لغتهم الأم). فالسوادُ الأعظم منهم لا يتقنونها. وكثيرون لا يفتخرون بها كما يفتخر الفرنسى بفرنسيته وكما يفتخر السورى بعربيته.
وعندى (بصفة شخصية) فإن هذه آفة ثقافية/ مجتمعيةٍ لا يجوز أن نستهين بها وبعواقبها. وكم يحزن كاتبُ هذه السطور عندما يستمع لشخصٍ مصريّ يُلقى خطبةً كُتبت له، ومع ذلك تتوالى الأخطاء فى سيلٍ منهمرٍ: غلطات نحوية وكوارث صوتية (وأقصد من ناحية علم الصوتيات Phonetics).




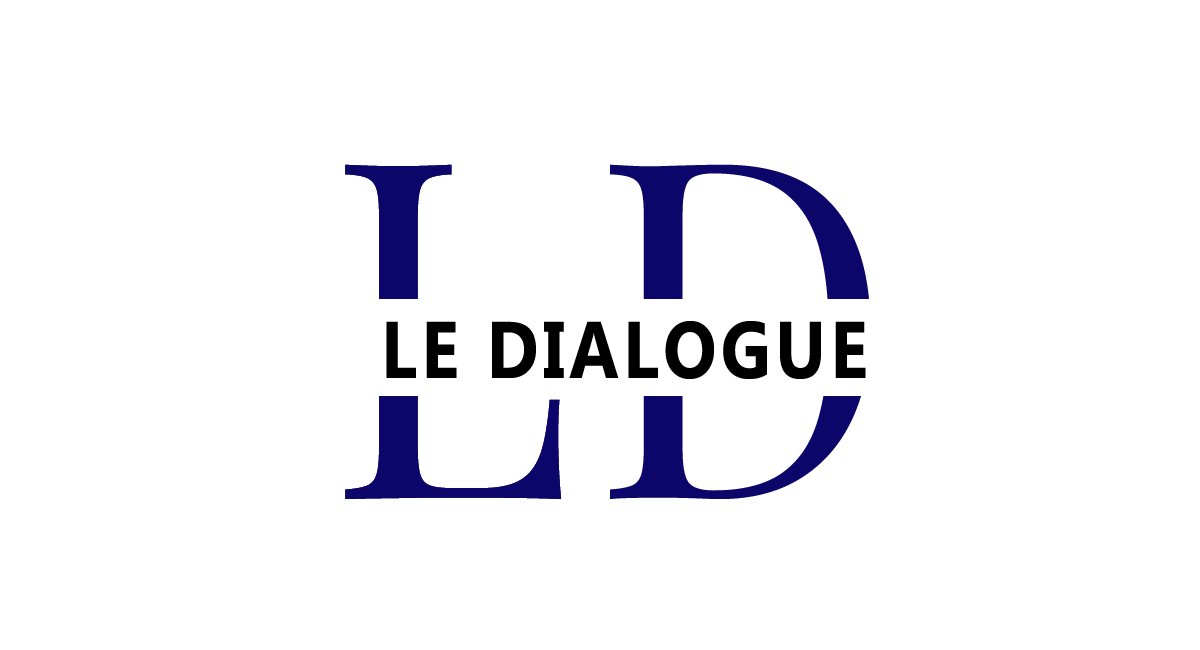 بالعربي
بالعربي
