
يعتبر كثيرون أن الحملة الفرنسية التى قادها نابليون بونابرت كانت بمثابة الصحوة لا لمصر وحدها ولكن للشرق كله لكى يكتشف الجميع أنهم ليسوا وحدهم فى ذلك العالم وأن هناك أممًا أخرى وحضارات موازية، لقد اختلفت الآراء حول الحملة الفرنسية فهناك من يراها نموذجًا للغزو العسكرى الذى يخفى أطماع الدول الأوروبية الاستعمارية حيث كانت جزءًا من التنافس البريطانى الفرنسى على مصر وغيرها من ممالك الشرق، بينما يراها آخرون حملة حضارية أدت إلى نقلة نوعية فى اتجاه الدولة المصرية الحديثة.
ويكفى أن نتذكر أن كتاب وصف مصر هو كتاب أسطورى كتبه علماء الحملة الفرنسية الذين استقدمهم نابليون معه، وكتبوا عن مصر الزراعة والصناعة والحيوانات والطيور والآثار حتى بدا الأمر وكأن مدافع الحملة كانت هى أبواق الإيقاظ للأمة المصرية من سبات عميق.
ولقد كتب الفيلسوف المصرى الكبير فؤاد زكريا منتقدًا من يهاجمون الحملة بقوله: إن دهاء التاريخ لا ينصف إلا من يستحق.. فكيف نقول عن الحملة المصرية فى اليمن أنها كانت تحررية قومية بينما نستكثر نفس الشيء على الحملة الفرنسية التى كانت حملة ثقافية تنويرية بكل المعاني.
ولقد تحولت مصر بفضل السنوات القليلة التى عاصرت الوجود الفرنسى فى مصر لتصبح دولة فرنسية الفكر والثقافة أيضًا وهى حاليًا عضو فى المنظمة الدولية للفرانكفونية التى كان أحد رموزها د.بطرس غالى المصرى وأمين عام الأمم المتحدة الأسبق كما أن الوجود الثقافى الفرنسى فى مصر من سنوات الحملة الثلاث يفوق كثيرًا الآثار التعليمية والثقافية للوجود البريطانى الذى عاش فى مصر أكثر من سبعين عامًا.
ولقد تأثرت الجامعات المصرية بعد ذلك ومراكز البحث ونوادى الثقافة بالروح الفرنسية بدءًا من القانون حتى أن المجموعة المدنية المصرية هى استقاء مباشر من القانون الفرنسى ((Code Napoléon كما أن كتاب وصف مصر يظل هو أهم كتاب صدر فى مصر فى القرنين الماضيين.
كذلك فإن المدارس الفرنسية فى مصر تعتبر أرقى فى مجملها عن المدارس الأجنبية الأخرى حيث إن الفرنسيين شديدوا الولاء لثقافتهم بالطبيعة ويعتبرون أن الثقافة هى التى تربط الشعوب وتجمع الأمم وتقوى الأواصر بين البشر، لذلك عندما انتهت الحرب بين الجيش الأمريكى ومتمردى طالبان سارعت الدول الكبرى بفتح سفاراتها فى كابول.

بينما سعى الفرنسيون إلى فتح أبواب مدارس الليسيه لأنهم يؤمنون بأن الثقافة هى العامل الحاكم فى العلاقات الدولية المعاصرة ويعولون كثيرًا على انتشار الثقافة الفرنسية لكى تصبح إلهامًا للشعوب ونبراسًا للأمم ونموذجًا حضاريًا أمام دعاة الحرية التى جاءت بها الثورة الفرنسية التى لم تغير الأوضاع فى أوروبا وحدها بل أصبحت مخزونًا ثقافيًا وفكريًا لكافة النظم السياسية والمجموعات القانونية فى العصر الحديث.
ومن الأمور الملفتة للنظر أن المصريين ينظرون إلى من يتحدثون الفرنسية باعتبارهم أرقى من غيرهم وأكثر تحضرًا لأن الفرنسية هى لغة الفلسفة والآداب والفنون ولذلك ينظر إليها الجميع بالاحترام والتقدير، ولقد كان من مقومات الفتاة المصرية حتى عهد قريب والتى تؤهلها للزواج الناجح أن تتحدث الفرنسية وتعزف على البيانو كرمزين كبيرين للتحضر والارتقاء.
إن رؤيتنا فى الثقافة الفرنسية فيها قدر كبير من الاحترام والتوقير ونرى أن المنافسة بين الثقافتين الأنجلوسكسونية واللاتينية قد تصب فى صالح الأولى بسبب ثقل الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها امتدادًا ثقافيًا للمملكة المتحدة بينما فرنسا تواجه وحدها المنافسة الحادة وتقدم للإنسانية نماذج مبهرة على الأصعدة الأدبية بل والعلمية أيضًا، وفى مصر مركز ثقافى نشط ومعهد للآثار وجامعة مستقلة بالإضافة إلى عشرات المدارس للبنين والبنات فى مقدمتها مدارس الجيزويت والفرير والمرديدى والسكاركير.
وعلى الجانب الآخر تتميز العلاقات المصرية الفرنسية بروابط وثيقة، وعلى المستوى السياسى يظل اسم شارل ديجول مضيئًا كرمز للاستقامة السياسية والتحرر الوطني، وما زلنا نتذكر برقية عزائه فى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عام ١٩٧٠ وما تضمنته من إشارات بالغة الاحترام والتقدير وهو الذى أعلن قبل حرب عام ١٩٦٧ أن بلاده سوف تمتنع عن تصدير السلاح لأى جانب من الجانبين يكون المبادر بالحرب والعمليات العسكرية.
وقد أوفى ذلك الزعيم العملاق – شكلًا وموضوعًا – بما تعهد به وظل شخصية عظيمة وفريدة فى تاريخ أوروبا الحديثة، ولا ننسى أنه كان الرئيس المنقذ الذى أدى إلى خلاص فرنسا مرتين الأولى فى الحرب العالمية الثانية فى مواجهة العدوان النازى والثانية فى موقفه العقلانى عند استقلال الجزائر.




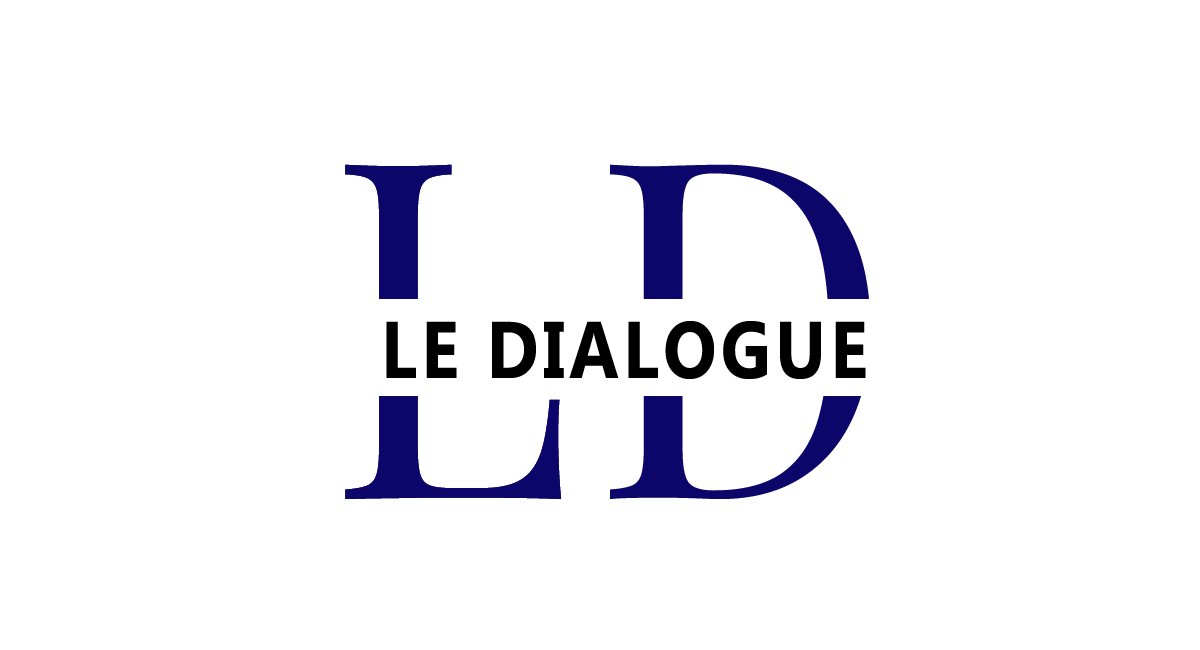 بالعربي
بالعربي
