
تطور هائل قطعته المدرسة الصوفية في طريقة المدائح النبوية والابتهالات والأناشيد الدينية، جعلها في مكانة رفيعة بين الأدب الإنساني العالمي العابر للأديان والثقافات واللغات، كونها تضم حالة عاطفية راقية معبرة عن شوق إنسان تجاه خالقه، أو معارج روحية لأولياء تطوف في سماء العشق الإلهي، باحثة عن لحظة يمكن فيها إدراك حالة الفناء التي يتغنى بها الصوفي في وجده الدائم.
وتظل قصائد شعراء الصوفية محل اهتمام من المنشدين والمغنيين لما فيها من قيم روحية سامية، مثلتها كلمات كل من الحسين بن منصور الحلاج، وعمر بن الفارض، ومحيي الدين بن عربي، وسمنون المحب، وغيرهم.
بدأ فن المدائح والقصيدة الدينية في صورة مرتبطة بالحدث السياسي والوقائع التي اختلطت بها وعبرت عنها، فمثلا قصائد الشاعر حسان بن ثابت تتحدث عن مكانة النبي بين قومه ونسبه الشريف وكلها أمور تعكس السياق الذي يتحرك فيه حسان بن ثابت، فهو يمدح شخصية عظيمة بين قبائل تتفاخر بالنسب الأصيل، ويهاجم مشركي مكة من خلال إنزال النواقص بهم، وكلها تعكس نوعا من الحماسة والانفعال المباشر لشاعر منغمس وسط الأحداث وجزء منها.
وكان من أبرز ما اشتهر لحسان بن ثابت على لسان المنشدين قوله: وأحسن منك لم تر قط عيني/ وأجمل منك لم تلد النساء/ خلقت مبرأ من كل عيب/ كأنك خلقت ما تشاء".
جاءت المدرسة الصوفية الموسومة بـ"العرفان"، أي الوصول إلى المعرفة عن طريق القلب، وغيرت كثيرا من المفاهيم ووضعت لونا جديدا من التعبير عن الذات والمعاملات، والغوص داخل المشاعر الإنسانية، لمعرفة أسرارها، هذه المدرسة التي طورت فنون الحب وطرق التعبير عنها، ووضعت برامج روحية لدخول في عالم المكاشفات والشواهد لم تنغلق علة نفسها بل تطورت هي أيضا من الداخل على يد فرسانها مثل ابن عربي.
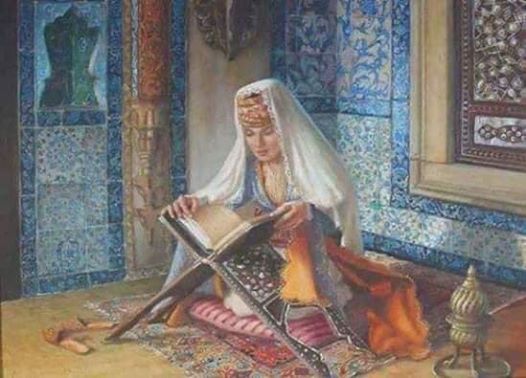
شهيدة العشق الإلهي
تطورت الحالة العرفانية الصوفية ونضجت بداية من القرن الثاني الهجري مع المتصوفة الشهيرة السيدة رابعة العدوية، وإليها تنسب هذه الأبيات المشهورة والتي يتغنى بها المنشدون والمبتهلون دائما، حيث تقول: "أحبك حبين: حب الهوى/ وحبًا لأنك أهل لذاكا/ فأما الذي هو حب الهوى/ فشغلي بذكرك عم سواكا/ وأما الذي أنت أهل له/ فكشفك للحجب حتى أراكا/ فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي/ ولكن لك الحمد في ذا وذاكا".
وعن الأبيات المنسوبة هذه، يرى الدكتور عبدالرحمن بدوي في كتابه "شهيدة العشق الإلهي" أنها تميز بين نوعين في الحب: حب الوداد أو الهوى، والحب الخالص، والأول حب ناقص، والثاني حب أمل. بيد أنها لا تختار هنا بين الواحد والآخر، إنما تأخذ بهما معا، ومن هنا فنحن نفترض لهذه الأبيات عهدا مبكرا شيئا، لم تكن قد بلغت فيه بعد المقام الأعلى للحب".
وقصيدتها "يا سروري" المشهورة، وتغنى بها كثيرون، تقول فيها: "يا سروري ومنيتي وعمادي/ وأنيسي وعُدتي ومرادي /أنت روح الفؤاد أنت رجائي/ أنت لي مؤنس وشوقك زادي/ أنت لولاك يا حياتي وأُنسي/ ما تشتتُ في فسيح البلاد/ كم بدت مِنة وكم لك عندي/ من عطاءٍ ونعمةٍ وأيادي/ حُبك الآن بُغيتي ونعيمي/ وجلاءُ لعين قلبي الصادي/ ليس لي عندك ما حييت براحٍ/ أنت منى مُمَكنُ في السواد/ إن تكن راضيا عليّ فإني/ يا مُنى القلب قد بدا إسعادي".
ويلاحظ قارئها أنها دائما تعبر عن انشغالها بذكر الله، وبحبه، حتى سميت شهيدة العشق الإلهي، وسيدة العاشقين، ركزت كلماتها عن العلاقة بين العبد وخالقه، وحالة الحب السامية التي يتحرك فيها المريد، ثم زادت هذه المرحلة نضوجا أكثر فأكثر في القرن الثالث الهجري ومن أعلامها أبي الحارث المحاسبي وأبي يزيد البسطامي والجنيد، وامتدت حتى القرن الخامس الهجري وصولا لأبي حامد الغزالي.
ابن عربي والأفق الجديد
نقلة كبيرة، أحدثها مولانا الأكبر محيي الدين بن عربي الذي انتقل في أشعاره ونثرياته من التعبير عن الذات والهيام في المحبوب إلى منطقة أرحب صنعت تحولا كبيرا إذا استغرقه الكون فوجه فيه تأملاته وارتبط بظواهره، وطاف بمن يقرأ له في عوالم أكثر أسطورية وأكثر غرائبية، تشعل النفس مزيدا من البهجة والارتباط بمثل هذه الحالة العرفانية المثيرة.
من أبياته المشهورة، يقول ابن عربي: "ليت شعري هل دروا/ أي قلب ملكوا/ وفؤادي لو درى/ أي شعب سلكوا/ أتراهم سلموا/ أم تراهم هلكوا/ حار أرباب الهوى/ في الهوى وارتبكوا". وفي هذه الأبيات ينتقل إلى الحديث عن تملك المناظر العُلى أو المقام الأعلى حيث المورد الأحلى، التي تتعشق بها القلوب وتهيم فيها الأرواح، قد تملكت القلب المحمدي، وأن غياب هذه المناظر عنه جعلته يبحث عن الطريق إليها وكأنها شعاب وسط الجبال.. وهكذا، فهذه المعاني الكبرى جاءت مع فكر ابن عربي المختلف تماما عن التجارب الصوفية التي سبقته مهما كانت عظمتها ودرجة رقيها.
ويحلو للفرق الإنشاد الديني أن تتغنى بقصيدته "سلام على سلمى"، وهي واحدة من قصائده في ديوانه المعروف "ترجمان الأشواق"، يقول فيها: سلام على سلمى ومن حل بالحمى/ وحُق لمثلي رقة أن يُسلما/ وماذا عليها أن ترد تحية/ علينا ولكن لا احتكام على الدمى/ سروا وظلام الليل أرخى سدوله/ فقلت لها صبا غريبا متيما/ أحاطت به الأشواق صونا وأرصدت/ له راشفات النبل أيان يمما/ فأبدت ثناياها وأومض بارق/ فلم أدر من شق الحنادس منهما/ وقالت أما يكفيه أني بقلبه/ يشاهدني في كل وقت أما أما".
والمعنى هنا يدور حول الحقائق الإلهية التي نصحته بلسانها قائلة لا تطلبني من خارج ويكفيه تنزلي عليه بقلبه، وأنها لما أضاءت زوايا كوني وأضاءت هيكل طبيعته وهو في مقام الحكمة، فتبسمت فأشرقت أرضه وسماؤه بنورها واستنار ليله وصادف ذلك أن ذاته حدث لها تجلي ذاتي فلم يدر ممن أشرق كونه، من شق ظلمة ذاته، وكأنه التبس عليه الأمر. وهذه المعاني أوردها ابن عربي بنفسه في شرحه على ديوانه "ترجمان الأشواق" وكلها معاني تأملية كبيرة ذهبت بالقصيدة إلى مرحلة بعيدة وأكثر تطورا.
ومن ذلك قوله: "وزاحمني عند استلامي أوانس/ أتين إلى التطواف معتجرات/ حسرن عن أنوار الشموس وقلن لي/ تورع فموت النفس في اللحظات". إذ يقول إنه عند قدومه لتسليم بيعة إلهية طافت من حوله الأرواح والملائكة وأهل الجنة يطوفون وله وهن مختفيات، وفي لحظة ظهرن وارتفع الحجاب فسطعن مثل أنوار الشموس، ونصحنه بقولها: تورع من الورع، واجتنب الملاحظة لئلا تذهب بنور بصرك المقيد.
وفي كتابها "ابن عربي ومولد لغة جديدة" تقول الدكتورة سعاد الحكيم: "من يستطيع أن ينقل الفكر من ميدان إلى ميدان هو الذي يطبع مسار التاريخ الفكري بطابعه، وذا ما فعله ابن عربي، نقل الفكر الصوفي من المعاملة إلى المكاشفة، ونقل اللغة الصوفية من لغة الأعماق والمعاملات إلى لغة الآفاق والمشاهدات فطبع الفكر الصوفي اللاحق بطابعه. وهذه النقلة التي أحدثها ابن عربي موهت على الدارسين، وظنوا بأن القطع قد حدث بين التجربة الصوفية السابقة وبين تجربة ابن عربي، وذلك لأن ابن عربي لم يقل إنه يجب أن ننظر إلى الآفاق أو إنه علينا أن ننقل التجربة الصوفية من المعاملة إلى المشاهدة، ابن عربي لم ينظر لهذه النقلة بل اكتفى بأن حول وجهه، فتحولت معه بالتبعية أنظار الصوفية".
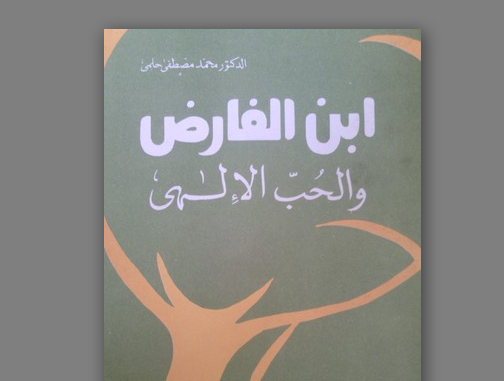
ابن الفارض وقصائده في الحب الإلهي
كان معاصرا لابن عربي، وعُرف بمكانته في التعبير عن الزهد والمعارف الصوفية والحب الإلهي، حيث تظل قصائد عمر بن الفارض تتردد على ألسنة المنشدين حاليا في كل المناسبات الدينية.
من كلماته المعبرة عن تهذيب النفس وترويضها يقول: "فنَفْسيَ كانَتْ، قبلُ، لَوّامَة متى / أُطعّها عصَتْ، أوْ أعصِ كانت مُطيعَتي/ فأوردتُها ما الموتُ أيسرُ بعضِهِ / وأتْعَبْتُها، كَيما تَكون مُريحتي/ فعادت ومهما حملته تحملتـ/ ـه مني وإن خففت عنها تأذت/ وكلفْتهُا، لاْبلْ كَفلْتُ قيامها / بتكليفيها حتى كلْفت بِكْلفتي/ وأذهبتُ في تهذيبها كلَّ لذَّة/ بإبعادِها عن عادِها، فاطمأنّتِ/ ولم يبقَ هولٌ دونهَا ما ركبتُهُ / وأشهَدُ نفسي فيهِ غيرَ زَكيّة/ وكلُّ مقامٍ عن سلوكٍ قطعتُهُ / عُبودِيّة حَقّقْتُها، بعُبودة".
في كتابه "ابن الفارض والحب الإلهي" يشرح الدكتور محمد مصطفى حلمي، أستاذ الفلسفة الإسلامية، أن ابن الفارض هذب نفسه اللوامة، وكيف أوردها موارد الهلاك، وحملها من المشقة والعناء ما لا يقاس إلى بعضه الموت، وما زال بها يعودها تحمل الأذى والصبر على المكروه والانصراف عن اللذة وركوب الهول حتى كلفت بهذا له، وأصبحت تستشعر في تخفيفه عنها تأذيا وتألما، وحتى صارت آخر الأمر نفسا مطمئنة بعد أن كانت لوامة".
وتهذيب النفس وإصلاح أمرها لدرجة منعها من قيادة الإنسان إلى الهلاك أو إلى موارد اللذات، معانى صوفية تحدثوا عنها باستفاضة، لأن ترويض النفس عماد التجربة الصوفية، حتى ابن عربي الذي حلق في المكاشفات والفتوحات الأكثر دهشة وإثارة، فإنه لم يغفل ترويض النفس، حيث وضع لها كتابا قيما بعنوان "الروح القدس" تحدث فيه عن تجربته مع شيوخه وأساتذته الذين نصحوه لتهذيب النفس، ودرجات أخذها وتنقيتها.
وبالعودة إلى ابن الفارض، فإن قصيدة "قلبي يحدثني" واحدة من أشهر أعماله التي يتغنى بها المنشدون والمبتهلون، وأبرزهم الشيخ سيد النقشبندي، وفيها يقول ابن الفارض: "قلبي يُحَدّثني بأَنّكَ مُتْلِفِي/ روحي فِداكَ عرَفْتَ أمَ لم تَعْرِفِ/ لم أَقْضِ حَقّ هَواكَ إن كُنتُ الذي/ لم أقضِ فيِه أسىً ومِثليَ مَنْ يَفي/ ما لي سِوَى روحي وباذِلُ نفسِهِ/ في حُبّ مَن يَهْواهُ ليسَ بِمُسرِف/ فلَئِنْ رَضِيتَ بها فقد أسعَفْتَني/ يا خَيبَة المَسْعَى إذا لم تُسْعِفِ/ يا مانِعي طيبَ المَنامِ ومانِحي/ ثوبَ السّقامِ بِهِ ووَجْدِي المُتْلِفِ/ عَطفاً على رَمقي وما أبقَيتَ لي/ منْ جسميَ المُضْنى وقلبي المُدَنَفِ/ فالوَجْدُ باقٍ والوِصَالُ مُماطلي/ والصّبْرُ فانٍ واللّقاء مُسَوّفي".
وعن حياته ومذهبه في الحب، يرى محمد مصطفى حلمي، أن أكبر الظن أن ابن الفارض قد حقق في حياته ومذهبه المثل العليا سواء من الناحيتين الروحية والعلمية، فهل هناء حياة روحية أرقى من هذه التي يدأب فيها الإنسان على تصفية نفسه، وتنقية قلبه وجلاء عين بصيرته، وعلى التأمل المتصل في الكون، والاتصال الدائم بمبدع الكون، ومفيض الوجود والحياة والجمال عليه، وهل هناك مذهب أعمق أثرا في نفس الذي ينتهي إليه وفي توجيه حياته العلمية من هذا المذهب الذي أقيم على دعائم قوية من الحب الصادق، والرضا الخالص، والاطمئنان إلى كل شيء، والقبول الحسن لكل شيء، بحيث تصبح اللذة والألم، والنعيم والعذاب، الغنى والفقر، السعادة والشقاء، كلها لديه سواء".
إبداع إنساني خالد عبر عن الشوق السامي والنبيل للإنسان، وقد غنى مثل هذه القصائد القديمة كل من الشيخ سيد النقشبندي، وانتقل بها الشيخ ياسين التهامي إلى الموالد والمناسبات الصوفية العامرة، وأخذت معه لونا جميلا أحبها جمهوره، فضلا عن فرق الإنشاد الدينية الجديدة التي تغنت بها أيضا، ومنها فرقة ابن عربي للإنشاد الصوفي، وهي فرقة مغربية قدمت جزءا كبيرا من تراث الشيخ محيي الدين بن عربي وطافت بحفلاتها في عدة بلدان عربية، وتروج الفرقة لنفسها بفقرة قصيرة تتحدث فيها عن نفسها، وأنها تعمل وتحاول "نقل ملامح التصوف في الأندلس من خلال إحياء الموسيقى الصوفية الأصيلة التي كانت معروفة هناك، ومن خلال استخدام أشعار كبار المتصوفين الأندلسيين والمغاربة والمشارقة، الذين لا زالت أشعارهم تصدح في الآفاق، معلنة معنى الوجد والحب والوصل والفناء والتآخي".
وهكذا، فإن فن المدائح النبوية والإنشاد الديني الذي اعتمد بشكل أساسي على تراث شعراء الصوفية، قد استفاد كثيرا من المعاني والتحولات العرفانية التي جاءت على يد رموز المدرسة الصوفية، وأن أغلب الفرق الإنشادية الحالية ترى أن قصائد المتصوفة أكثر تعبيرا عن المشاعر والانفعالات الدينية لإنسان العصر لما فيها من روح إنسانية عابرة للزمن وللثقافات المختلفة.



