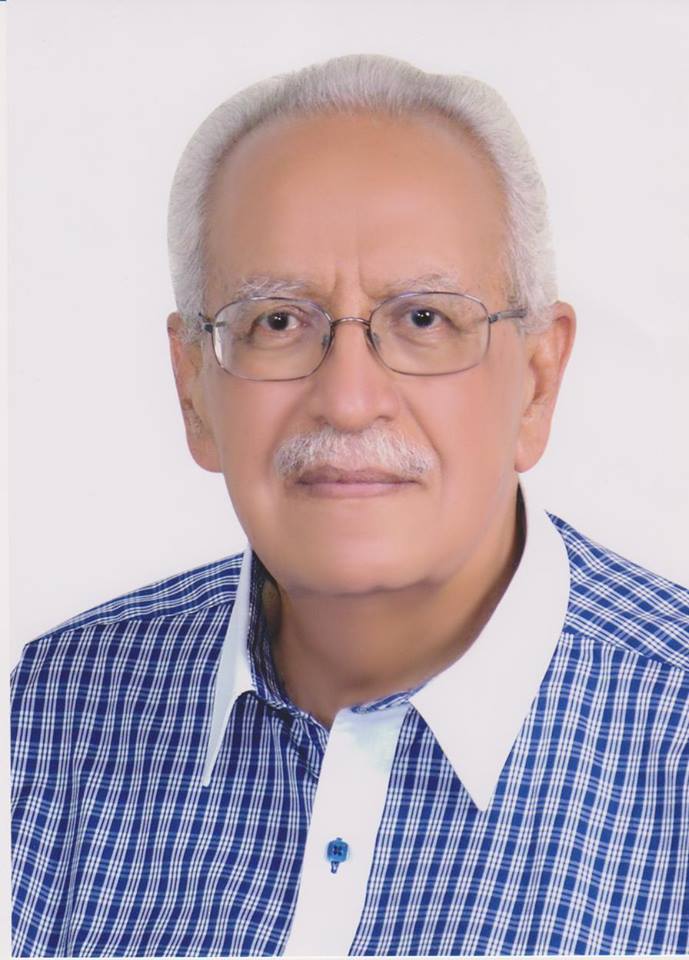هل أنت مع أمريكا أم ضدها؟ هل أنت مع التطبيع أم المقاطعة؟ هل أنت مع عبد الناصر أم السادات؟ سؤال يتردد كثيرا، وحين يواجه المرء بمثل تلك التساؤلات الثنائية وتكون إجاباته مثلا: إننى دون شك مع قرار بناء السد العالى، ولكنى بالتأكيد ضد معسكرات التعذيب والقتل الناصرية. إننى مع قرار حرب أكتوبر، ولكنى ضد اعتقالات سبتمبر، إننى مع إقامة اقتصاد وطنى ولكنى ضد ظاهرة القطط السمان، إننى مع تحرير الاقتصاد ولكنى ضد نهب البنوك. إننى مع الانتخابات الأمريكية الشفافة وضد سعار الرأسمالية الأمريكية واحتلال العراق، إننى مع كل من يقف مع الحق الفلسطينى حتى لو كان يهوديا إسرائيليا، وضد كل من ينتهك هذا الحق بصرف النظر عن هويته حتى لو كان مسلما عربيا.
حين يجيب المرء بهذه الطريقة سرعان ما يرى علامات الاستياء بل والاستنكار تبدو على وجه المستمع واضحة بقدر تعصبه لفكره، متهما مثل تلك الإجابات بالزئبقية والالتواء والغموض: «يا أخى حدد موقفك مع من وضد من».
ترى لماذا يثير ذلك النوع من الإجابات ضيقا لدى بعض من يتلقونها؟ لعل الأمر يرجع إلى أنها بالفعل إجابات غير قاطعة، بمعنى أنها لا تصدر حكما نهائيا حيال الموضوع المطروح إما أبيض وإما أسود. إنها إجابات «غامضة» لا تشفى غليل تلك الفئة من المتلقين، ويزودنا تراث علم النفس الاجتماعى بحقيقة مؤداها أن أمثال هؤلاء لا يستطيعون تحمل حكم لا ينتهى إلى إدانة «الآخر» إدانة تشمل كل ما صدر عنه، وتمجيد «الذات» الإيديولوجية أو السياسية تمجيدا يخفى كل العيوب والسلبيات. ومثل هؤلاء لا يخلوا منهم أتباع أى إيديولوجية أو تيار فكرى، سواء كان دينيا أو ماركسيا أو قوميا أو ناصريا أو حتى براجماتى.
ورب من يتساءل وبحق: هل يمكن أن تمضى بنا الحياة هكذا دون إصدار أحكام قاطعة؟ دون أن نحدد مواقفنا مع أو ضد؟ هل يمكن عمليا أن نتجنب فى ممارساتنا اليومية مثل تلك الاختيارات القاطعة؟ ذلك أمر مستحيل قطعا؛ فنحن فى تصحيح الامتحانات مثلا لا نستطيع الوقوف عند حد رصد الصواب والخطأ؛ لا بد من إجراء حسابات الطرح والجمع لنصل إلى قرار نهائي: الرسوب أو النجاح؛ وكذلك الحال بالنسبة للعديد من القرارات التى نتخذها فى حياتنا اليومية. قرارات الزواج واختيار التخصص الأكاديمى أو المهنى. والأمر كذلك فى العديد من الممارسات السياسية كقرار الفرد بالانضمام لحزب معين أو التصويت لمرشح دون غيره أو حتى الانتماء لتيار فكرى بذاته. فى كل تلك الأحوال يفترض أن يقوم الفرد فى البداية بعملية الموازنة بين السلبيات والإيجابيات، بين المكسب والخسارة، ولكنه لا بد فى النهاية أن يتخذ قرارا حاسما، أما إذا ما توقف عند حدود المفاضلة فإننا نصبح حيال ذلك النمط المتردد العاجز عن اتخاذ قرار مما قد يفقده جانبا هاما من جوانب الإنجاز. هكذا يكون الأمر عندما نقوم بإبداء الرأى فى أمر راهن يتعلق بقرار عملى يوشك الفرد أو توشك الجماعة على اتخاذه.
كل هذا صحيح، ولكن الأمر يختلف إذا كنا بصدد تقييم شخصية أو مرحلة تاريخية، إن الشخصيات التاريخية لا يمكن أن تخلو من السلبيات أو الإيجابيات، وكذلك المراحل التاريخية تكون خليطا من هذا وذاك، ولذا لا يجوز أن نعمل أسلوب الطرح والجمع للتوصل لحكم نهائى بشأنها، فالتقييم التاريخى لا يستهدف التوصل إلى قرار بقدر ما يسعى للإسهام فى صنع المستقبل باستخلاص الدروس المستفادة من المراحل الماضية لتكون هاديا لأبناء المرحلة الراهنة لصياغة المرحلة القادمة، والدروس المستفادة لا يمكن إلا أن تكون فرزا للسلبيات، وتبين أساليب تحاشى تكرارها، وإبراز الإيجابيات والدعوة للتمسك بها.
إن الإصرار على بلوغ قرار نهائى برفض أو قبول مرحلة تاريخية برمتها، يستند عادة إلى القول بأن إيجابيات المرحلة تفوق سلبياتها، أو أن سلبيات المرحلة تتجاوز ما بها من بعض الإيجابيات أو تبنى موقف ميكيافللى مؤداه أن الغاية تبرر الوسيلة، وأنه لم يكن ممكنا إحراز تلك الإيجابيات إلا عبر تلك الإجراءات السلبية، وفى ظل تلك الدعاوى نصبح حيال خطرين أساسيين:
الخطر الأول: أننا بالتركيز على الإيجابيات والتشويش أو غض الطرف عن السلبيات قد نقدم لقادة المرحلة الراهنة تبريرا لقبول سلبيات مرحلة سابقة استنادا إلى ما تضمنته تلك المرحلة من إيجابيات.
الخطر الثاني: أننا بالتركيز على السلبيات والتشويش أو غض الطرف عن الإيجابيات قد نقدم لقادة المرحلة الراهنة تبريرا للانقضاض على إيجابيات مرحلة سابقة استنادا إلى ما تضمنته تلك المرحلة من سلبيات.