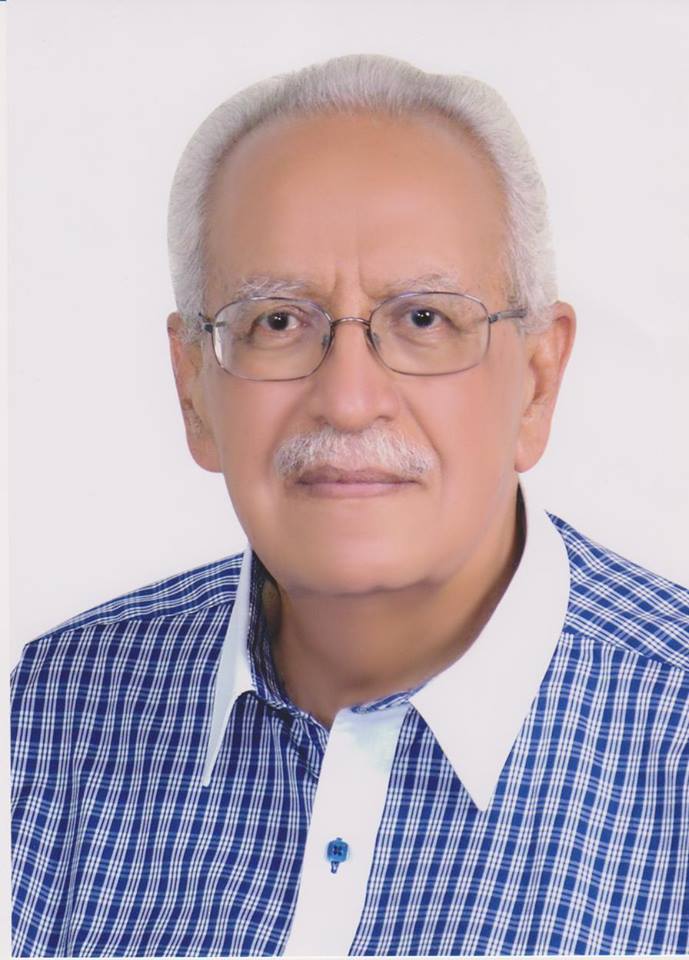يعد إقصاء الآخر المختلف خاصية لصيقة بأصحاب الفكر الشمولى العقائدى سواء كان ذلك الفكر يمينيًا دينيًا أو يساريا ماركسيًا أو ما بين هذا وذاك. ولا ترجع هذه الخاصية إلى عوار أخلاقى أو تشوه نفسى، بل على العكس فأصحاب هذا الفكر الشمولى قد يكونون الأكثر إقداما على التضحية والإيثار. ولكن المشكلة تكمن فى أحادية نظرتهم إلى الكون والبشر والتاريخ؛ فهم يعتمدون على مصدر أساسى واحد يستقون منه معلوماتهم ويشكل وحده مرجعيتهم الفكرية ويوقنون يقينا لا يداخله شك فى امتلاكهم للحقيقة كاملة تامة غير منقوصة لا تحتاج إلى مراجعة أو إعادة نظر، ولذلك فليس من المستغرب على هؤلاء أن تضيق نظرتهم فيصنفون الآخر وفقا لانتمائه الفكرى دون نظر إلى سلوكه وأدائه الفعلى، وتضيق صدورهم بأولئك الذين ينادون بحتمية تعدد الرؤى وبنسبية الحقيقة وبحق الخطأ، وقد يبلغ الأمر بأصحاب الفكر الشمولى إلى حد اعتبار أن الليبرالية خطر حقيقى يهدد ثوابت المجتمع ويشوه هوية الوطن ومن ثم ينبغى إقصاء أتباعها فكريا بل بدنيا إذا ما لزم الأمر.
قد يكون ذلك الموقف الإقصائى منطقيًا فى إطار الفكر الشمولي؛ ولكن الأمر يصبح مستوقفًا للنظر إذا ما انزلق الليبراليّون إلى تلك الغواية التى تتعارض مع منطلقاتهم الفكرية القائمة على التعددية وحرية الرأى والمنافسة، فإذا بهم يصنفون الآخر وفقا لانتمائه الفكرى دون نظر إلى سلوكه وأدائه الفعلى، ويطالبون بإقصاء ذلك الآخر المتمثل فى أصحاب الفكر الشمولى، مستندين إلى نفس الأسباب أى باعتبار الفكر الشمولى وأصحابه يمثلون خطرًا حقيقيًا يهدد ثوابت المجتمع ويشوه هوية الوطن.
لقد شهدنا فى السنوات الأخيرة تزايد من يتصايحون عند إسناد منصب لشخص معين سواء فى مجال الإعلام أو الإدارة محذرين منه باعتباره كان «شيوعيا» أو «إخوانيا» أو من «الفلول» دون توقف لتبين طبيعة علاقته بأى من تلك المجموعات، ودون انتظار لطبيعة أدائه، بل دون الاستناد إلى ما قد يشين تاريخه العملى، وحتى لو لم يسبق أن امتدت يده إلى المال العام ولم تحم حول سمعته الشخصية الشبهات؛ بل يكفى الاستناد إلى تاريخه الفكرى حتى لو كان قديمًا لإدانته والتحذير منه والعمل على إقصائه.
إن حقيقة أن الميل للإقصاء لا يقتصر على الأصوليين أصحاب الرؤى الأحادية قد ثبتت بشكل علمى منذ عام ١٩٩٣، ومن خلال مقياس «أحادية الرؤية» الذى شاركت أستاذى الراحل رشدى فام منصور فى تصميمه؛ والذى قام عدد من أبنائنا بالاعتماد عليه فى إنجاز أطروحاتهم للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه فى علم النفس.
ولكن يبدو أن الحقيقة العلمية الجافة الباردة والتى ترصدها البحوث فى صورة جداول إحصائية دقيقة ومضبوطة، يختلف وقعها حين تتجسد فى الواقع الاجتماعى - الشخصى الحى، وقد استوقفتنى فى المشهد الراهن ما يؤكد تلك الحقيقة العلمية.
لاحظت أن العديد من الزملاء والأبناء والأصدقاء الليبراليين «يترفعون» عن الاطلاع على ما يختلف مع توجهاتهم الفكرية مكتفين بمتابعة ما يرونه متفقا مع رؤيتهم، مولين ظهورهم لغير ذلك من مصادر الرأى والخبر. ووجدتنى بالمقابل أميل إلى إعطاء الأولوية فى الاطلاع لما يبدو متعارضًا مع قناعاتى الفكرية والسياسية بل الدينية أيضًا.
لقد حاولت - وما زلت - الاطلاع على كتابات العقائديين من اليهود والمسيحيين والبهائيين والبوذيين والماركسيين بألوانهم، والملاحدة بأطيافهم والفاشيين والصهاينة؛ فضلا عن كتابات المفكرين المسلمين من الشيعة والسنة والسلفيين. ولا أدعى بذلك حاشاى أننى أحطت بكل تلك المعارف أو حتى ببعضها إحاطة المتخصص، فلست سوى مجتهد فى مجال علم النفس السياسى، ولكنى وددت أن أؤكد أن اطلاعى على تلك المصادر رغم تناقض مطلقاتها لم يثر لدى فزعًا انفعاليًا أو رجفة عقائدية بقدر ما أسهم فى تكوينى الفكرى.
إن انغلاق المرء على ما يثق فيه ويتفق مع توجهاته يكون بطبيعة الحال باعثًا على الطمأنينة والارتياح، وقد يخلق لديه وهمًا بأن ما يعتقد هو عقيدة غالبية البشر، وأن من يرون غير رأيه ليسوا سوى قلة من الضالين، ولكن ذلك لا يمكن أن يتيح له اقترابًا من الحقيقة؛ فثمة جانب من الحقيقة لا بد من التماسه فيما يقوله الآخرون لتكتمل الصورة أو تقترب من الاكتمال. ولو شئنا نموذجًا عمليًا فيكفى أن ننظر إلى المصادر الإعلامية المتاحة من صحف وتليفزيون فضلًا عن الإنترنت، ليتضح لنا بجلاء نسبية الحقيقة فيما يصلنا من كل مصدر. قد يكون المصدر محترمًا بمعنى أنه لا يتدنى لاختلاق الوقائع ولكن من الطبيعى أن يركز على ما يراه هامًا، مهملًا ما يعتبره استثناءات وتفاصيل تافهة، فى حين أن مصدرًا آخر لا يقل عنه احترامًا ونزاهة يرى فى تلك «الاستثناءات التافهة» ما هو الأجدر بالاهتمام. ومن ثم فعلى الباحث عن الحقيقة أن يلملمها من هنا وهناك، رغم ما فى ذلك من عناء.
وإذا جاز للبعض أن يركنوا لراحة الانغلاق على فكرهم وتجنبهم مشقة السعى لمعرفة حقيقة ما يعتنقه الآخرون، فإن ذلك لا يجوز لمن يتصدى للكتابة للرأى العام زاعمًا أنه يسعى لتنويره من خلال اطلاعه على الحقائق. خلاصة القول إن الحقيقة الناقصة أشد خطرًا من الجهل الذى قد يدفع المرء إلى التماس المعرفة، وإن الاطلاع على الفكر المخالف يكفل للمرء رؤية أدق للحقيقة، ويزيد طمأنينته لما يعتقد الأصوب، كما يكفل له جدارًا يقيه من التعصب والانغلاق.