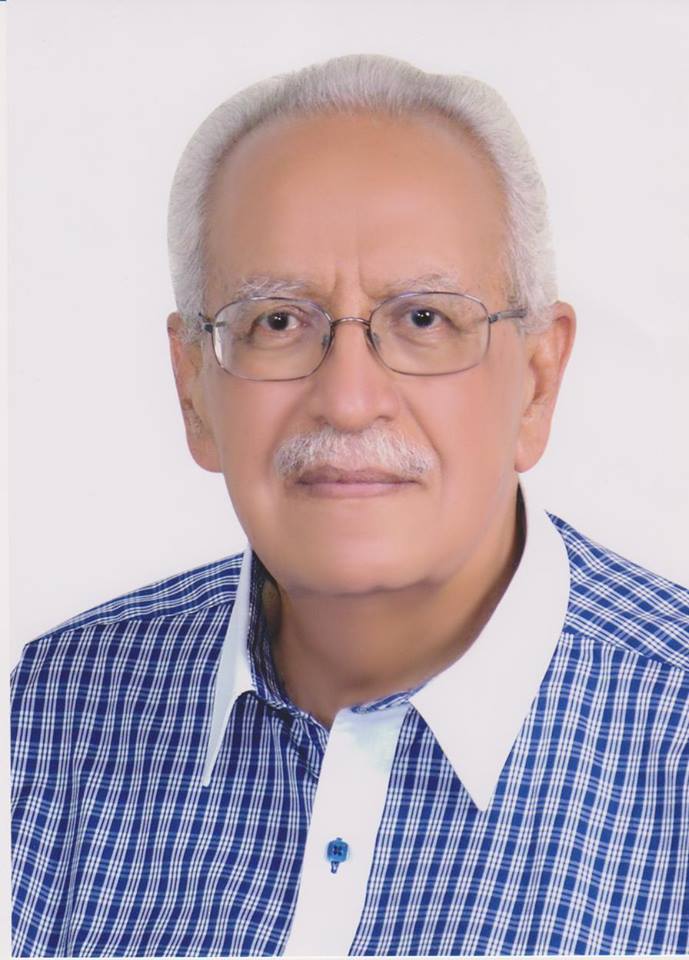إن أحدًا لا يستطيع الفصل بين «السياسة» و«السلطة»، فالعمل السياسى سواء كان مشروعًا أو غير مشروع، وسواء كان إصلاحيًا أو ثوريًا، إنما هو عمل يستهدف السلطة تغييرًا أو ترشيدًا أو محافظة واستمرارًا، ومن ثم فإن إلحاق صفة «السياسى» بالإسلام يعنى التفرقة بين غالبية المسلمين من المتدينين ممن لا ينطلقون فى ممارساتهم السياسية من منطلق دينى، أو حتى ممن لا يهتمون بالسياسة أصلًا؛ وبين الحركات والتنظيمات الإسلامية السياسية التى تنطلق من أرضية دينية إسلامية فى تحرك جماعى منظم، يستهدف السلطة بالمعنى الذى أشرنا إليه.
ولكن هل نستطيع أن نضع كل تلك الحركات الإسلامية فى سلة واحدة؟ هل يمكن الجمع مثلًا بين تنظيم القاعدة، وجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وجماعة الجهاد، وحزب الحرية والعدالة المصرى، وحزب العدالة والتنمية التركى، وحركة حماس الفلسطينية، وحزب النور المصرى، وحزب الله الشيعى اللبنانى… إلى آخر تلك التنظيمات التى تشترك فى مرجعيتها الإسلامية، وفى سعيها بشكل أو بآخر نحو التأثير فى السلطة؟
إنها تجمعات تبدو شديدة التناقض، بل إن تناقضها قد يتجاوز التعبير اللفظى إلى حد الاشتباكات الدموية، ولكن ما يجمعهم هو التسليم بإمكانية إقامة دولة تجمع المسلمين جميعًا، ثم هم بعد ذلك يختلفون اختلافات أساسية فى الطبيعة العقائدية لتلك الدولة وفقًا لتباين المذاهب والاجتهادات، ويختلفون كذلك فى أساليب العمل من أجل إقامة هذه الدولة، وما إذا كانت إقامتها بالقوة هو السبيل الوحيد؟ وما الشروط الواجب توافرها لتوقيت استخدام القوة؟ أم أن السبيل الأنسب لتحقيق الهدف هو الدعوة السلمية والإقناع التدريجى؟ وتظل فكرة «التسليم بإمكانية إقامة دولة تجمع المسلمين جميعًا» هى حجر الأساس الذى تقوم عليه الحركات الإسلامية جميعا، والسؤال هو: هل توجد بالفعل أمة إسلامية ينقصها أن تتوحد فى صورة دولة؟
إن الأمة تقوم على توافر شروط تتعلق بالمكان، الاقتصاد، واللغة، والتاريخ، ثم تكتمل هذه الشروط بالتكوين النفسى المشترك، وتعد العقيدة الدينية جانبًا من جوانب عديدة تشمل اللغة والعادات وغيرهما، تشكل فى مجملها ذلك التكوين النفسى المشترك، ومن ثم فإن وحدة العقيدة لا يمكن لها وحدها أن تقيم أمة، غير أن الحركات الإسلامية تقوم على العكس من ذلك تماما، إذ تقوم على أن الرابطة الفكرية العقائدية- وهى جزء من التكوين النفسى كما أشرنا- تكفى للحديث عن أمة قائمة بالفعل مزقتها قوى معادية للإسلام، واصطنعت بينها حدودًا سياسية قومية، وأضفت القداسة على تلك الحدود، وأن تلك الحدود «المصطنعة» لا بد زائلة يومًا ما.
وللحقيقة والإنصاف؛ فإن القول بتلك الهوية العابرة لحدود الوطن ليس بالقول الجديد، فقد قال جمال الدين الأفغانى بوضوح فى مجلة «العروة الوثقى» عام ١٨٨٤: «لا جنسية للمسلمين إلا فى دينهم»، وأكد ذلك بقوله: «… وعلمنا وعلم العقلاء أجمعين أن المسلمين لا يعرفون لهم جنسية إلا فى دينهم واعتقادهم»، ثم يخلص إلى «أن المسلمين من يوم نشأة دينهم إلى الآن لا يتقيدون برابطة الشعوب وعصبيات الأجناس، وإنما ينظرون إلى جامعة الدين، لهذا نرى المغربى لا ينفر من سلطة التركى والفارسى يقبل سيادة العربى، والهندى يذعن لرئاسة الأفغانى، لا اشمئزاز عند أحد منهم ولا انقباض».
ويستمر هذا التيار الفكرى فى التدفق، ليقول الشيخ يوسف القرضاوى فى مطلع الألفية الثانية ملخصًا موقف الإسلام من الوطنية بقولة: «ليس بمجتمع مسلم ذلك الذى تتقدم فيه العصبية الوطنية على الأخوة الإسلامية حتى يقول المسلم وطنى قبل دينى» و«أن دار الإسلام ليس لها رقعة محددة» و«مشاعر الولاء للإسلام وأهله هى التى تقود المجتمع وكذلك مشاعر البغض لأعداء الإسلام»، ويقول فى إدانة واضحة للفكرة الوطنية: «فى واقع مصر والوطن العربى والإسلامى، شجع المستعمرون النعرة الوطنية، هادفين إلى أن يحل الوطن محل الدين، وأن يكون الولاء للوطن لا لله، وأن يقسم الناس بالوطن لا بالله، وأن يموتوا فى سبيل الوطن لا فى سبيل الله».
خلاصة القول، إن فكرة أسبقية الانتماء الدينى على الانتماء الوطنى فكرة ضاربة الجذور فى تراثنا الإسلامي، ولكن الأهم هو حقيقة أن تلك الفكرة وحدها مهما بلغ رسوخها واليقين من صوابها عند أصحابها، لم تكن مرتبطة دائما بممارسة العنف، فثمة خيط رفيع يفصل بين الفكر وشكل الممارسة، وتبين أن ذلك الخيط الرفيع هو المدخل الرئيسى لمواجهة الإرهاب الذى نعانى منه فى الوقت الراهن، ولقد عرفنا بالفعل فى الثلاثينيات من تاريخنا الحديث نقدًا فكريًا حادًا فى إطار بالغ الاحترام لفكر ملحد صريح، دون أن يتطور الأمر إلى ممارسة لعنف أو دعوة إليه أو حتى تجاوز لفظى، كما حدث بالنسبة لإسماعيل أدهم وكتابه الشهير «لماذا أنا ملحد؟»، وما أثاره من مجادلات.
ولكن هل نستطيع أن نضع كل تلك الحركات الإسلامية فى سلة واحدة؟ هل يمكن الجمع مثلًا بين تنظيم القاعدة، وجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وجماعة الجهاد، وحزب الحرية والعدالة المصرى، وحزب العدالة والتنمية التركى، وحركة حماس الفلسطينية، وحزب النور المصرى، وحزب الله الشيعى اللبنانى… إلى آخر تلك التنظيمات التى تشترك فى مرجعيتها الإسلامية، وفى سعيها بشكل أو بآخر نحو التأثير فى السلطة؟
إنها تجمعات تبدو شديدة التناقض، بل إن تناقضها قد يتجاوز التعبير اللفظى إلى حد الاشتباكات الدموية، ولكن ما يجمعهم هو التسليم بإمكانية إقامة دولة تجمع المسلمين جميعًا، ثم هم بعد ذلك يختلفون اختلافات أساسية فى الطبيعة العقائدية لتلك الدولة وفقًا لتباين المذاهب والاجتهادات، ويختلفون كذلك فى أساليب العمل من أجل إقامة هذه الدولة، وما إذا كانت إقامتها بالقوة هو السبيل الوحيد؟ وما الشروط الواجب توافرها لتوقيت استخدام القوة؟ أم أن السبيل الأنسب لتحقيق الهدف هو الدعوة السلمية والإقناع التدريجى؟ وتظل فكرة «التسليم بإمكانية إقامة دولة تجمع المسلمين جميعًا» هى حجر الأساس الذى تقوم عليه الحركات الإسلامية جميعا، والسؤال هو: هل توجد بالفعل أمة إسلامية ينقصها أن تتوحد فى صورة دولة؟
إن الأمة تقوم على توافر شروط تتعلق بالمكان، الاقتصاد، واللغة، والتاريخ، ثم تكتمل هذه الشروط بالتكوين النفسى المشترك، وتعد العقيدة الدينية جانبًا من جوانب عديدة تشمل اللغة والعادات وغيرهما، تشكل فى مجملها ذلك التكوين النفسى المشترك، ومن ثم فإن وحدة العقيدة لا يمكن لها وحدها أن تقيم أمة، غير أن الحركات الإسلامية تقوم على العكس من ذلك تماما، إذ تقوم على أن الرابطة الفكرية العقائدية- وهى جزء من التكوين النفسى كما أشرنا- تكفى للحديث عن أمة قائمة بالفعل مزقتها قوى معادية للإسلام، واصطنعت بينها حدودًا سياسية قومية، وأضفت القداسة على تلك الحدود، وأن تلك الحدود «المصطنعة» لا بد زائلة يومًا ما.
وللحقيقة والإنصاف؛ فإن القول بتلك الهوية العابرة لحدود الوطن ليس بالقول الجديد، فقد قال جمال الدين الأفغانى بوضوح فى مجلة «العروة الوثقى» عام ١٨٨٤: «لا جنسية للمسلمين إلا فى دينهم»، وأكد ذلك بقوله: «… وعلمنا وعلم العقلاء أجمعين أن المسلمين لا يعرفون لهم جنسية إلا فى دينهم واعتقادهم»، ثم يخلص إلى «أن المسلمين من يوم نشأة دينهم إلى الآن لا يتقيدون برابطة الشعوب وعصبيات الأجناس، وإنما ينظرون إلى جامعة الدين، لهذا نرى المغربى لا ينفر من سلطة التركى والفارسى يقبل سيادة العربى، والهندى يذعن لرئاسة الأفغانى، لا اشمئزاز عند أحد منهم ولا انقباض».
ويستمر هذا التيار الفكرى فى التدفق، ليقول الشيخ يوسف القرضاوى فى مطلع الألفية الثانية ملخصًا موقف الإسلام من الوطنية بقولة: «ليس بمجتمع مسلم ذلك الذى تتقدم فيه العصبية الوطنية على الأخوة الإسلامية حتى يقول المسلم وطنى قبل دينى» و«أن دار الإسلام ليس لها رقعة محددة» و«مشاعر الولاء للإسلام وأهله هى التى تقود المجتمع وكذلك مشاعر البغض لأعداء الإسلام»، ويقول فى إدانة واضحة للفكرة الوطنية: «فى واقع مصر والوطن العربى والإسلامى، شجع المستعمرون النعرة الوطنية، هادفين إلى أن يحل الوطن محل الدين، وأن يكون الولاء للوطن لا لله، وأن يقسم الناس بالوطن لا بالله، وأن يموتوا فى سبيل الوطن لا فى سبيل الله».
خلاصة القول، إن فكرة أسبقية الانتماء الدينى على الانتماء الوطنى فكرة ضاربة الجذور فى تراثنا الإسلامي، ولكن الأهم هو حقيقة أن تلك الفكرة وحدها مهما بلغ رسوخها واليقين من صوابها عند أصحابها، لم تكن مرتبطة دائما بممارسة العنف، فثمة خيط رفيع يفصل بين الفكر وشكل الممارسة، وتبين أن ذلك الخيط الرفيع هو المدخل الرئيسى لمواجهة الإرهاب الذى نعانى منه فى الوقت الراهن، ولقد عرفنا بالفعل فى الثلاثينيات من تاريخنا الحديث نقدًا فكريًا حادًا فى إطار بالغ الاحترام لفكر ملحد صريح، دون أن يتطور الأمر إلى ممارسة لعنف أو دعوة إليه أو حتى تجاوز لفظى، كما حدث بالنسبة لإسماعيل أدهم وكتابه الشهير «لماذا أنا ملحد؟»، وما أثاره من مجادلات.