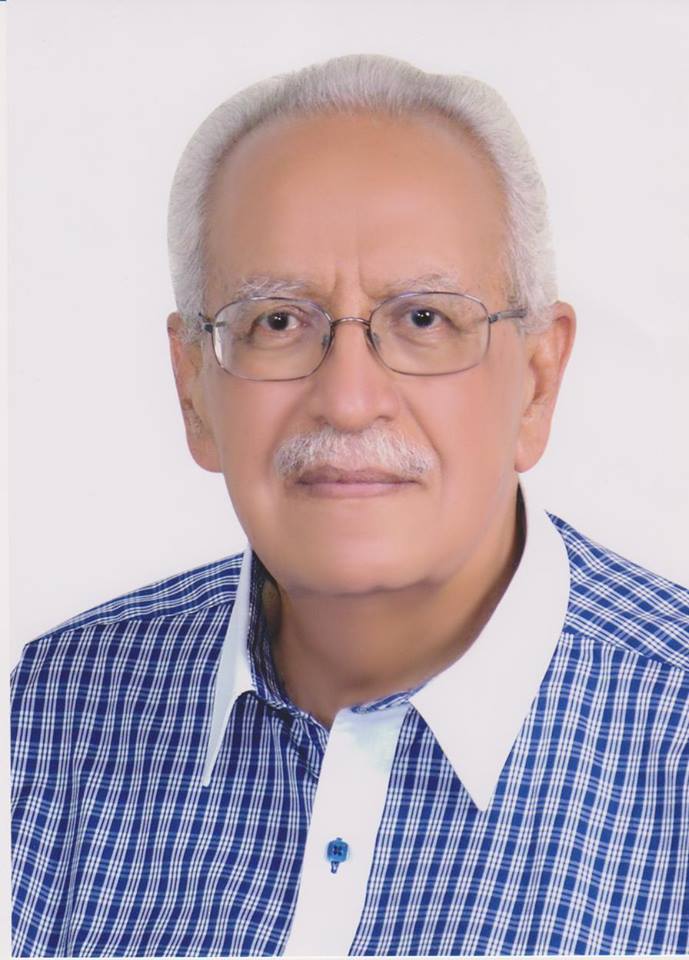[email protected]
نحن لا نولد مصريين، وكذلك لا نولد منتمين لديانة معينة؛ بل نولد على الفطرة سياسيًّا ووطنيًّا ودينيًّا، ثم نتدرب ونتعلم ونكتسب هويتنا وانتماءاتنا عبر مسار طويل يمتد من الطفولة إلى الرشد. نتدرب في أسرنا ومدارسنا ومن خلال إعلامنا، ومساجدنا، وكنائسنا، ومن خلال جماعات الأصدقاء..
نتدرب خلال آليات متشابكة على الانتماء للوطن، ولكن عمليات التدريب هذه لا تتطابق دائمًا.
فمن الجماعات الفرعية من تُدرب أبناءها على أن الانتماء للأسرة مثلاً ينبغي أن يعلو على الانتماء للوطن، أو أن الانتماء الديني ينبغي أن يعلو على كافة الانتماءات الوطنية والأسرية وغيرها.
فضلاً عن أن مثل تلك الجماعات الفرعية تميل إلى تدريب أبنائها على رؤية غالبية البشر باعتبارهم أحد صنفين: طيبين أو أشرار، وبطبيعة الحال نكون نحن الطيبين وهم الأشرار، ولا مجال للتدرج بين هذا وذاك. ويمتد ذلك التصنيف القاطع ليشمل التمييز بين الذكر والأنثى، وبين النظم الاجتماعية، وبين الأفكار السياسية، وبين الجماعات القومية، وبين الأغنياء والفقراء... إلى آخره.
فلا مجال لرؤية وجهَي الموضوع في آنٍ واحد، ولا مجال لأن يضع الفرد نفسه موضع الآخر ليتبين كيف ولماذا هو مختلف عنه، وما هي درجة ذلك الاختلاف. ويؤدي ذلك في النهاية إلى عجز المرء عن القبول بحقيقة “,”أن الآخرين يختلفون عنا حقًّا في بعض الأوجه، ولكنهم يلتقون معنا في غيرها، وأنه لا توجد جماعة تخلو من الطيبين، كما لا توجد جماعة كلها أخيار“,”.
خلاصة القول أنه ليس من مجال للحديث فيما يتعلق بالانتماء عن جينات وراثية تميز جماعات معينة من البشر، لا سبيل أمامهم للتخلص منها، ولا سبيل لغيرهم لاكتسابها؛ فالإنسان يولد طفلاً ثم يتم تدريبه على الانتماء للوطن وللدين وللقبيلة وللأمة وللدولة، ولغير ذلك من أنواع الانتماء، ويتم تعريفه كذلك بمن هم أعداؤه، ومن هم أصدقاؤه، وكيف ينبغي أن يتعامل مع هؤلاء وهؤلاء.
ولا تخلو الحياة الواقعية من مواقف عملية يجد المرء فيها أنه مطالب بتدريج انتماءاته واتخاذ قراراته وفقًا لانتمائه الأساسي، حتى لو كان ذلك على حساب انتماءاته الأخرى. في مثل هذه المواقف ينكشف زيف النظرة المتوازية للانتماءات: هل الانتماء للأسرة مثلاً يقتضي أن يتضامن الجميع في إخفاء جريمة تمس الأمن القومي ارتكبها أحد أعضائها؟ إن الإبلاغ عن المجرم في هذا الصدد قد يعد إعلاء للانتماء القومي، ولكنه في نفس الوقت خيانة للانتماء الأسري.
هل يعد إقدام مواطن على إبلاغ مؤسسات دولية عن جرائم تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده إعلاء للانتماء الإنساني، أم أنه يعتبر بمثابة الخيانة الوطنية.
هل يعتبر إقدام مواطن على التصدي بيده لتجاوز غيره لما يعتبره مقدسًا، إعلاء لانتمائه الديني وانسجامًا مع توجهات السلطة القائمة؟ أم أنه يعد تجاوزًا لما يقتضيه الانتماء الوطني من التزام بالوحدة الوطنية.
المشهد الراهن في بلادنا يشهد للمرة الأولى في تاريخنا تطابقًا بين أولوية الانتماء الإسلامي، وأولوية الانتماء للسلطة التي تمسك بها جماعة الإخوان المسلمين. لقد وصل ممثلو تيار الإسلام السياسي للسلطة؛ ومن هنا خلط أنصار السلطة خلطًا مقصودًا بين الخروج على السلطة والخروج على الدين الإسلامي، بل والخروج على قواعد الديمقراطية أيضًا.
ويصبح طبيعيًّا والأمر كذلك أن يلصق هؤلاء المدافعون عن السلطة/الإسلام بمعارضيهم تهمَ الانحلال والتهتك والخروج عن الإسلام، فضلاً عن انتهاك أصول الديمقراطية؛ مع ما تحمله تلك الاتهامات من إغراء البسطاء بإبادة أولئك الخارجين على السلطة والإسلام والديمقراطية معًا.
إن قراءة بسيطة لخريطة علاقات القوى السياسية المصرية في اللحظة الراهنة كفيلة بإدراك أنه لم يعد ممكنًا عمليًّا ولا جائزًا أخلاقيًّا أن يحلم فصيل بإبادة فصيل آخر أو تجاهل وجوده أو إخضاعه لإرادته.
لقد اختفت من عالم المستقبل إمكانية أن ينفرد فصيل واحد بالساحة السياسية أيًّا كانت قوته المادية أو العددية أو المالية أو قدرته على الحشد، أو حتى صواب عقيدته الدينية.
الفصيل الأبقى هو الأقدر على استيعاب من يختلف معه. وليست عملية الاستيعاب هذه بالعملية الهينة على من يرون في أنفسهم أصحاب حقيقة مطلقة؛ فاستيعاب الآخر -وليس ابتلاعه- يعني في جوهره التسليم بحق ذلك الآخر في الممارسة العلنية الآمنة لما يعتبرونه من وجهة نظرهم محرمًا.
ومن يتأمل التاريخ، فضلاً عن الحاضر، يدرك بوضوح أن الكيانات الاجتماعية والسياسية تتهاوى وتندثر، ولو بعد حين، إذا ما أحجمت عن استيعاب تلك الحقيقة، وأن المجتمعات المتقدمة حضاريًّا هي التي استطاع أصحابها دفع ذلك الثمن الباهظ والضروري، وهو القبول بما يختلف مع عقيدتي وقيمي الأخلاقية، والوقوف عند حدود الرفض الفكري له.