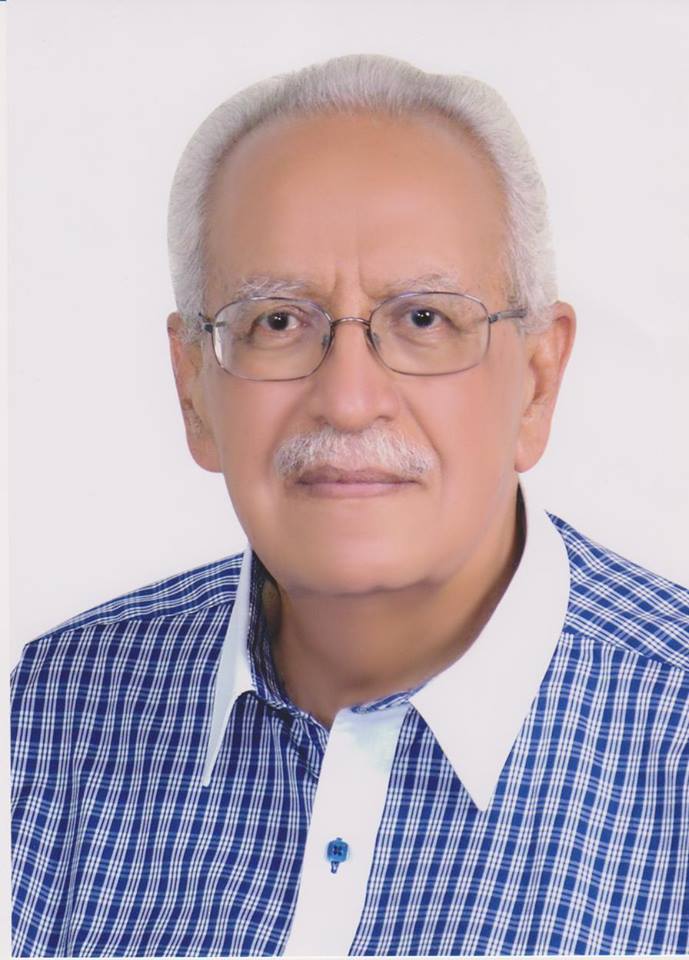قد يبدو العنوان غريبًا، فنحن جميعا نفكر في حلول لمشاكلنا، و قد نخاف من أمور كثيرة ولكن ليس من بينها التفكير بأي حال، هذا ما يبدو لنا للوهلة الأولي، و لكن إذا ما تأملنا أنفسنا وواقعنا تكشفت لنا صورة مختلفة بعض الشيء.
ليس صحيحا أن حل أي مشكلة يحتاج إلي تفكير، فثمة مشكلات لا تتطلب من الفرد سوى أن يلجأ إلى مخزونه من الحلول التي سبق أن مارسها وأثبتت جدواها، وتنتهي المشكلة تمامًا فور استعادة تلك الحلول وتطبيقها، وقد لا تستغرق هذه العملية بكاملها طرفة عين، و لكن للأسف فإن مثل تلك الحلول الخاطفة لا تتحقق في كل المواقف، فإذا ما أخفق الحل التقليدي المألوف فعلى المرء أن يبحث عن حل جديد مبتكر لمشكلته التي يعاني منها، أن يفكر تفكيرًا إبداعيًا، والتفكير الإبداعي يعني الاختلاف، يعني الخروج عن النمط المألوف، وكلها أمور قامت أغلب المجتمعات على رفضها والتخويف منها، فالتنشئة الاجتماعية تقوم عادة على التحذير من الخطأ وعقاب المخطئ، ومن ثم فقد يفضل المرء في كثير من الأحيان أن يتجاهل وجود المشكلة، ومع التجاهل يختفي الهدف، وتتلاشي آلام الوعي والإحباط، وتسود الطمأنينة والسعادة، ولكن تظل المشكلة قائمة بل لعلها قد تتفاقم.
رب من يتساءل، تري وهل هنالك حقًا من يفضلون سعادة اللحظة الراهنة مهما كانت خطورة المشكلات القائمة و القادمة؟ الإجابة الفورية نعم، بل ولعل هؤلاء يمثلون الغالبية في بعض الأحيان، و يصدق ذلك يشكل خاص علي المشكلات الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية، والسياسية، وقد يبدو للوهلة الأولى أن مثل تلك المشكلات بحكم حجمها وشموليتها عصية علي التجاهل، فضلًا عن التجهيل، ولكن الحقيقة غير ذلك تمامًا، إنها الأكثر قابلية للتجاهل، والأكثر استهدافًا للتجهيل، خاصة إذا ما كانت من نوعية تلك المشكلات التي لا تبدو في اللحظة الراهنة سوي علاماتها المنذرة فحسب.
إن تلك المشكلات تتميز بأمور ثلاثة:
الأمر الأول:
أنها ذات طابع تاريخي، يندر ظهورها فجأة بين عشية وضحاها، بل تبدأ نذرها خفية في البداية، ثم تأخذ في التراكم والتضخم والظهور شيئًا فشيئًا، ولذلك فإن رصد بداياتها الأولي، ربما يتطلب توافر عدد من السمات الشخصية، والقدرات العقلية، فضلًا عن بعض المعارف المتخصصة، مما قد لا يتاح مجتمعًا سوى لدي نخبة محدودة من الأفراد. ومثل أولئك الأفراد حين يمسكون بنواقيس الخطر، ويرفعون رايات التحذير، لا يلقون في الغالب من مجتمعاتهم ترحيبًا كبيرًا، إنهم دعاة التشاؤم، المنقبون عن المشكلات، وفي أغلب الأحوال فإن هؤلاء الأفراد يعانون كثيرًا من نبذ أبناء مجتمعاتهم لهم، خاصة أنهم يرون أنفسهم الأكثر انتماءً والأكثر حرصًا على مصالح تلك المجتمعات، ولذلك فإنهم في كثيرٍ من الأحيان يختارون في النهاية الحفاظ علي انتمائهم لجماعتهم وعلى تقبل أبناء جماعتهم لهم ومن ثم فإنهم قد يقدمون علي طي رايات التحذير، و الكف عن دق نواقيس الخطر.
الأمر الثاني:
أن حل ذلك النوع من المشكلات لا يمكن أن يتأتى بجهدٍ فردي مباشر بل لا بد وأن يكون ذلك الجهد جهدًا اجتماعيًا جماعيا مخططًا.
الأمر الثالث:
إن حل ذلك النوع من المشكلات لا يتطلب فحسب وعيًا بالمشكلة، وبحثًا عن الطريق الأنسب للتخلص منها، بل انه يتطلب في أغلب الأحيان تصديًا لقوى ومؤسسات اقتصادية اجتماعية عاتية تستفيد من استمرار تلك المشكلات قائمة بل تدفع بها إلى مزيد من التفاقم.
ومن ثم فإننا لا نبالغ إذن عندما نقرر أن تعثر الوعي, و من ثم التعثر في حل العديد من مثل تلك المشكلات الاجتماعية التي نعاني منها لا يرجع إلى كونها غير قابلة للحل، أو لكونها بالغة التعقيد فحسب، ولكنه يرجع في المقام الأول إلى أوضاع اجتماعية اقتصادية تاريخية تخلق مصالح اقتصادية يقوم بقاء أصحابها على استمرار الحال على ما هو عليه، ومن ثم التصدي بكل الوعي والحسم لأية محاولة للحل، كما يرجع من ناحية أخرى إلي عزوف النخب القادرة علي طرح الحلول المبتكرة تخوفا و قصورا، تخوفا من دفع ثمن المبادرة و التصدي، وقصورا فيما يتعلق بالمهارات التي يتطلبها تكوين قوى الضغط وكذلك مهارات العمل الجماعي، وغني عن البيان أن عقبتي التخوف والقصور عقبات صنعتها قوي اجتماعية عبر تاريخ ممتد، و لكنها عقبات قابلة للإزالة، ومصيرها حتما للاندثار.
ليس صحيحا أن حل أي مشكلة يحتاج إلي تفكير، فثمة مشكلات لا تتطلب من الفرد سوى أن يلجأ إلى مخزونه من الحلول التي سبق أن مارسها وأثبتت جدواها، وتنتهي المشكلة تمامًا فور استعادة تلك الحلول وتطبيقها، وقد لا تستغرق هذه العملية بكاملها طرفة عين، و لكن للأسف فإن مثل تلك الحلول الخاطفة لا تتحقق في كل المواقف، فإذا ما أخفق الحل التقليدي المألوف فعلى المرء أن يبحث عن حل جديد مبتكر لمشكلته التي يعاني منها، أن يفكر تفكيرًا إبداعيًا، والتفكير الإبداعي يعني الاختلاف، يعني الخروج عن النمط المألوف، وكلها أمور قامت أغلب المجتمعات على رفضها والتخويف منها، فالتنشئة الاجتماعية تقوم عادة على التحذير من الخطأ وعقاب المخطئ، ومن ثم فقد يفضل المرء في كثير من الأحيان أن يتجاهل وجود المشكلة، ومع التجاهل يختفي الهدف، وتتلاشي آلام الوعي والإحباط، وتسود الطمأنينة والسعادة، ولكن تظل المشكلة قائمة بل لعلها قد تتفاقم.
رب من يتساءل، تري وهل هنالك حقًا من يفضلون سعادة اللحظة الراهنة مهما كانت خطورة المشكلات القائمة و القادمة؟ الإجابة الفورية نعم، بل ولعل هؤلاء يمثلون الغالبية في بعض الأحيان، و يصدق ذلك يشكل خاص علي المشكلات الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية، والسياسية، وقد يبدو للوهلة الأولى أن مثل تلك المشكلات بحكم حجمها وشموليتها عصية علي التجاهل، فضلًا عن التجهيل، ولكن الحقيقة غير ذلك تمامًا، إنها الأكثر قابلية للتجاهل، والأكثر استهدافًا للتجهيل، خاصة إذا ما كانت من نوعية تلك المشكلات التي لا تبدو في اللحظة الراهنة سوي علاماتها المنذرة فحسب.
إن تلك المشكلات تتميز بأمور ثلاثة:
الأمر الأول:
أنها ذات طابع تاريخي، يندر ظهورها فجأة بين عشية وضحاها، بل تبدأ نذرها خفية في البداية، ثم تأخذ في التراكم والتضخم والظهور شيئًا فشيئًا، ولذلك فإن رصد بداياتها الأولي، ربما يتطلب توافر عدد من السمات الشخصية، والقدرات العقلية، فضلًا عن بعض المعارف المتخصصة، مما قد لا يتاح مجتمعًا سوى لدي نخبة محدودة من الأفراد. ومثل أولئك الأفراد حين يمسكون بنواقيس الخطر، ويرفعون رايات التحذير، لا يلقون في الغالب من مجتمعاتهم ترحيبًا كبيرًا، إنهم دعاة التشاؤم، المنقبون عن المشكلات، وفي أغلب الأحوال فإن هؤلاء الأفراد يعانون كثيرًا من نبذ أبناء مجتمعاتهم لهم، خاصة أنهم يرون أنفسهم الأكثر انتماءً والأكثر حرصًا على مصالح تلك المجتمعات، ولذلك فإنهم في كثيرٍ من الأحيان يختارون في النهاية الحفاظ علي انتمائهم لجماعتهم وعلى تقبل أبناء جماعتهم لهم ومن ثم فإنهم قد يقدمون علي طي رايات التحذير، و الكف عن دق نواقيس الخطر.
الأمر الثاني:
أن حل ذلك النوع من المشكلات لا يمكن أن يتأتى بجهدٍ فردي مباشر بل لا بد وأن يكون ذلك الجهد جهدًا اجتماعيًا جماعيا مخططًا.
الأمر الثالث:
إن حل ذلك النوع من المشكلات لا يتطلب فحسب وعيًا بالمشكلة، وبحثًا عن الطريق الأنسب للتخلص منها، بل انه يتطلب في أغلب الأحيان تصديًا لقوى ومؤسسات اقتصادية اجتماعية عاتية تستفيد من استمرار تلك المشكلات قائمة بل تدفع بها إلى مزيد من التفاقم.
ومن ثم فإننا لا نبالغ إذن عندما نقرر أن تعثر الوعي, و من ثم التعثر في حل العديد من مثل تلك المشكلات الاجتماعية التي نعاني منها لا يرجع إلى كونها غير قابلة للحل، أو لكونها بالغة التعقيد فحسب، ولكنه يرجع في المقام الأول إلى أوضاع اجتماعية اقتصادية تاريخية تخلق مصالح اقتصادية يقوم بقاء أصحابها على استمرار الحال على ما هو عليه، ومن ثم التصدي بكل الوعي والحسم لأية محاولة للحل، كما يرجع من ناحية أخرى إلي عزوف النخب القادرة علي طرح الحلول المبتكرة تخوفا و قصورا، تخوفا من دفع ثمن المبادرة و التصدي، وقصورا فيما يتعلق بالمهارات التي يتطلبها تكوين قوى الضغط وكذلك مهارات العمل الجماعي، وغني عن البيان أن عقبتي التخوف والقصور عقبات صنعتها قوي اجتماعية عبر تاريخ ممتد، و لكنها عقبات قابلة للإزالة، ومصيرها حتما للاندثار.