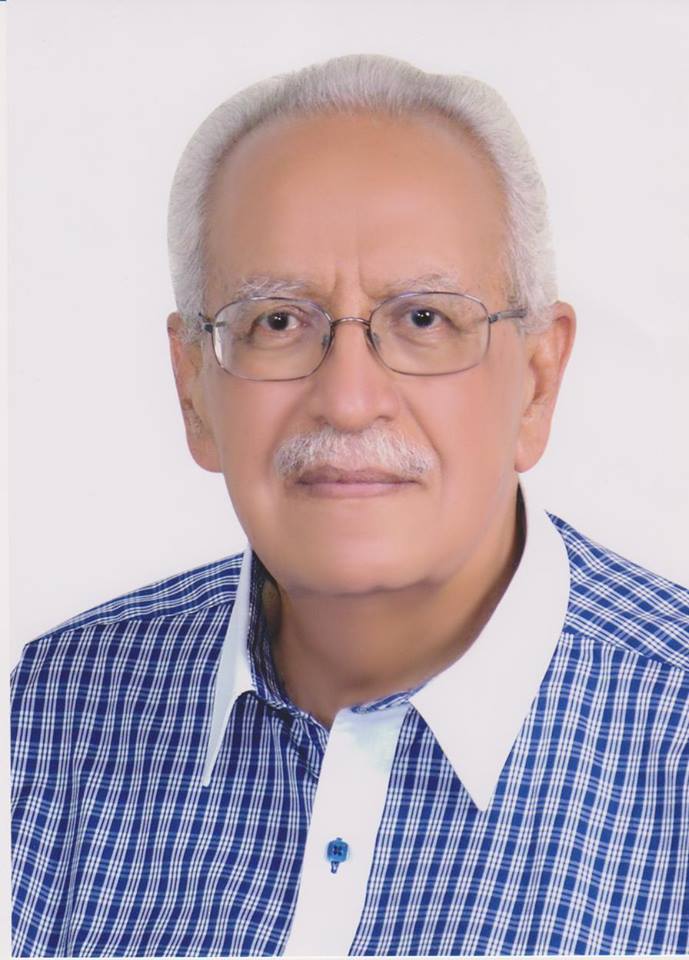[email protected]
علمنا أساتذتنا، ونحن على بداية الطريق في دراسة علم نفس النمو، أن المرء في طفولته يكون أقدر على رفض ما لا يريد بدافع الخوف من المجهول، أو بتأثير خبرات مؤلمة سابقة، ويكون الصغير آنذاك أقل قدرة على تحديد ما يريد.
ومع نضج الفرد ونمو مداركه يصبح أكثر قدرة على تحديد ما يريد. ولعل ذلك المعنى يتجسد في التعبير الشائع في مجال المدح حين نقول “,”فلان يعرف ما يريد“,”.
وعلمونا أيضًا أن ذلك النضج لا يتحقق إلا باستخدام أداة الاستفهام الذهبية التي اتخذها بعض علماء النفس عنوانًا لمرحلة متقدمة من مراحل النضج؛ حيث أسموها “,”مرحلة لماذا“,”.. لماذا نرفض ما نرفض؟ لنصل إلى تحديد ما نريد.
وغني عن البيان أن تحقيق ذلك يتطلب شحذ القدرات العقلية على المقارنة واستقصاء الأسباب. وهي قدرات لا يتمكن منها الصغير إلا بعد أن يشب عن الطوق ويستطيع بحق أن يحدد ملامح ما يريد.
فلنقترب قليلاً من شعارات الدعوة للحرية والديمقراطية في بلادنا. سوف نكتشف أن ثمة كلمة ثابتة تلتصق بغالبية تلك الشعارات. إنها كلمة “,”ولكن“,”..
«نحن مع الحرية طبعًا ولكن لسنا مع الفوضى». «الحرية كل الحرية للشعب ولكن لا حرية لأعداء الشعب». «الحرية للوطنيين الحقيقيين ولكن لا حرية للعملاء والمندسين». «كل الحرية للأفكار البناءة الشريفة ولكن لا حرية للأفكار الهدامة المستوردة». «كل الحرية لأنصار التقدم ولكن لا حرية للرجعيين أنصار التخلف». «الحرية قيمة مقدسة ولكن في حدود الالتزام بثوابتنا الدينية والوطنية».
حتي داخل التيارات الليبرالية تجد من يقول: «كل الحرية لأنصار الحرية ولكن لا حرية لأعدائها من أنصار الحكم المطلق».
قد تبدو كل تلك الشعارات براقة حتى نصل إلى تلك الكلمة المفتاحية “,”ولكن“,”، فإذا ما تساءلت: وكيف يمكن التفرقة؟ كيف يمكن أن يتم الفرز والتمييز؟ كان جوهر الإجابة أن صاحب الشعار هو المرجعية الأولى والأخيرة للتمييز بين العملاء والوطنيين، بين الأفكار البناءة والهدامة، بين التقدميين والرجعيين، بين الثوابت والمتغيرات الدينية والوطنية، وبين الديمقراطية الحقيقية والديمقراطية الزائفة.
ويعلمنا التاريخ أن كافة تلك التمييزات أمور نسبية تمامًا، وأن محاولات القضاء على الأفكار قد باءت جميعها بالفشل، وأن المؤسسات، والنظم، والتنظيمات، لا بد أن تنتهي يومًا، بل ويمكن إنهاؤها، وتستمر بعدها الحياة، فلكل فعلٍ نهاية، أما الأفكار فإنها تتجدد وتتطور.. قد تجمد وتنغلق.. قد يعلو صراخها أو يخفت همسها.. ولكنها أبدًا لا تموت حتى ولو مات أصحابها. تستوي في ذلك أسخف الأفكار، وأروعها: النازية، الشيوعية، الداروينيّة، الصهيونيّة، الاشتراكيّة،... إلخ.
إن الأفعال ترتبط بحياة أصحابها وتنتهي بموتهم. وكذلك المؤسسات تنتهي بانتهاء الحاجة إليها، أو بتدهور أدائها.. أما الأفكار فما دامت قد خرجت من أفواه أصحابها أو من أقلامهم فإنها تظل باقية ولو مختزنة.
إن محاولة القضاء على الأفكار بدعوى اجتثاث الجذور الفكريّة للعنف، أو للفوضى، أو للدكتاتورية، أو للعنصرية، أو حتى للإلحاد، ليست سوى أوهام تدحضها حقائق العلم والتاريخ معًا.. بل إن حقائق التاريخ تؤكد أنه ما من دعوة لتقييد الحرية
-مهما كانت نوايا أصحابها- إلا وانتهت إلى سلسلة من العنف والعنف المضاد.
وطالما أن الأمر كذلك؛ فإن الحل والضمان إنما يتمثل في الدعوة إلى القبول بحق الأفكار جميعًا في التعبير عن نفسها، مهما كانت درجة الاختلاف معها، أو النفور منها، بما يتضمّنه ذلك القبول من تسليمٍ واعٍ بما سوف ينجم عنه من فوضى فكريّة.
إن فوضى الأفكار أقل ضررًا من إرهاب العنف. وضجيج الكلمات، مهما كان ما يسبّبه من إزعاج، أهون كثيرًا، من صوت لعلعة الرصاص.
إن التحديد الدقيق لملامح ما نريد هو المدخل الناضج للتعرف على ما ينبغي رفضه، بل وتحديد الأساليب الأكثر فعالية لمقاومته، وتحديد طبيعة القوى التي تشترك معنا في رفض ما نرفضه والتصدي له.