
تنشر "البوابة" قسمًا من كتاب "مرايا السَّراب.. تفكيك الوعي السياسي العربي" للكاتب الدكتور نايل شامة، الباحث والكاتب في شئون السياسة والثقافة والمجتمع، والصادر مؤخرًا عن دار "صفصافة" للنشر. والذي يتناول ثلاثة أقسام تدور حول العقل العربي وأزمة المفاهيم.
ويضم القسم الأول، الذي جاء بعنوان "الدولة"، الحديث عن الدولة بين المعنى واللاهوت، وتناول الدولة العربية بين خطيئة الماضي ومأزق الحاضر؛ ثم ينتقل إلى القسم الثاني بعنوان "الثورة"، والذي يُشرّح نظرية الثورة، ثم يتناول الأساطير الحاكمة للثورات العربية في 2011، بعدها ينتقل الكتاب للحديث في القسم الثالث عن "العلمانية"، متناولًا التساؤل الأكبر حول ماهية العلمانية، وإشكاليات العلمانية في المجتمعات المسلمة.
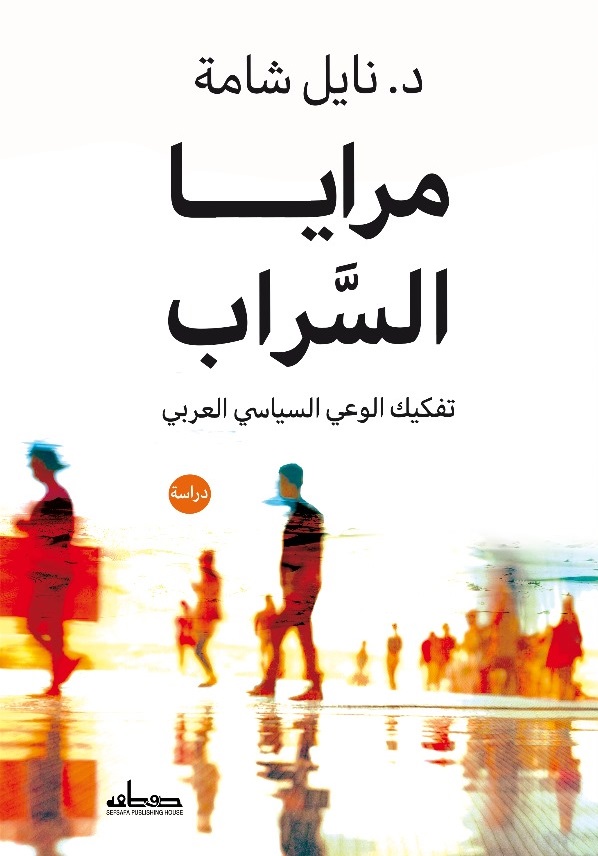
عملية تكوُّن الدولة القومية
عاش البشر عبر آلاف السنين في ظل سيطرة الإمبراطوريات والجماعات الدينية، مع استمرار وجود مساحات مأهولة بجماعات بشرية خارج سلطان أي سلطة فوقية، ومساحات أخرى خاضعة لعدة سلطات متداخلة ومتنافسة (يفرضها ملك أو أمير أو زمرة من الأرستقراطيين أو بابا أو أسقف، إلخ). في تلك الأزمان البعيدة، اتَّسم الحكم بالسيولة الشديدة والشخصانية وغيبة المؤسساتية والقواعد الواضحة، أي كان مناقضًا تمامًا للدولة الحديثة القائمة على مبادئ المركزية والوحدة والهرمية والحياد والانحصار في إقليم بعينه. في ذلك الزمان، وهو ما قد يبدو أمرًا مُلغِزًا بمنطق العالم اليوم، لم تكن الثقافة أو العرق أو اللغة قوة موحدة للجماعات البشرية في مدائنهم وقراهم ودساكرهم وضِياعهم، بل كان مجرد السؤال عما إذا كان المرء يحب ثقافته أمرًا لا معنى له (لاحظ كيف صار اليوم موضوعًا يُقرض فيه الشعر ويتغنى به المطربون)، إذ تعامل معها الناس لا كموضوع للتأمل أو عنوان للهوية بل "كأمر مفروغ منه، تمامًا كالهواء الذي يتنفسونه". وحتى حيث وُجد إحساس ما بالوحدة الثقافية، كما في اليونان القديمة، لم يوجد شعور بجبرية تحويل هذه الرابطة العاطفية العميقة إلى كيان سياسي موحَّد. وغنيٌّ عن البيان أن طرق التعبير عن هذه الوحدة خلت في ذلك الزمان القصي من شعارات مثل "مصر هي أمي"، أو "عاش العراق"، أو "تحيا الجزائر"، أو "شعب واحد، رايخ واحد، قائد واحد" الذي رفعته ألمانيا النازية لتوحيد الشعوب الجرمانية.
في زمن الإمبراطوريات مترامية الأطراف، مثلت "الإمبراطورية" النظام الوحيد المتصور الذي ينضوي تحت لوائه الإنسان. لم يخطر ببال الناس، حتى المحلِّقين في الخيال منهم، إمكانية وجود أي نظام آخر بديل. في الإمبراطورية، حكم الحاكم أو الإمبراطور مدعومًا بالحق الإلهي، وبذلك امتلك السلطتين الدينية والدنيوية معًا، فكان كأنه ظل الله على الأرض (أو خليفة الله في أرضه بالتعبير الإسلامي)، ومكث السكان تحت كنفه كرعايا لا مواطنين. لم يفكر الناس، حتى في خلوات النفس، بمنطق "الجنسيات" الشائع كبطاقة تعريف في أيامنا هذه. ولذلك كان عاديًّا تمامًا أن تتكون النخب الحاكمة في كثير من الإمبراطوريات من "الأجانب" أو الغرباء، أي أن يكون انتماؤهم العرقي إلى سلالة مختلفة عن تلك التي تضم غالبية الشعب، أو حتى أن يكون لسانهم أجنبيًّا مغايرًا للسان رعيَّتهم (وهو أمر حريٌّ في عالمنا المعاصر بإثارة الاستهجان وحتى تفجير الثورات). وكثيرًا ما استُعيض عن الحروب كوسيلة لتعضيد الحكم وتوسيع المُلك بالزِّيجات الملكية، التي تمَّ بمقتضاها توحيد مساحات واسعة من الأراضي، تسكنها جماعات متباينة دينيًّا وعِرقيًّا ولغويًّا، تحت راية إمبراطورية واحدة وعائلة ملكية حاكمة، واحدة، دون أن يشعر أحد بأي وصمة أو غضاضة. وحتى الحروب بين الممالك كانت، بتدقيق النظر، صراعًا بين سلالات حاكمة أكثر من كونها حروبًا بين دول أو شعوب. لم يضمر أحدٌ في أعماق سريرته، لا بخفقات القلب أو خطرات العقل، فرنسيَّتَه أو إنجليزيته أو ألمانيته، فتحت ظل الحاكم الإله وأسرته المقدسة خلفًا عن خلف، انتسب الجميع في استقرار مقيم وبساطة متناسقة. وفي حين نشير اليوم إلى رؤساء الدول، وخاصة في الدول الديمقراطية، باسمهم الأخير (فيقال أوباما وترامب وميركل وشيراك وهكذا)، جرت العادة على استخدام الاسم الأول فقط للإشارة إلى الملوك في العصور السالفة (فقيل مثلًا هنري الثامن ولويس الرابع عشر وإدوارد الخامس وهكذا)، ببساطة لأن الاسم الأخير ثابت باستمرار ما دام حكم الأسرة قائمًا. أيضًا، ظلت الحدود بين الإمبراطوريات المختلفة غير محددة بدقة، بل كانت مسامية ومتداخلة متيحة للبشر والدواب حرية العبور عبر الأمصار والمناطق والمدن بسهولة ويسر، وبالتالي فإن منطق السيادة -الصارم تطبيقه في يومنا هذا- كان يتلاشى تدريجيًّا عند الدنو من الحدود. والغريب لم يكن فقط قدرة الإمبراطوريات على احتواء جماعات من أجناس وأعراق وأديان مختلفة تحت رايتها، بل أيضًا على ضمِّ أقاليم غير متجاورة جغرافيًّا بسهولة شديدة.
لكن كيف أفَلَ نجم الإمبراطورية بعد طول بريق؟ وكيف، بعدها، تشظى العالم إلى مئات الكيانات السياسية الصغيرة؟ ثم لماذا انخفض عدد الوحدات السياسية المستقلة في أوروبا من خمسمائة تقريبًا في عام 1500م إلى نحو خمس وعشرين فقط في عام 1900م؟ وكيف، بعد طول المسير، تكونت أخيرًا الدولة القومية وحلت محل الإمبراطوريات والإقطاعيات والمدائن ذاتية الحكم؟ وما العوامل السياسية والسوسيولوجية التي ساهمت في قيام الدولة القومية؟ وكيف صارت هذه الدولة بتلك الانتشار والمنعة والرسوخ ولم يمضِ على قيامها سوى نحو مائتي عام؟ ثمة مدرستان رئيسيتان تشرحان عملية صعود وتمدد الدولة القومية: الأولى: تضعها كناتج من نواتج عملية التحديث واسعة النطاق والتأثير في القرون المنصرمة (ومن أبرز منظِّريها أندرسون وجيلنر)، والثانية: ترى الدول القومية كانعكاس للانتماءات الإثنية (ومن أبرز منظِّريها سميث).

لا يمكن بحال من الأحوال الحديث عن نشأة القومية دون التعريج على إسهامات الباحث الإيرلندي بنيديكت أندرسون (1936-2015م) في كتابه المرجعي "الجماعات المتخيَّلة". يذهب أندرسون في كتابه، وهو نتاج عمل بحثي استقام على مقتضى التماسك النظري والعملي، إلى اعتبار القومية ثمرة لعمليات التحديث، التي أصابت صلب العلاقات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات بخلخلة شديدة في القرون القليلة الماضية. يشير أندرسون إلى عدة عوامل رئيسية ساهمت في ذلك. من هذه العوامل بزوغ الطباعة، التي أدَّى انتشارها في طورها الرأسمالي في القرن السادس عشر إلى زلزلة الأرض من تحت أقدام اللغة اللاتينية، ووضعها شبه المقدَّس في العصور الوسطى (حيث كانت اللغة الوحيدة التي يتم تدريسها)، وفي الوقت ذاته تمهيد المعراج لصعود اللغات الأوروبية المختلفة (مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية، إلخ). تشير إحصائيات النشر إلى أن الكتب المطبوعة باللغة اللاتينية مثَّلت قبل عام 1500م نحو 77% من إجمالي عدد الكتب المطبوعة في أوروبا. ذاعت في تلك الفترة أعمال الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز، المنشورة باللاتينية، فيما كلَّل التجاهل مسرحيات شكسبير، المكتوبة بالإنجليزية، وكانت بعدُ لغةً عامية شأنها شأن باقي اللغات الأوروبية. ويتساءل أندرسون عما إذا كانت أعمال شكسبير العظيمة ستظل طيَّ الغموض لو لم ترتقِ الإنجليزية في القرنين التاليين لمرتبة اللغة الكلاسيكية. وبالفعل، سريعًا ما تبددت هيمنة اللاتينية على دنيا النشر مع سموق شمس الطباعة. ولنأخذ فرنسا مثالًا، فمن بين ثمانية وثمانين كتابًا طُبعت في عام 1501م، كانت ثمانية كتب فقط بغير اللاتينية، لكن أكثر من نصف الكتب المطبوعة في عام 1575م (بالتحديد 55%) صدرت بالفرنسية، وقد كان يُنظر إليها من قبل على أنها "نسخة فاسدة" فحسب من اللاتينية. نرى نفس النسق وبوتيرة أسرع في ألمانيا، ففي حين صدر أربعون عنوانًا فقط باللغة الألمانية في عام 1519م، ارتفع العدد بحلول عام 1525م إلى 498 عنوانًا.
ليس هذا فقط، فعلى مستوى الكم أيضًا، زاد في المطلق عدد الكتب وعدد طبعاتها، وأصبح الكتاب بحلول القرن السادس عشر، أو السابع عشر على أقصى تقدير، في متناول الجميع. ثم شاع مفهوم الطبعات الشعبية فصارت بعض الكتب تباع كالخبز، وذاع صيت بعض المؤلفين الذين تكفي شعبيتهم الجارفة لضمان إقبال الناس على ما يكتبون. كان أول هؤلاء ربما هو مارتن لوثر، ثم تبعه آخرون مثل موليير وجان دو لافونتين وبيير كورني، الذين أقبل الناشرون على شراء أعمالهم باعتبارها استثمارًا مضمونًا. ثم أدى انتشار اللغات العامية على هذا النحو إلى اعتمادها كلغات رسمية في الأجهزة الإدارية للدولة، وكان ذلك من قبل أمرًا غير مطروق. كما أدَّت ثورة الطباعة إلى انتشار الصحف الصباحية على نطاق واسع، والتي شبَّهها هيجل في زمانه بالبديل الحديث للصلوات الصباحية.
الأهم من كل ذلك أن انتشار اللغات على هذا النحو الواسع أدى إلى نسف التصور القديم القائم على أن الوصول إلى "الحقيقة" مرهون بالقدرة على إجادة لغة مقدسة مقصورة على نخبة صغيرة -ومنغلقة على نفسها- من البشر. تزامن ذلك مع تضعضع دور الكنيسة وصعود الأفكار العلمانية، مما خلق فراغًا هائلًا تم ملؤه بواسطة المشاعر الوطنية في الأقطار الأوروبية المختلفة. خلاصة القول، صار الوطن، لا الله أو الكنيسة أو اللغة المقدسة، هو الملاذ.
بالتوازي مع هذه التطورات الحاسمة، اختلف مفهوم "الوقت" في المجتمعات الحديثة عمَّا كان سائدًا في مرحلة ما قبل الحداثة. ففي المجتمعات الحديثة يسود تصوُّر يسميه أندرسون "بالوقت الخالي المتجانس" (homogeneous empty time). فبفضل اكتشاف الساعة والتقويم ووسائل الاتصال والصحف وحركة الأفراد ورؤوس الأموال، أصبح للوقت تزامن ما عرضي يمضي في حركة ثابتة للأمام، وليس في حركات دورية متتابعة. يدرك أفراد كل جماعة طبيعة هذا الوقت بوعي واضح، ويرونه في سياقه كعلامة على الحركة، على المضي إلى المستقبل؛ وكذلك الأمم المتخيلة، تمضي فقط إلى الأمام. أدى كل ذلك مُجتَمِعًا -نشر المعرفة بواسطة الطباعة وصعود اللغات الأوروبية والخروج من عباءة الممالك المدعومة بالحق الإلهي وتطور مفهوم الوقت- إلى إذكاء الشعور القومي بالتدريج في سائر ربوع أوروبا، ثم في كافة أرجاء المعمورة.



