

ومن كان يتنبأ قبل أربع سنوات بأن أوروبا سوف تعاني من كارثة صحية، ثم تجد نفسها في مواجهة حروب تندلع واحدة تلو الأخرى على أراضيها أو على حدودها (أرمينيا، إسرائيل)، كان يعد ضربا من الخيال ولكن حدث ما لم يكن متوقعا ومما يزيد الأمر إثارة أن القارة القديمة كانت تعتبر قارة السلام. وفي عام ٢٠١٢، حصل الاتحاد الأوروبي على أعلى وسام، وهو جائزة نوبل، لتحويل منطقة مزقتها الحروب إلى مساحة للسلام. وشددت لجنة أوسلو على أن الاتحاد الأوروبي وأسلافه عملوا على تعزيز السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا على مدى ستة عقود.
وكل شيء ينهار على الفور تقريبًا؟ كيف هذا ممكن؟ إن أبسط إجابة هي بالطبع أن القصة لن تكون متوقعة وهذا صحيح جزئيًا، ولكن فقط عندما يتعلق الأمر بسلسلة من الأسباب غير المرتبطة كما أن هناك صعوبات كبيرة. ولم يكن بوسع أحد أن يتنبأ بالانهيار الاقتصادي في عام ٢٠٠٨. ولو فعلوا ذلك، فما كان ليحدث ببساطة. وينطبق الشيء نفسه على الكارثة الأولية في القرن العشرين، الحرب العالمية الأولى. لقد حدث الهجوم في سراييفو لأن المسئولين عنه، أي المخابرات النمساوية والمحكمة في فيينا، استهانوا بالخطر. وحتى بعد الهجوم على فرانز فرديناند في ذلك اليوم، فقد سلك نفس المسار مرة أخرى بعد بضع ساعات، وبالتالي لقي مصيره ومعه، لقي أكثر من ٢٠ مليون شخص مصيرهم على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ومع ذلك، وعلى عكس الكوارث الأخرى التي ضربتها عبر التاريخ، فإن أسباب التفكك الحالي واضحة تمامًا. من المؤكد أن هذه الظواهر تطورت ببطء، لكنها اكتسبت زخما في نهاية الحرب الباردة، عندما اكتسبت النيوليبرالية، التي بدت وكأنها الصيغة التاريخية الوحيدة المنتصرة، حصانة ضد الفشل بفضل الغياب المفترض للأيديولوجية: الماركسية، والشيوعية، والاشتراكية الحقيقية والرأسمالية. أما المذاهب الأخرى (التطرفية على سبيل المثال) فكانت ستفشل جميعها لأنها كانت محملة عقائديا؛ فلقد قدموا أيديولوجية جديدة وكانواعرضة للموت.. بالفعل كل ذلك لا يحكي القصة بأكملها.
وبما أن النيوليبرالية كانت الفاعل الوحيد المتبقي على الساحة، فقد أطلق فرانسيس فوكوياما نظرية النهاية الحتمية للتاريخ. وهي أطروحة ما كانت لتكون مدوية إلى هذا الحد لو لم تقع على أرض خصبة للغاية. في الغرب، وعلى وجه التحديد في القارة الأصلية، في أوروبا، كان هناك قناعة بالإجماع بعد سقوط جدار برلين بأن التاريخ قد انتهى، وبالتالي لا بد من استخلاص بعض العواقب الضرورية.
ومع ذلك، فقد تبين أن هذا هو الافتراض الأكثر أيديولوجية الذي عرفته أوروبا، إلى جانب الأنظمة الشمولية في ثلاثينيات القرن العشرين؛ كما أن فرضية نهاية التاريخ هي في الواقع تبقى أيديولوجية؛ فهو يعمل بمبدأ "القنبلة العنقودية". وهو في حد ذاته ليس خطيرا: الخطر هو ما يحمله في داخله. وما ينفجر عندما يصطدم بالأرض، أو عندما يلامس الواقع الاجتماعي. لذا، فعندما قررت أوروبا نهاية التاريخ، اختارت أيضًا أن تترك مجالها لتطغى عليه الأيديولوجيات التي تمكنت حتى ذلك الحين من الإبقاء عليها عند بابها. ولكن لم يستشعر أحد الخطر الأساسي، وهو أن هذا من شأنه أن يكلف القارة القديمة المكانة التي احتفظت بها لعدة قرون، باعتبارها خالق الحضارة الغربية.
ولذلك جاءت الضربة الأقوى لتضرب العمود الذي يحمل الثقل الأكبر، أو بالأحرى، الذي يمثل هويته الأساسية؛ إنها المسيحية. منذ معاهدة ماستريخت (١٩٩٢)، أصبحت القوى التي تريد محو الهوية المسيحية من أوروبا في السلطة بشكل متزايد. لقد تطورت الأمور مرة أخرى في الآونة الأخيرة كما أن الهوية المسيحية ليست الوحيدة المزعجة إضافة إلى أن مراكز القوة - دعنا نسميها كذلك - يعوقها أي ثبات للهوية، لأن الهوية هي ملجأ الإنسان وجوهره. وهكذا، فإن أولئك الذين يشكلون مصيرنا، والذين يتواجد مبعوثوهم في بروكسل وبرلين وباريس، يعارضون هوية الأمم واللغات، وأيضًا يعارضون الهوية الجنسية بشكل متزايد.
هذه الأفكار كانت حاضرة منذ ثورة ٦٨ فى فرنسا، وقد أدخلها إلى الفضاء الأوروبي جان بول سارتر وإلى جانبه يقف أولئك الذين يسميهم إريك زمور بـ"مؤلفي الانتحار الفرنسي"، أو حاملي "النظرية الفرنسية". لكن الشيء الرئيسي هو سارتر.. لقد شكلت في الواقع مفهومًا أصبح اليوم مرادفًا لكل شيء، عندما لم يعد يعني أي شيء؛ إنها الحرية. لم يسبق في التاريخ أن كان هناك وقت حُكم فيه على الإنسان حرفيًا بالحرية، وكانت الحرية أساس كل ما يحدث؛ لكن هذه الحرية ليست مطلقة، كما ينبغي أن تكون، بل هي نسبية: فهي مشروطة بهوية لحظية زائفة.. الحرية عند سارتر تعني ببساطة حرية تحقيق الذات، في أي اتجاه، دون التزام.
لقد قال: أنا ما أصنعه بنفسي ولا ينبغي أن يقف أي شيء في طريق هذه الحرية وهي السلطة على الأقل! إذا واجه تلاميذ المدارس الصغار معلما يقول شيئا حاسما لهم، فإن الوالدين يذهبون على الفور إلى المدرسة مع المحامين وينطبق الشيء نفسه إذا منع شخص ما الطفل من استخدام الهاتف الذكي فهذا يمثل اعتداءً خطيرا على حريته، وعلى هويته التي يختارها بنفسه، حتى لو كان سوء استخدام الهواتف المحمولة جزءًا منها!.
هذا ما نحن فيه!
لقد أصبح تحقيق شبه هوية الإنسان هو الهدف الرئيسي للديمقراطية.. هل تعتقد أن هذه مجرد هراء؟ لا، لأنه يحدث في الحياة اليومية، تحت راية "المثلية الجنسية" LGBT+، على سبيل المثال. هناك الكثير لدرجة أن الجميع سئموا من كل ذلك! على سبيل المثال، نوصي بالحرية بين الجنسين: ففي غضون عشرة أو خمسة عشر عامًا، سيكون من الطبيعي أن تستيقظ في الصباح كامرأة وتذهب إلى الفراش ليلًا كرجل. لم يعد الإنسان كائنًا اجتماعيًا، بل أصبح كائنًا انتقاليًا.. لا توجد قيم متفوقة على الآخرين، ولا توجد حدود واضحة.. ماذا تبقى؟ أنا محكوم علي بالحرية، محكوم علي أن أفعل ما أريد؛ ولكن في الواقع، أنا محكوم علي بالعدم.
إن ظهور هوية مزيفة يُظهر أننا لم يعد بإمكاننا تحقيق أهداف مشتركة ونحن نبحث عن أهداف في هويتنا الفردية: أنا نباتي، أنا وأنا متحول جنسيًا ولهذا السبب هناك المزيد والمزيد من الإمكانيات لتحقيق هوية الفرد حيث يتم وضع الهوية في مكان العمل السياسي وفي مكان الجهد من أجل الصالح العام ولكن هناك عدد غير قليل من المستفيدين من الفوضى: لا الإنسان، ولا الكنيسة بل السوق. إذا تم تصنيف التغيرات الجنسية على أنها نفقات في الميزانية وتم تمويلها من قبل الصحة العامة، فسيكون ذلك أعظم منجم ذهب للطب والصيدلة.
إن الشخص الذي لا يفكر في نفسه ككائن متعالٍ، بل يرى نفسه كشخص يجب أن يدرك أنه سوف يستهلك الكثير، وبالتالي يسمح بأرباح أولئك الذين يستفيدون من "حرية" الإنسان. في الواقع، إنها تجربة هائلة، وربما هي الأكبر على الإطلاق التي قامت بها البشرية، وكان هناك الكثير منها. ومع ذلك فإن كل التجارب الاجتماعية تنتهي بنفس الطريقة، أي بالفشل. ماذا سيحدث مع التجارب التي لا يقتصر مجالها على الطبيعة الاجتماعية للإنسان، بل على كيانه البيولوجي؟ الحل ؟ بسيط جدا وهو إلغاء نهاية التاريخ وإزالة كل الأيديولوجيات التي اخترقت الفضاء الأوروبي والتعلم من الحضارات التي لم تفكر قط في إلغاء تاريخها!.
سيباستيان ماركو تورك: دكتوراه فى الآداب من جامعة «السوربون» باريس وأستاذ جامعى، يناقش، الانتخابات الأمريكية التى تجرى فى العام المقبل.. يكتب عن مستقبل القارة الأوروبية.




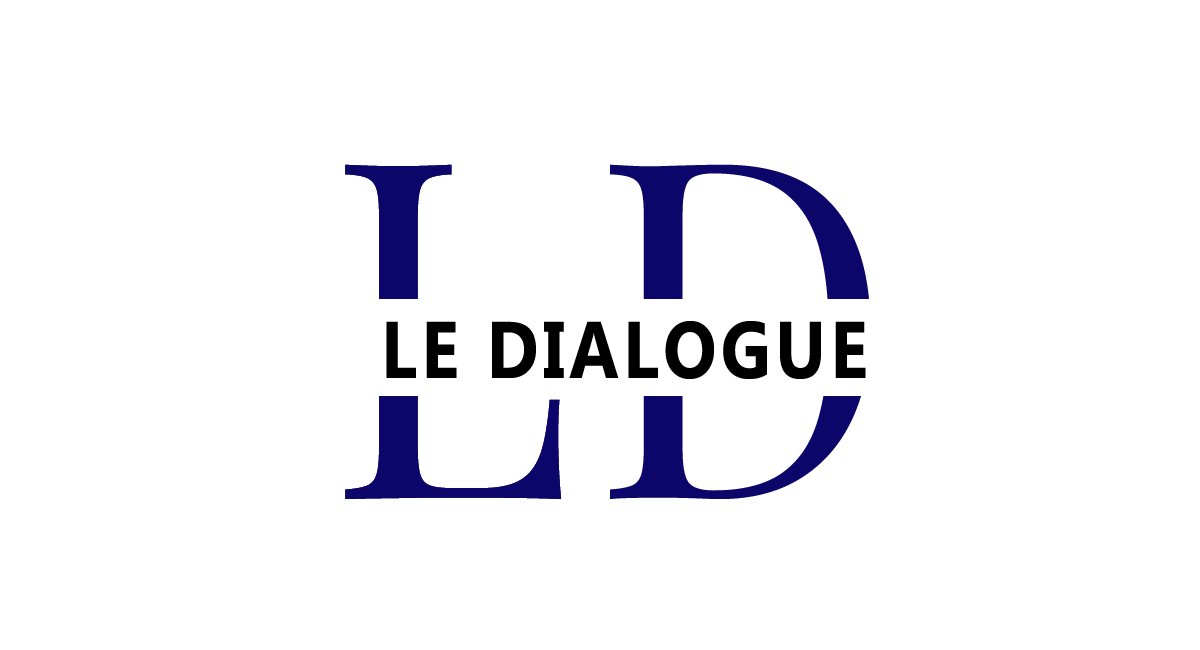 بالعربي
بالعربي
