
فى الحقيقة يعتبر تدهور الغرب هوعبارة عن عملية ديناميكية كانت قد بدأت بشكل مكثف بعد عام ١٩٦٨. وبالرغم من ذلك، فقد اكتسبت وتيرة أكثر سرعة إلى الحد الذى دفع الكثيرون إلى التساؤل عما يحدث حقًا؛ فحجم التغييرات والسرعة التى يتم بها التنفيذ هو أمر مذهل للغاية والأمر المثير للدهشة هو أنها تعتبر عملية موجهة على حساب غالبية السكان! ومن المذهل أيضا أن كل التطورات الجديدة التى واجهها الغرب على مدى العقد الماضى هناك قاسم مشترك فيما بينها، ألا وهو أنها متناقضة بشكل ملحوظ.
وفى الواقع يفرض الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وجماعات اللوبى غير الظاهرة والرعاة والمنظمين الرئيسيين لهذا التدهور الغربى - بمساعدة مستمرة من الأغلبية الإعلامية- قانون التناقض وهنا يمكننا أن نعتبر أن هذا التشبيه مقصود بهدف استبعاد السكان الغربيين أو الأوروبيين بصورة أساسية ويعد هذا الأمر ظاهرة لم يعرفها التاريخ من قبل.
نظرية «الوكيزم» والهجرة من خارج أوروبا.. مثالان صارخان
دعونا نأخذ فقط الأمثلة الأكثر إثارة للانتباه: مجتمع المثليين والهجرة من دول غير أوروبية. هناك أشياء قليلة متناقضة لا يريدها المثليون جنسيًا أو المثليات. وربما تكون هناك أقلية صغيرة بينهم من ذوى التوجهات الناشطة (وغالبًا ما يحصلون على أجور جيدة فى المنظمات غير الحكومية) ولكن أغلبهم يطمحون إلى الاندماج السلمى فى المجتمعات. وفى الواقع، لا أحد يفكر فى الكشف عن حياته الشخصية فى الأماكن العامة أو حتى إظهارها خلال المسيرات، حتى ولو كانت مسيرات للتفاخر.
وعلى الرغم من أن هذا يعد تناقضًا مرة أخرى، إلا أنه حتى أولئك الذين يمثلون المسيحية على أعلى مستوى يتفقون مع تلك الآراء والتوجهات؛ ففى السويد، أصدر رئيس أساقفة أوبسالا تعليماته إلى رجال الدين بتجنب ضمائر المذكر عند الحديث عن الذات الإلهية!
ولكن لا يمكنك الاستسلام وتغيير جنسك حسب الرغبة؛ فاختلاط الأنواع يوازى اختلاط الثقافات والهويات. ولا يمكننا تغيير وتكييف ثقافتنا أوهويتنا مع أى بيئة. وفى هذا الصدد، هناك تناقض جديد يفرضه أولئك الذين يشكلون الرأى العام، ألا وهو أن التعددية الثقافية شرط أساسى للتعددية السياسية أو الديمقراطية. والتعددية هى فى الواقع شرط من شروط ذلك وهى الرابط بين الأنظمة السياسية التى تشكلت لأول مرة فى الولايات المتحدة وأوروبا. فالتعددية تضمن توافق مصالح المواطنين المختلفة والمتضاربة فى كثير من الأحيان، وذلك عبر الجسم الاجتماعى مما يعنى أن المواطنين (أولئك الذين يعبرون عن هذا الطموح) لديهم الفرصة للتواصل بطريقة تمكن من تحقيق المشاريع المشتركة. وبالتالى فإن التعددية لا وجود لها بدون الأحزاب السياسية والانتخابات والممثلين المنتخبين ديمقراطيا.
ولكى يعمل المجتمع بشكل كامل فى ظل ما يسمى بالديمقراطية، فإن التعددية، بالمعنى الموصوف للكلمة، تكفى لذلك الأمر. وعلينا أن نتذكر أيضا أن إدخال عناصر التعددية الثقافية لا يضيف شيئا إلى التعددية السياسية فحسب، بل إنه يؤدى إلى الارتباك وإلى إضعاف تلك التعددية السياسية لأن العديد من البلدان غير التعددية - أو التى لم تكن كذلك - كانت متعددة الثقافات ومثال على ذلك يوغوسلافيا المكونة من تسع دول وقوميات وثلاث ديانات وكتابتين (اللاتينية والسيريلية)؛ لكنها لم تكن تعددية ولا ديمقراطية. وعندما تضاءل الإرهاب السياسى مع التغيرات الديمقراطية فى أوروبا (سقوط جدار برلين)، بدأت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية فى التحول إلى دولة تعددية ولكنها لم تتمكن أبدًا من أن تصبح متعددة الثقافات. ومن هنا نرى ونفهم الحرب الأهلية التى بدأها سلوبودان ميلوسيفيتش بإسم هيمنة الهوية الصربية على الهويتين البوسنية والكرواتية!
وفى الحقيقة، لم يكن الاتحاد السوفييتى بلدًا تعدديًا قط، والسؤال حول ما إذا كانت روسيا القيصرية كانت تعددية قبل ذلك، هو مجرد أمر نظرى أو بلاغى وكلاهما كانا متعددى الثقافات وخاصة الاتحاد السوفييتى. وتحدث لينين كثيرا عن حق الأمم فى تقرير مصيرها وحقوقها. وأصدر قانونا تاريخيا أنكر فيه مؤسس الاتحاد السوفييتى هذا الحق.. إلا أنه تم تطبيق مبدأ الأمم المتحدة فى تقرير المصير بالتحديد فى العام الذى انهارت فيه الإمبراطورية الحمراء (١٩٩١). وأيضا نذكر هنا أن الصين اليوم دولة متعددة الثقافات ولكنها ليست تعددية ولا ليبرالية ولا ديمقراطية. واليوم، كثيرًا ما تكون الدول المتعددة الثقافات غير ديمقراطية وهى فى كثير من الأحيان أيضا متعددة الصراعات، أى أنها مستنزفة بسبب خلافات وطنية متعددة غالبا ما تندلع فى شكل حروب أهلية. وهذا هو حال بيروت والبوسنة والهرسك الحالية، على سبيل المثال لا الحصر ولسوء الحظ، فإن بعض مناطق أوروبا وخاصة فى فرنسا، معنية بهذا الأمر بشكل متزايد.. ولكن التدمير الذاتى المتعمد للغرب، والذى أصبح الآن أمرًا شائعًا، لا يتوقف عند هذا الحد بل يمتد الأمر إلى منطقة أكثر حساسية، وهى الهوية الثقافية. وفى هذا الصدد، تتجلى عملية واضحة تدفع سكان الغرب إلى الندم على الجذور التاريخية لثقافتهم، بحجة تعرضها للاستعمار والعنف ضد الأمم الأخرى. كما أن موقع الدول الغربية قد سبب الكثير من سوء الحظ للدول الأخرى وخاصة فى القارات الأخرى. يسمح الناس (فى الولايات المتحدة) عن طيب خاطر بأن يتم تقييدهم بالسلاسل (مثل العبيد)، ويتجولون ويعترفون بخطئهم بصوت عال! وهنا مبدأ الحرية ليس واضحا. وكاتب هذا المقال يأتى من بلد كان أيضًا مستعبدًا فى ظل الشيوعية ويعرف ما هى الحرية ويعرف كيف يقدرها: ولكن فى الوقت نفسه، يبدوله أن اتباع بروتوكولات تركز على مبدأ «اتهام الذات» هذه سيكون بمثابة نهج مرضى فى الأساس.
الهدف العابر للحدود الوطنية للمؤسسة الغربية
فى أوروبا، وهى المجال الرئيسى لتطبيق ما يسمى بانتحار الهوية، يطمح أصحاب السلطة سياسيًا وإعلاميًا إلى تحقيق هوية عابرة للحدود الوطنية تختفى فيها الأمم والثقافات الفردية. ويتجلى مدى تناقض هذه التطلعات، على سبيل المثال، فى فكر أندريه مالرو، الذى عبر عنه فى واحدة من أشهر خطاباته فى فترة ما بعد الحرب.. كلماته تكاد تكون أكثر واقعية اليوم أكثر مما كانت عليه عندما قيلت وهكذا: «نحن نعلم أننا لن نكون أكثر إنسانية إذا كنا أقل فرنسية.. وفى السراء والضراء، نحن مرتبطون بالوطن ونعلم أننا لن نكون أوروبيين بدون هذه الهوية».
وفى واقع الأمر: مع التهديد بالتقليل من قيمة هوية المرء، فإن هناك شيئا ما يخرج عن الواقع. وفى الحقيقة هى حالة تحتاج إلى علاج نفسى ويجب على السلطات وسائل الإعلام من المواطنين تبنى سلوك يُعامل الفرد على أنه مرضى. ولا شك أن مثل هذه المفارقات لم تكن موجودة قط فى تاريخ أوروبا.. وإذا كان هناك الهدف النهائى من كل ذلك هو ألا يحترم الفرد الغربى ذاته؛ فهذا يعنى أن هناك خطأً كبيرًا لدى أولئك الذين يسعون لتحقيق ذلك.
دعونا نأخذ مثال الفرد الذى يعانى، على سبيل المثال، من تدنى احترام الذات. وهذا يلعب دورًا مهمًا وله تأثير كبير على سعادته ونوعية حياته حيث يشعر الأشخاص الذين يعانون من تدنى احترام الذات بأنهم ليسوا جيدين بما فيه الكفاية أو غير قادرين على فعل أى شيء بشكل صحيح، مما قد يؤدى إلى تطور مشاكل مزمنة مثل الاكتئاب والقلق. وبالتالى فإن أصحاب السلطة فى الغرب ووسائل الإعلام الرئيسية يدفعون الناس إلى مواقف قد تتعرض فيها نزاهتهم للخطر. كما أن فرض «تدنى احترام الذات» هو فى الواقع تحضير للتخلى عن هوية الفرد أو تبنى هوية أخرى وهى مسألة تتعلق بعلم النفس السريرى والعلاج النفسى. ويعانى الأشخاص الذين تخلوا عن هويتهم القديمة وتبنوا هوية جديدة من متلازمة «تعدد الشخصيات».. أى ما يسمى باضطراب الهوية الانفصامية ويتم علاجه على هذا النحو وغالبًا ما توجد هويتان أو حالتان شخصيتان على الأقل داخل هذا الفرد!

يتعلق الأمر بفرض الوعى بالذنب، مما يجعل الغربى كائنًا بلا جذور وبلا هوية أو شخصا بهوية معدلة. ولم يعد هناك مكان للذاكرة التاريخية والجذور الثقافية وكل ما يضعنا فى مواقع أرقى. وينطبق هذا أيضًا على الأشخاص من مجتمع LGBT+، وخاصة الأشخاص المتحولين جنسيًا الذين يقعون فى هويتين سواء اعترفوا بذلك أم لا.
لماذا تعطى النخب الغربية الكثير من الاهتمام والدعاية لنظرية «الوكيزم"؟
السؤال الأساسى الآن هو لماذا تحظى هذه العمليات المرضية بهذا القدر الكبير من الاهتمام ولماذا يتم تخصيص الكثير من الطاقة لها فمن الصعب الإجابة عن مثل هذه التساؤلات مع ذلك، يمكن اقتراح الحل التالى: الأمر يتعلق بتدمير الحضارة الغربية من خلال نوع من التجربة التى تستخدم مبدأ نافذة «أوفرتون» والمعروف أيضًا باسم نافذة الخطاب. وكل ذلك عبارة عن قصة رمزية تحدد الأفكار أو الآراء أو الممارسات التى تعتبر مقبولة إلى حد ما فى الرأى العام للمجتمع. وهذا المصطلح ينشق من الفكر الذى قام بتأسيسه، جوزيف ب. أوفرتون. ويشير فى وصفه لهذا التعريف إلى أن الجدوى السياسية لفكرة ما تعتمد فى المقام الأول على ما إذا كانت تقع ضمن هذه «النافذة التى تعتمد على الانفتاح» وليس على «التفضيلات الفردية للشخصيات السياسية».
وفى وصف أوفرتون، تتضمن نافذته سلسلة من السياسات التى تعتبر مقبولة سياسيًا وفقًا للرأى العام الحالى والتى يمكن للسياسى أن يقترحها دون اعتباره متطرفًا للحصول على منصب عام أو الاحتفاظ به؛ لذا يحاول أصحاب السلطة ووسائل الإعلام إقناعنا بأن الشيء غير الطبيعى هو فى الواقع أمرا طبيعيا. وبما أنه لم يكن أحد يفكر بهذه الطريقة قبل عقد من الزمان، فسوف يقنعوننا قريبًا بأن الجميع قد فكروا بهذه الطريقة ولكننا لم ندرك ذلك! والحل؟ الحل هو التحدث عن الأمر والكتابة عنه وهذا أيضًا هوغرض هذه المقالة، بالرغم من نافذة «أوفرتون"!
معلومات عن الكاتب:
سيباستيان ماركو تورك.. دكتوراه فى الآداب من جامعة «السوربون» باريس وأستاذ جامعى، يتناول عدة تناقضات يعيشها الغرب ومؤسساته مقابل الموقف من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.




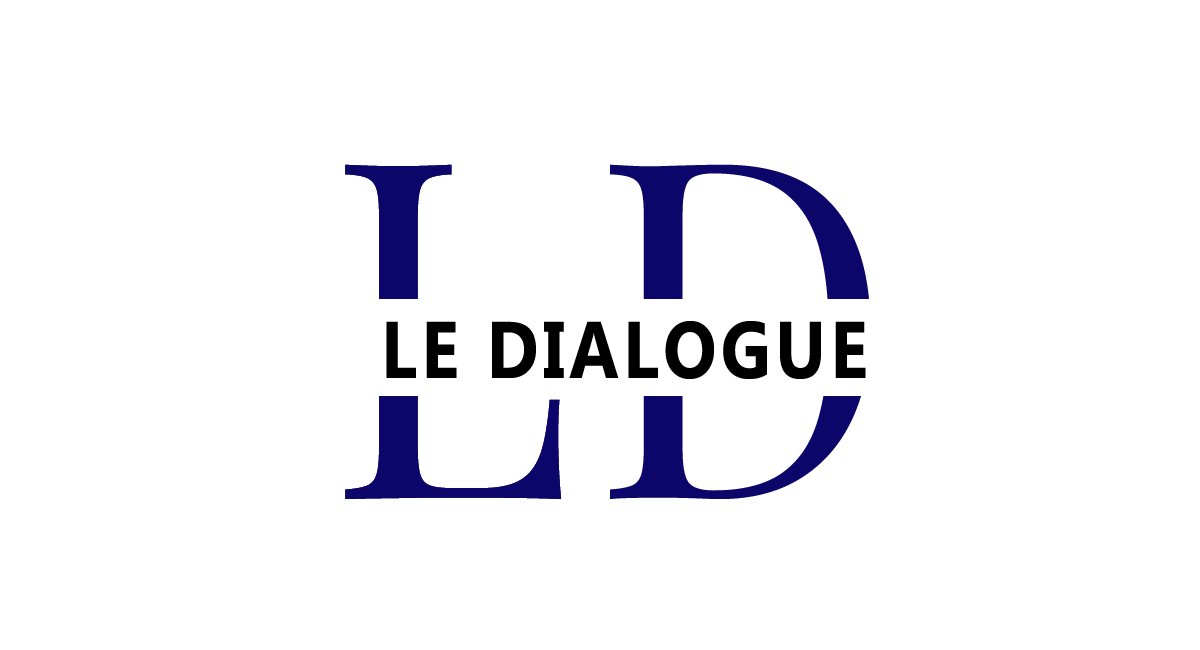 بالعربي
بالعربي
