
يواجه العالم كله، وليس الدول النامية أو الفقيرة وحدها تحديات هائلة فى عملية صنع السياسات العامة الدبلوماسية والدفاعية والاقتصادية. هذه التحديات تبدو فريدة عما اعتاد عليه هذا الجيل من السياسيين؛ فمحور القوة فى العالم ينتقل من الغرب إلى الشرق، وهو ما يسبب اضطرابات جيوسياسية على مستوى العالم كله، بعد أن عاش العالم أكثر من مائة عام تحت نفوذ محور قوة يتركز فى الغرب. وها نحن نشهد بسبب ذلك تداعيات مؤلمة، منها حرب أوكرانيا وأزمات الغذاء والطاقة.
كما أن التحديات البيئية التى تواجه العالم حاليا، لم يشهدها هذا الجيل من السياسيين، بل إن كثيرا من المؤسسات التى تربى فيها كانت، حتى وقت قريب، تعتبر أن الحديث عن أزمات البيئة والمخاطر والتهديدات المتوقعة يتعمد المبالغة وإثارة فزع الناس بلا مبرر. الآن أصبحت غضبة البيئة تهدد الدول الضعيفة القدرات مثل بنجلاديش وباكستان والصومال، كما تهدد الدول الصناعية المتقدمة ومنها الولايات المتحدة نفسها. وإلى جانب ذلك تعرض العالم لكوارث صحية، أهمها جائحة كورونا وتداعياتها البشرية والاقتصادية والاجتماعية.
كذلك تعرض العالم لأزمات لم تتسبب فيها الاضطرابات الجيوسياسية ولا التهديدات البيئية، ولكن تسبب فيها صانعو السياسات أنفسهم، منها أزمات اقتصادية نشأت عن سوء تقدير للوضع العام، خصوصا على صعيد التضخم، الذى ربما كان من السهل مكافحته، عندما اعتقد مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى عام ٢٠٢١ أنه مجرد «تضخم عابر - transitory»، فتلكأت السلطات النقدية فى مكافحته، حتى إذا بدا للعالم كله غولا شرسا، وارتفع إلى أعلى مستوى فى الأربعين عاما الأخيرة، لم يكن أمام السلطات النقدية إلا أن تستخدم أقصى وأقسى الأدوات الممكنة من أجل محاصرته ووضعه تحت السيطرة.
وقد دفع العالم وما يزال يدفع ثمنا فادحا لخطأ تقدير خطر التضخم، خصوصا الدول النامية، التى ارتفعت فيها معدلات الفقر والمديونية. وما يزال الطريق شاقا، بعد أن رفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة الأمريكية يوم الأربعاء الماضى إلى أعلى مستوى منذ عام ٢٠٠٧.
مصر والتكلفة المضاعفة للتحديات
وتواجه مصر كغيرها من دول العالم هذه التحديات بكل ما تنطوى عليه المواجهة من تكلفة. لكنها بالإضافة إلى ذلك تواجه تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة على مستوى الإقليم، تصل إلى تهديد حدودها، وأمنها الاقتصادى والاجتماعى.
مصر إذن تدفع تكلفة ظروف خارجة عن إرادتها، عالميا وإقليميا، ويكفيها ذلك لكى تعمل بكل ما تستطيع من جهد لكى لا تدفع تكلفة إضافية بسبب أخطاء فى إدارة السياسة الاقتصادية على وجه التحديد، لأن الاقتصاد هو أساس القوة. ذلك أن فائض القوة الاقتصادية هو الذى يغذى القوة العسكرية، والدبلوماسية، والاستقرار الديناميكى للمجتمع.
ونستطيع أن نقول بلا مبالغة إن العجز الاقتصادى يولد ضغوطا شديدة عليها. ومن أجل التغلب على العجز تلجأ الدول إلى «الاستدانة فى الأجل القصير» لسد فجوة «الحاجة إلى القوة»، لكنها تعمل على بناء القدرات فى الأجل الطويل من أجل تحقيق القوة المستدامة. وقد شهدنا كيف أن الديون المحلية للدول الصناعية قفزت لتتجاوز قيمة الناتج المحلى الإجمالى فى بلدان مثل الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا.
وفى هذا السياق وجدت دول نامية منها الأرجنتين ومصر على سبيل المثال، أن طريق الاستدانة لتمويل الطلب المحلى لا مفر منه. لكنها بدلا من أن تستخدم التمويل المدين من أجل سد ثغرة فى الأجل القصير، استخدمته كوسيلة لتمويل طموحات الأجل الطويل، مما ترتب عليه صعوبات مضاعفة، تحتاج إلى حكمة بالغة، للعمل على تخفيف حدتها أولا، ثم التخلص منها ثانيا.
وطالما أن الدول النامية تعانى من الحاجة إلى التمويل، فإن الطريق إلى ذلك قد يكون بتفعيل القاعدة التى تقول أن «الحاجة أُم الاختراع» وهو الطريق المستدام لبناء القدرات، لكنه صعب وطويل. أو قد يكون بابتكار قاعدة يقول منطوقها: «الحاجة أُمّ الاقتراض"! وهى قاعدة تقود إلى طريق سهل وقصير فى بدايته، لكنه قد يكون كارثيا فى نهايته.
السياسة القائمة على المعرفة
ولا ينطوى التمييز بين المسارين على موقف أيديولوجى اجتماعى، بقدر ما ينطوى على موقف يثمن اعتبارات الكفاءة، والعمل على زيادة الإنتاجية، والانتقال من منطق «تحقيق الربح بالفهلوة» إلى منطق تحقيق التراكم والفائض الاقتصادى ب «العمل».
طريق «الفهلوة» قصير الأجل، عشوائى، يخضع للصدفة، وربما يحتاج أحيانا إلى التواطؤ. أما طريق «العمل»، فإنه يقوم على المعرفة والتخطيط والتكنولوجيا، وهى الأسلحة التى اتفق العالم على الحاجة إليها لتحقيق التقدم المستدام.
إننا نعرف أن المصريين على مدار العقود الزمنية الأخيرة يزيدون بمعدل ٢٪ سنويا، فماذا يعنى هذا بالنسبة للاقتصاد؟ إنه يعنى ببساطة أن الطلب الطبيعى بزيد بالنسبة نفسها على الأقل، للمحافظة على مستوى معيشة السكان على ما هو عليه بلا زيادة ولا نقصان.
أما إذا أردنا رفع مستوى المعيشة بنسبة ٢٪ سنويا، فإننا سنحتاج إلى تحقيق معدل نمو حقيقى غير مصطنع بنسبة ٤٪ سنويا فى المتوسط على الأقل، بشرط تحقيق العدالة فى التوزيع، والقضاء على التفاوت. وهذا شرط ضرورى لمنع تركيز الثروة فى أيدى قلة من جماعات أصحاب المصالح.
أما إذا أردنا، كدولة نامية، مجاراة الدول النامية الناهضة، ووضع أقدامنا على مسار المنافسة فى الأسواق العالمية؛ فإنه علينا تحقيق معدل نمو يصل إلى ٧٪ فى المتوسط سنويا على غرار دول مثل فيتنام وتايلاند وكمبوديا والهند.

وبدون ذلك يتدهور مستوى الرفاهية الاجتماعية، وتنعدم القدرة على المنافسة. وتزيد حدة هذا التدهور فى حال الفشل فى «توزيع الأحمال الاقتصادية» بصورة عادلة، وهو ما ينتج ظواهر سلبية عميقة التأثير، مثل الفقر والأمية واعتلال صحة الأفراد. هذه الظواهر تعرقل بناء مجتمع المعرفة.
وحيث إن المعرفة هى أحد الشروط الأولية لبناء القدرة على التحمل، فإن المجتمع يفقد القدرة على المقاومة، وتتآكل الروح المجتمعية تدريجيا، لتصبح «النكتة» سلاحا للهروب من الشعور بعدم القدرة على المقاومة. ومع استمرار هذا النمط من السلوك، تتغلب روح الاستهتار على روح العمل.
فى مثل هذه الحالة يعيش الأفراد بشكل عام حياتهم، بمنطق التفكير القاصر، السريع، القصير الأجل، وهو المنطق الذى قام بتشريحه عالم السلوك البشرى دانيال كانمان، فى كتابه العظيم «التفكير المتعجل والمتمهل - Thinking Fast and Slow.
كانمان فاز بجائزة نوبل فى الاقتصاد عام ٢٠٠٢، عن أعماله فى تطوير نظرية سلوك المستهلك، التى أدت إلى تغيير دالة الطلب، بإضافة «توقعات المستهلكين» لتكون واحدا من مكوناتها. التفكير المتعجل يعكس فى جوهره العوامل الغريزية الفطرية، التى تقوم عليها ردود الأفعال بلا تفكير عميق.
وهو ما يفضى إلى منطق «الحاجة أم الاقتراض». أما التفكير المتمهل الذى يقوم على البحث والتمحيص وترجيح وجهات النظر والأفعال؛ فهو ما يفضى كما إلى قاعدة «الحاجة أم الاختراع» أى بناء القدرات وتعزيز جانب العرض.
بناء القدرة على التحمل
ونظرا لأن العالم يمر بمرحلة اضطراب تاريخى، فى سياق منافسة ضارية على القيادة، والانتقال من نظام أحادى القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب، فإن الحاجة تتزيد إلى بناء القدرة على تحمل التكلفة الناشئة عن اضطراب وتقلبات العوامل الخارجية غير الخاضعة لإرادتنا، باعتبارها حقائق معطاة، لم نصنعها نحن، ومن ثم لا نملك القدرة على تغييرها.
كذلك فإن بناء القدرة على تحمل الصدمات هو الطريق الصحيح لمواجهة تكلفة الأزمات البيئية القاسية التى يتعرض لها العالم كله. إن كثيرا من السياسيين وجماعات أصحاب المصالح الضيقة، ظلوا ينكرون لعقود طويلة أفكار ونظريات المخاطر البيئية التى يتعرض لها العالم.
ومع أن هذه المخاطر ظلت تتعاظم بمقدار أكبر وأشد حدة، فإن الإنكار كان يتعاظم أيضا. وها نحن نرى الآن، مع كل الشعوب التى تشترك فى ملكية كوكب الأرض الذى نعيش عليه، كيف أن غضب الطبيعة يفتك بالحياة، من خلال الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف والتصحر، التى أصبحت ظواهر متكررة، وتقع فى دورات متقاربة زمنيا عاما بعد عام.
ولن يستطيع الآن شعب بمفرده منع حدوث هذه الظواهر، ولذلك تعلو أصوات فى العالم من أجل التعاون لخفض الانبعاثات الكربونية السامة، والحد من التصحر، وسلوك طريق التنمية الخضراء، التى تهدف إلى استعادة التوازن البيئى بين إنتاج الاوكسبجين وإنتاج ثانى أكسيد الكربون.
لكن هذا التعاون يخضع لقيود كثيرة، ما تزال تحد من فاعليته. لهذا السبب فإن الحاجة تتعاظم لبناء القدرة على تحمل التقلبات المناخية الحادة، من خلال سياسات داخل كل دولة مفردها، للحد من الخسائر الناتجة عن تلك التقلبات البيئية. ويعتبر بناء القدرة على التحمل مسؤولية قومية لكل دولة، داخل حدودها، لحماية شعبها ومقدرات حياتها.
ويعتمد بناء وتعزيز القدرة على التحمل الاقتصادى والاجتماعى على عوامل ومقومات مستدامة بالضرورة، ولا ينفع معها منطق «الفهلوة» ولا فلسفة «الحاجة أم الاقتراض» بل إنه يجب أن يقوم بالضرورة على فلسفة ومسار «الحاجة أم الاختراع».
بناء القدرة على التحمل ليس مسؤولية صندوق النقد الدولى، وليس عن طريق الاقتراض من خلال الآلية الجديدة التى أنشاها الصندوق «Resilience Fund» بغرض مساعدة الدول على تضميد جروح التقلبات الجيوسياسية والبيئية التى تتعرض لها. منطق صندوق النقد الدولى هنا ينحصر دوره فى تقديم الحلول العاجلة للمشاكل الطارئة، فهو مثل منطق إتاحة «حقيبة الإسعافات الأولية» الضرورية لتضميد الجروح والحد من النزيف. إنه منطق تخفيف الأعراض.
ولا يتحقق العلاج الصحيح طويل الأجل إلا من خلال إرادة محلية لبناء وتعزيز القدرة على التحمل، مهما كانت المساعدات التى تحصل عليها أى دولة من الخارج، سواء لاعتبارات جيوسياسية أو لاعتبارات «أخوية» دينية أو قومية. بدون هذه الإرادة، التى ينطلق منها منطق ومسار أن «الحاجة» هى «أم الابتكار"؛ فإن أى مساعدة قصيرة الأجل من الخارج لتضميد الجروح أو علاج الأعراض، تتحول إلى مصيدة تاريخية لتهشيم الارادة القومية، والمحافظة على استمرار المرض، مع إبقاء المريض على قيد الحياة، سواء عن قصد أو بحسن نية.
المصيدة الجيوسياسية
وقعت مصر فى تاريخها ضحية لما يمكن ان نسميه «المصيدة الجيوستراتيجية». مصر تتوسط قارات العالم القديم الثلاث، مصنع الحضارة البشرية وأصلها، وتطل عليها برا أو بحرا. وهى واحة خضراء وسط الرمال، يحميها البحر والصحراء.
وقد تعرضت فى فترات ضعفها للاحتلال باختراق أعدائها أيا منهما. وطالت فترات الاحتلال لضعف القدرة على المقاومة. وكان هذا الضعف نتيجة لاعتصار فائضها الاقتصادى عاما بعد عام، حيث اكتفت أغلبية الفلاحين المصريين، حتى ستينيات القرن الماضى، بالعمل فى طين الحقول، والعيش فى بيوت من الطين، ودفنوا فى قبور من الطين بعد الممات.
وعلى العكس منهم عاش الغزاة المحتلون، والعبيد المحاربون، الذين حولوا الفائض إلى بلدانهم الأصلية، أو تمتعوا به فى بناء آثار تدل على استبدادهم. ونظرا لموقع مصر وثرواتها فى عصور الحضارات المختلفة، فإنها كانت الجائزة الكبرى، التى فازت بها القوة المنتصرة فى العالم.
حكمها الفرس، والإغريق، والرومان، والعرب، والمماليك (وهم عبيد محاربون من كل الأجناس، زاد نفوذهم فى أواخر حكم الدولة الأيوبية ثم سيطروا هم على الحكم)، وبعدهم جاء العثمانيون، والفرنسيون، والإنجليز. وأصبحت مصر بعد الاستقلال مطمعا للقوى المتصارعة على النفوذ فى العالم.
ووجد حكامها فى سباق تلك القوى للفوز بها فرصة للعب مع طرف ضد الطرف الثانى، وضرب هذا بذاك، للحصول على مكاسب عزيزة. لكنها ما تزال تدرك ضرورة العمل على تحقيق توازن دقيق، يجنبها الوقوع فى «المصيدة الجيوسياسية»، وألا تضعف، حتى لا تقع فريسة لقوة أجنبية من جديد.




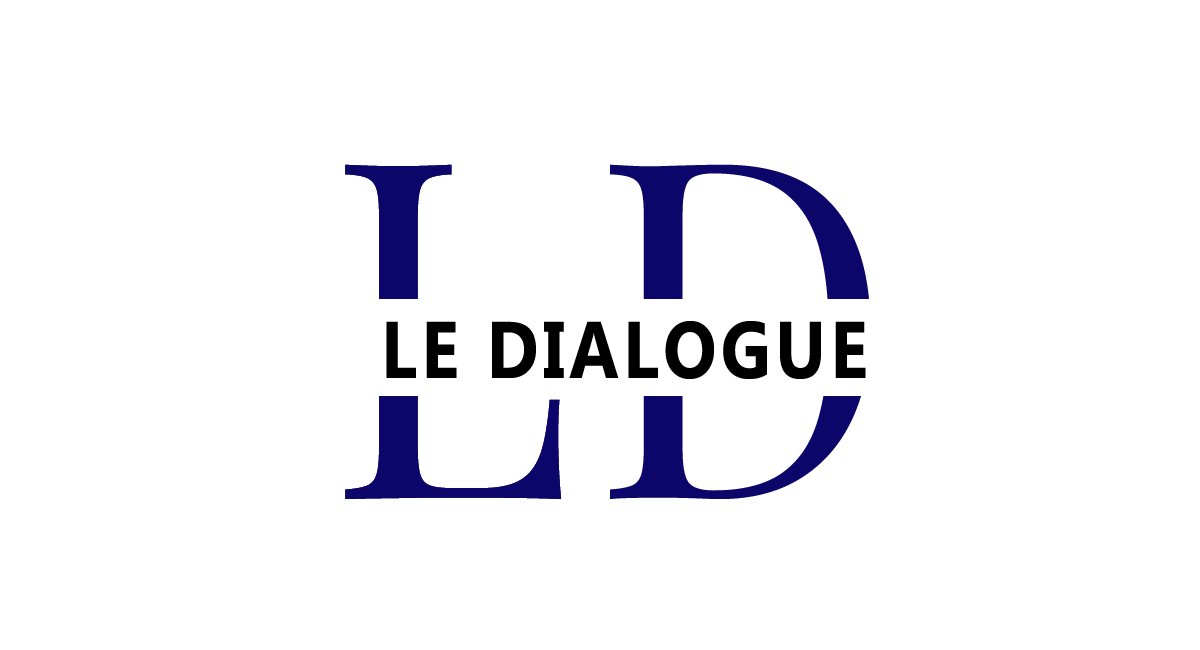 بالعربي
بالعربي
