
ينتشر العنف فى ضواحى فرنسا بشكل منتظم واكتسب أشكال جديدة من الوحشية (١٢٠ هجومًا يوميًا بالسكاكين). كثيرًا ما يرتبط هذا العنف بالأجيال الشابة من المهاجرين من المغرب وأفريقيا ويعكس الشعور بالضيق الشديد لدى هؤلاء الشباب الذى يفتقر إلى الاندماج وانتشروا فى المدن وأٌقاموا العديد من المناطق «الخارجة عن القانون» (١٥٠ إلى ٢٠٠) وتحصنوا بأسلحة فهم يهربون من قوانين الجمهورية كما أنهم يتاجرون فى المخدرات والأسلحة ولا تخاطر الشرطة بنفسها بدخول هذه المناطق المنحرفة.
النسخة الرسمية
نقرأ، على سبيل المثال: «وراء حالة التمرد الظاهرة لهؤلاء الشباب فى هذه المجتمعات يكمن حالة مزمنة ومتجذرة بعمق فى السكان ذوى الخلفية المهاجرة وعدم وجود حلول لمشاكل المدينة.. بطالة، وتمييز إجتماعى وأزمات شخصية وعدم اندماج فى نموذج فرنسى وعلمانى وجمهورى.
هذه النسخة الرسمية تحمل الدولة الفرنسية المسئولية بسبب سياستها الفاشلة والتى كلفتها ملايين اليورو ولكنها لم تستطع علاج الظاهرة؛ لنستبدل الموضوع بجغرافيته وتاريخه؛ بغض النظر عن الوضع الطبقى لقاطنى هذه الأحياء فيجب أن توفر الضواحى بالفعل مساحة وهدوءًا أكبر من المدن المزدحمة وقارن جان دى لافونتين فيما مضى بين هدوء فأر الريف وبين جرذ المدينة المضطرب ودعونا نتذكر أن مناطق Neuilly وSaint- Cloud وVille d'AvrayوGarches...وهى ضواحى باريس غاية فى الهدوء والراحة». بينما نجد المدن كما فى مرسيليا يتم تصفية الحسابات «بالرصاص» وهى مصدر للقلق وقد علمنا مؤخرًا أن الأماكن التى كانت حتى وقت قريب من بين المناطق الأكثر هدوءًا فى فرنسا مثل نانت ورين اصبحت متأثرة بهذا العنف لدرجة أن سكانها التقليديين يضطرون إلى الفرار منها.
تاريخ صغير
فى الأصل كانت الضواحى مخصصة للفرنسيين الذين طردوا من وطنهم الأصلى ولقد تمت إقامة هذه الأحياء فى ضواحى المدن لإيواء الفرنسيين غير المرغوب فيهم فى المستعمرات القديمة وفى الستينيات تسببت بلاد المغرب الثلاثة المستقلة حاليا فى هجرة جماعية لغير المسلمين الذين طردوا من بلدهم الأصلى ولم تعد تونس والجزائر والمغرب تقبل وجود الرعايا الفرنسيين على أراضيها ولا اليهود حتى لو كانوا يحملون الجنسية التونسية أو المغربية.
كما شمل النزوح الإيطاليين والمالطيين والإسبان، ناهيك عن المسلمين الجزائريين الذين اختاروا المعسكر الفرنسى ومن الواضح تمامًا أن فرنسا لم تستطع استيعاب هذه التدفقات الهائلة وبالتالى أنشأت هذا النوع من المدن.
لقد كنت على دراية جيدة بهذه الفترة عندما أعاد أولئك الذين يطلق عليهم «ذوى الأصول الجزائرية»: إعادة تكوين المجتمعات حيث ساد جوجنوبى دافئ وعلى الرغم من الهندسة المعمارية غير المتطورة إلا أن هذه المساكن توفر لهؤلاء الوافدين الجدد ولإيجارات معتدلة، راحة لم يعرفوها من قبل: غرفة المعيشة، وغرف النوم، والمطبخ، والحمامات، إلخ.
لكن بعد سنوات قليلة من الاستقلال، أصيب السكان الجزائريون على وجه الخصوص بخيبة أمل حيث دفعت الكراهية الانتقامية لفرنسا قادتها الجدد إلى الاقتراب من الروس السوفيت وحتى الصينيين؛ مما أثار استياء عدد من مواطنيها، الذين ما زالوا متعلقين بالثقافة الفرنسية.. حتى أن بعض المرضى الجزائريين قاموا برحلة إلى فرنسا لاستشارتى سنويًا وكانوا سعداء بالذهاب إلى طبيب يتحدث الفرنسية.
يجب أن يقال أيضًا أن النموذج الفرنسى لا يزال يحتفظ بمكانته وحدثت موجة ثانية من الهجرة: كان سكان شمال إفريقيا الأصليون هم الذين قرروا نفى أنفسهم من بلدهم المستقل الآن واتجهوا إلى مستعمريهم السابقين بعد الروس والصينيين واتخذ هؤلاء أيضًا هذا القرار بعد صعود الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الحزب الإسلامى الجزائرى الراديكالى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ") واغتيالاتها اليومية، لتأتى موجة جديدة من الهجرة الجزائرية تستقر فى الضواحي؛ ثم أصبح العائدون السابقون أقلية.
الجيل الثاني
على عكس والديهم، يتحدى الشباب من هذا الجيل الثانى حياتنا اليومية بانتظام بأعمال الشغب والنهب، وخاصة المبانى العامة، على خلفية العنف والتمرد. دعونا نحاول أن نفهم:
السياسة التى انتهجها جيسكار وكارتر وبعد ذلك مقولة ميتران الشهيرة «أهم شيء أن أحمى ظهرى» ومع حدوث الثورة الإسلامية فى إيران، التى حدثت بسبب الإقالة الأمريكية لشاه إيران من ناحية.
ومن ناحية أخرى، تم تسليم حق اللجوء الفرنسى الخيرى لأولئك الذين كانوا سيصبحون أعيان هذا البلد المتعطشين للدماء وكانت الشريعة العنيدة لآيات الله الشيعة الإيرانيين، والإسلام السياسى يظهران بقوة فى المشهد الروحى الغربى، الذى كان بالفعل فى حالة انحدار كامل ودعا الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان إلى «لم شمل الأسرة». وأصبحت هذه الهجرات المؤقتة هجرة توطين وبعد ذلك نشهد السكان المغاربيين، من الجيل الثانى، الذين أعيدت تنشأتهم فى هويتهم، وزاد عددهم بشكل كبير.
«لا تلمس صديقى!».. نقطة تحول حاسمة
فى أوائل الثمانينيات، كان الجيل الثانى من الهجرة المغاربية وأطلق جاك لانج، وزير ثقافة فى عصر ميتران، كتابه الشهير"لا تلمس ظهرى» وعم فى خطاباته بشكل غير متوقع هذه الفئة وكانت المطالب تدور حول الهوية أكثر بكثير من كونها دينية. وهكذا التقينا أكثر فأكثر، بما فى ذلك فى العمل، حيث كنا نرى فى السابق فتيات جميلات يرتدين التنورات القصيرة أصبحن يرتدين النقاب أوغيرها من الحجاب الإسلامى وفى رأيى، لم يكن هذا على الأقل، فى البداية، مرتبطًا بالبعد الدينى والروحى للمصطلح، بل بالأحرى يعتبر تحدى لعدد من السياسات.
وفى الحقيقة، الأجيال الشابة - التى تطورت فى بيئة فرنسية غير موجودة ضمن أوروبا المنكوبة روحيًا، والتى رفضت جذورها اليهودية-المسيحية واليونانية-الرومانية - لم يكن لديها سبب «للركض وراء» ثقافة شاذة بل تحاول هذه الأجيال إثبات نفسها فى النموذج الإسلامى التقليدى.
كما أن مسلسل إحراق الكنائس والاعتداءات على أقسام الشرطة يكشف فى الحقيقة مجلدات عن الرفض الثقافى والسياسى لهؤلاء الشباب الفرنسى «من الأرض». وفى حين أن المتسامح تٌرك للتطرف، ولكن العلمانى من حيث المبدأ، أبدى ارتياحًا مفاجئًا لهذا التطرف الإسلامى مع الاستمرار فى «تحطيم أسطورة الكاهن» ! وبعد أن أصبحوا أغلبية عددية فى الضواحى، واكتسبوا أكثر فأكثر أفكار الإسلام الفاتح، فإن هؤلاء الشباب المسلمين المتأثرين بعقيدة الإخوان المسلمين والسلفيين الراديكاليين قد أعادوا الاتصال بعلم الاجتماع الذى كان دائمًا هوالخصوصية.

ومن تاريخ الحركات الإسلامية الراديكالية، من العثمانيين فى الماضى إلى جماعة الإخوان المسلمين منذ السبعينيات، يدعى هؤلاء أتباع هذا الإسلام السياسى الموروث فى هذه المنطقة ويتصرفون هناك بصفتهم سادة غير متسامحين تجاه المجتمعات الأخرى التى ليس لديها خيار سوى «الذهاب إلى المنفى» لإفساح المجال لهم ويسود هناك «نظام» جديد، نظام الرؤساء. لقد رأينا هذا على مر القرون، ومؤخرًا فى كوسوفو، حيث أدى التفكير الانتحارى الجيد لغربنا، والذى اجتمع لشن حرب وحشية وبربرية لا ترحم على الصرب، إلى مطالب المتمردين، وإنشاء إقليم إسلامى مستقل مثل ألبانيا المجاورة وبالعودة إلى ضواحينا، فإن فاعلى الخير لدينا، يلعبون دورهم المفضل مرة أخرى كأغبياء يساعدون على زيادة هذا الوضع ويواصلون إيجاد الأعذار لهؤلاء الشباب المنحرفين. هؤلاء يشجبون القمع الشرعى للشرطة باعتباره عنصريًا ومعادًا للإسلام، ولا يترددون فى التأكيد على أن أعمال الشغب العنيفة هذه بالدمار، ولا يترددون فى المشاركة فى «خطاب الضحية» فى المظاهرات التى يكون فيها العلم الفلسطينى جزءًا من الديكور بشكل شبه منتظم.
تعدد الثقافات
أما بالنسبة لقادتنا الحاليين، فلا شك من منطلق رغبتهم فى استرضائهم، فهم يرفضون تسمية الأشياء ويبدو أنهم يتأثرون، ليس بالعمى تجاه العنف الذى لا يمكنهم إنكاره، ولكن بسبب عمى الألوان المؤكد الذى أدى إلى أن نرى، خلال الحوادث الخطيرة للغاية فى استاد فرنسا، على سبيل المثال، أن المشاغبين هم مواطنون إنجليز، فى حين أن الشهود ومقاطع الفيديوالخاصة بالمراقبة لم يعثروا إلا على أشخاص ملامحهم تدل على أنهم من شمال أفريقيا وليس إنجلترا!
وبنفس الطريقة، فإن وزير داخليتنا، خلال أعمال الشغب والنهب العنيف التى أعقبت وفاة الشاب نائل، أشار بفضول إلى أقصى اليمين، ويبدو أنه رأى فقط «كيفن وماتيو» على الرغم من الأسماء الأولية لـ«الجناة المسجلين رسميا» تحمل اسم أسماء عربية بشكل رئيسى.
أما رئيسنا الشاب، فيصرّ، بعمى أيديولوجى غير مفهوم، على الدعوة إلى التعددية الثقافية.. وفى الحقيقة، عدم إدراك أن هذا الموقف مميت لأنه لا يؤكد بوضوح التفوق الطبيعى لجذورنا الدينية سواء كانت مسيحية أو غيرها. القضية هنا ليست فى الواقع «التعددية» ولكن «التعددية الثقافية». بوضوح: إسلام قاهر فى مواجهة غرب فاتر عفى عليه الزمن.. وهذه اللعبة خاسرة مقدما!
بلدنا يدعم، بل «يرعى» الغزو من قبل السكان، والذى، طبقا للاحصائيات، سوف يولد مزيدًا من الاضطرابات. وهذا يعد عنصرا فريدا فى تاريخ الشعوب! يستفيد المهاجرون من الخدمات الطبية والاجتماعية والإسكانية ونعلم أيضًا أنه من خلال المساعدة الضارة من بعض المنظمات غير الحكومية التى تستخدم اللوائح المثيرة للجدل والمشوهة يتحول هذا الغزو إلى مؤسسة دائمة ويستفيد من هذا السخاء العديد من المنحرفين والمجرمين المثبتين.
الآن أصبح النموذج معروفًا بشكل واضح: التأكيد من خلال العنف والخضوع للأقوى، مع إجبار النساء على ارتداء النقاب أوالبوركينى، تحت هيمنة الأقوياء ماليًا والمسلحين بشكل مفرط، وقادة العصابات وشبكات المخدرات.
وخلال أعمال الشغب الأخيرة التى أعقبت وفاة الشاب نائل، ساهمت الشرطة مع اجتهاد القضاء على استعادة الهدوء بعد الحرب شبه الأهلية التى عشناها، فلا يجب أن نقلل من دور قادة الشبكات والعصابات الذين أرادوا ذلك من أجل استئناف تجارة المخدرات المربحة للغاية؛ ولكن «اللعبة انتهت!»
لكننا نعلم فى الأماكن المرتفعة أن كل شيء يمكن أن يبدأ من جديد، وأن هؤلاء البارونات الأقوياء من مختلف الأراضى المفقودة فى الجمهورية لديهم القدرة على إحداث مشاكل يمكن أن تهدد بشدة الوحدة الوطنية.
إلى جانب ذلك، ستبدو أعمال الشغب الأخيرة والعنيفة للغاية على أنها نزهة صحية بسيطة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. ويمكن للبعض أن يتخيل بدء تمرد فى مرسيليا، بدعم لوجستى من الجزائر المجاورة! لاحظ أن هؤلاء، خلال أعمال الشغب الأخيرة، طالبوا باستدعاء فرنسا للمساءلة عن إدارتها للشرطة.
ومع ذلك، فى يوم من الأيام، يجب معالجة مسألة «سيف ديموقليس» هذا الذى يمكن أن يضرب فى أى وقت بشكل واضح وتحدث المواجهة المسلحة؛ الانفصال؟ وهذا بالفعل موضوع خطير جدا. دعونا نحتفظ به تحت البساط فى الوقت الحالى.
معلومات عن الكاتب:
آلان بليش.. طبيب معروف فى الغرب بكتاباته التحليلية ذات النظرة الفلسفية العميقة للأشياء.. يحلل، بنظرته الفلسفية، ما آل إليه المجتمع الفرنسى «متعدد الثقافات» على حد قوله.




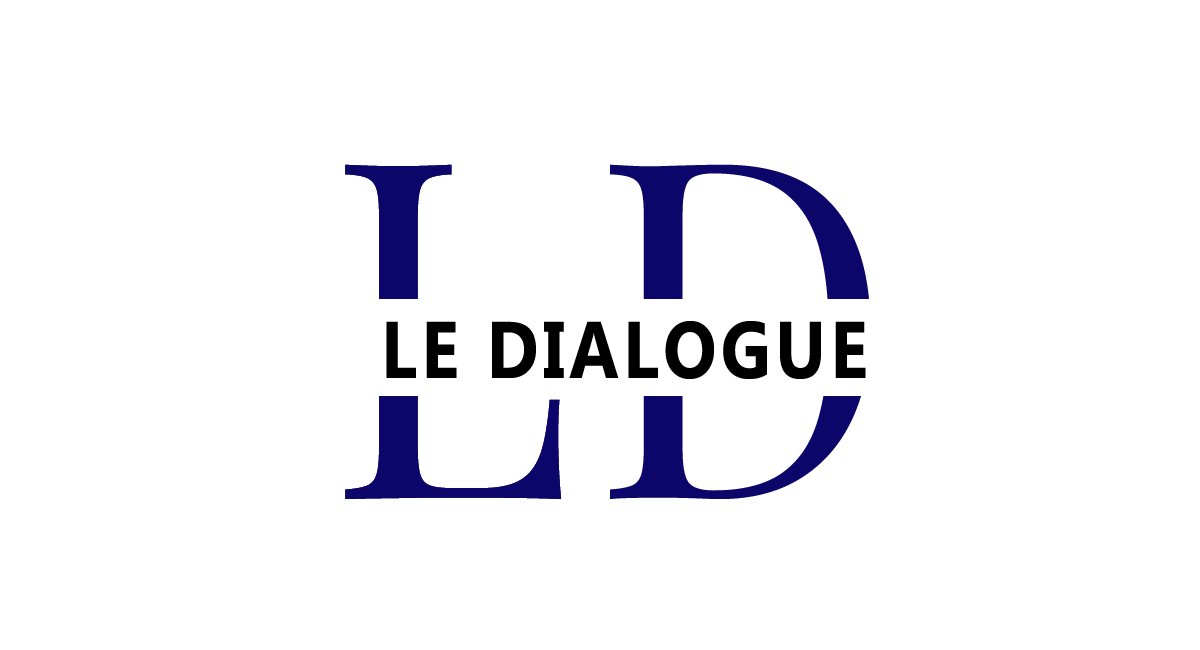 بالعربي
بالعربي
