
يُعد المسجد الجامع في الحضارة الإسلامية علامة فارقة، فهو المبنى الذي تتمحور حوله عاصمة الدولة، حيث جرت العادة أن يبدأ البناء بالجامع أولًا ثم يعقبه بناء مقر الحكم ومقر إقامة الحاكم، وفي المسجد الجامع تُدار أمور التعليم والقضاء، ومنه تخرج الجيوش وإليه تعود، وظل بناء المساجد الجامعة عادة في بناء المدن الجديدة حتى يومنا هذا.
ويُعد جامع عمرو بن العاص في منطقة مصر القديمة، هو أول مسجدًا جامعًا في مصر وإفريقيا، وبالطبع هناك مسجدًا يسبقه وهو مسجد سادات قريش في بلبيس حسبما أوردت بعض المصادر التاريخية، ولكنه مسجدًا وليس جامعًا، حيث يجب أن نشرع في الحديث عن جوامع مصر عبر العصور أن نفرق بين ثلاث منشآت، الأولى الزاوية، والثانية المسجد، ثم الجامع.
والزاوية وجمعها زوايا، وهي المكان الذي من الممكن أن يخصص للصلوات الخمس فقط ومن الممكن البناء فوقه ومن الممكن أن يباع أو يُشترى، أما المسجد فهو لا يُباع ولا يُشترى، ولا يبنى فوقه، ويخصص للصلوات الخمس فقط ولا تقام فيه لا صلاة الجمعة ولا العيدين، أما الجامع فلا يًباع ولا يُشترى ولا يُبنى فوقه، وفيه تقام الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والعيدين، وفيه يتم التدريس، وتتم فيه شئون التقاضي، ومختلف ما يتعلق بحياة المسلمين.
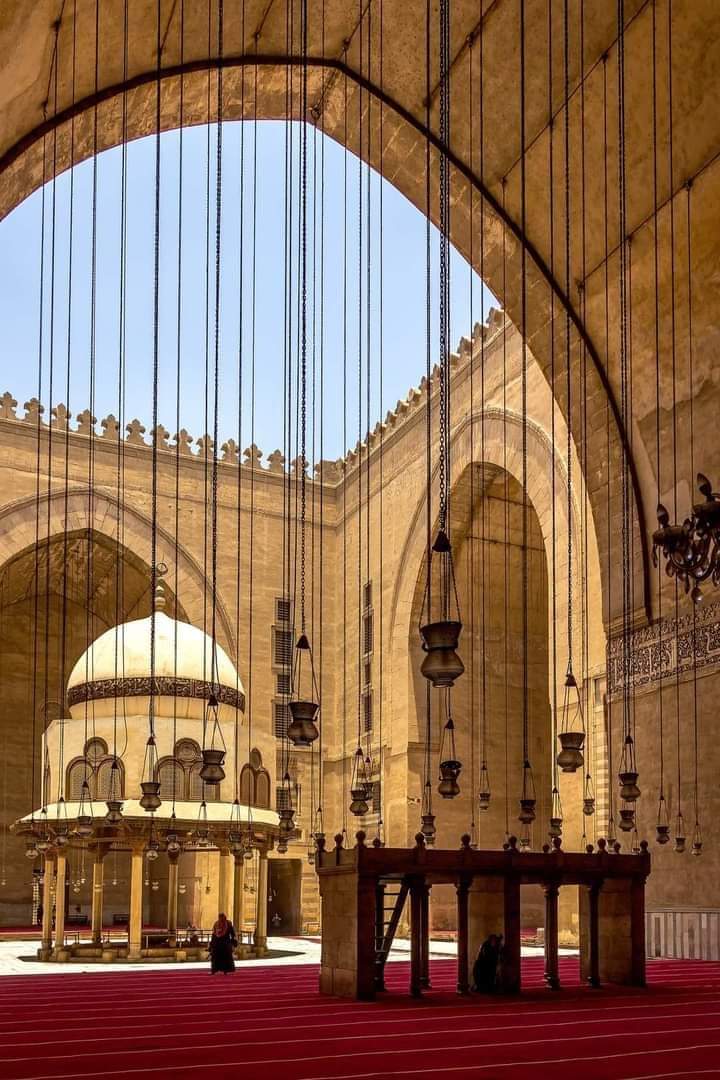
جامع عمرو بن العاص
هو أول جامع بُني في مصر، والذي قرر عمرو بن العاص أن ينشئه مع إنشاء مدينة الفسطاط عام 21هـ، وكان يسمى بجامع أهل الراية، وسُمي أيضًا بالجامع العتيق، وبتاج الجوامع، وبداية جامع عمرو كانت بسيطة للغاية، فلم يكن له صحنًا ولا مئذنة، حسبما ورد في كتاب الدكتور أحمد عبد الرازق العمارة الإسلامية، وكانت مساحته 50 × 30 ذراعًا، أي ما يوازي 29 × 17 مترًا تقريبًا.
وكان له أربعة أبواب، بابان منهما في جهة دار عمرو بن العاص، ولم يكن له محراب مجوف، واشترك 80 صاحبيًا في تحديد جهة قبلته، وصنع بقطر النجار من أهل دندره لعمرو منبرًا كي يخطب عليه، ولكن الخليفة عمر بن الخطاب بعث له أن يكسره، وقال له أما يكفيك أن تخطب والمسلمون جلوس تحت عقبيك، فكسره وقيل إنه أعاد بناؤه بعد وفاة عمرًا رضي الله عنهما.
وكان أول من زاد ووسع في جامع عمرو هو مسلمة بن مخلد الأنصاري والي معاوية على مصر وكان ذلك في عام 53هـ /673م، فجعل له زيادة من ناحية دار عمرو، وقام بدهان حوائطه، وزخرف جدرانه، وسقفه، وفرشه بالحصر بعد أن كان مفرشًا بالحصباء، وجعل له 4 صوامع عند أركانه، وجعل له رحبة من الناحية الغربية كان الناس يصيفون بها.
ثم جاء والي مصر عبد العزيز بن مروان، 79هـ /698م، فهدم جدرانه ووسعه ناحية الجنوب وأدخل فيه الرحبة التي كانت ناحية الغرب، ثم أمر عبد الله بن مروان والي مصر من قبل أخيه الوليد، برفع سقفه وكان مطأطأً، وذلك عام عام 89 هـ /707م
ثم أمر قرة بن شريك العبسي بهدم الجامع تمامًا وإعادة بنائه من جديد، استجابة لأمر الخليفة عبد الملك بن مروان، عام 93هـ /712م، حيث زاد فيه من ناحية الشمال وأدخل في الجامع دار عمرو ودار ابنه عبد الله بن عمرو، وجعل له منبرًا جديدًا في العام التالي بدلًا من منبر عبد الله بن أبي السرح، وجعل له محرابًا مجوفًا، وذهب تيجان أعمدته الأربعة. وفتح فيه 11 بابًا، وأضاف له مقصورة كمقصورة معاوية في دمشق.
جرت عدة زيادات أخرى على الجامع أبرزها في عهد اسامة بن زيد التنوخي متولي خراج مصر بخلافة سليمان بن عبد الملك عام 79هـ ،715م، جعل فيه بيت مال المسلمين، ثم في عام 133 هـ / 750م، أدخل فيه الصالح بن علي دار الزبير بن العوام، وفي عام 175هـ /719م، أضاف له موسى بن عيسى الهاشمي والي مصر من قبل هارون الرشيد الرحبة التي كانت تقع في الجهة الغربية المعروفة برحبة أبي أيوب.
في عام 212 هـ، أضاف له عبد الله بن طاهر زيادة جديدة، من ناحية الجنوب تعادل كامل مساحته، والتي أصبحت مساحته الحالية، 120.5 × 112.5 م.
في العصر الطولوني جدد الجامع خمارويه بن أحمد بن طولون، وأنفق عليه 6000 دينارً، وفي العصر الفاطمي، نصب يعقوب بن كلس فواره تحت قبة بيت المال عام 378هـ 988م، وأهداه الحاكم بأمر الله تنور «نجفة» من الفضة بوزن 100000 درهم فضة وخلعوا أحد الأبواب لكي يستطيعوا إدخال التنور، وردوا الباب إلى مكانه.
بعد الحريق الذي أشعله الوزير شاور في الفسطاط تصدعت جدران الجامع وأمر صلاح الدين الأيوبي بإعادة ترميمه، في عام 568هـ /1172م، وجدد بياضه وأصلح رخامه وأعمدته.
وجرت العديد من الإصلاحات على الجامع في عصر المماليك، منها ما قام به السلطان المعز عز الدين أيبك، والظاهر بيبرس من إبطال جريان ماء الفواره، وأعاد جريانه المنصور قلاوون عام 687هـ، /1288م، من البئر الواقعة بزقاق الأقفال، وعمر الجامع الأمير سلار عقب زلزال 702هـ ،/ 1303م، وهي العمارة التي بقى منها إلى الآن الشبابيك الجصية «الجبسية»، الموجودة بالجهة الغربية والمحراب الجصي الخارجي الذي تم عمله برسم المالكية، وكان يشتمل على شريط من الكتابات العربية بخط النسخ المملوكي، وتهشم هذا المحراب في إحدى عمليات ترميمات الجامع السابقة، وأعيد تصميم واحدًا على نمطه.
في عام 713هـ، 1313م، وصف المؤرخون جامع عمرو بن العاص فقالوا عنه أنه ضم 378 عمودًا، و 13 بابًا، وفي جدار القبلة 3 محاريب، وكان له 5 مآذن وفي عام 1212هـ /1719م، قام مراد بك بتجديد على الجامع فهدم رواق القبلة وأعاد بناءه وغير اتجاه عقوده، مما تطلب سد معظم شبابيك هذا الجزء مما حرمه من الضوء، وبنى المئذنتان الباقيتان فيه حتى الآن، وأثبت تاريخ العمارة في نصوص تأسيسية فوق الأبواب الغربية والمحرابين الكبير والصغير برواق القبلة.
وضمن أدوار جامع عمرو بن العاص كان الدور العلمي، حيث ينقل المؤرخين أن الجامع في منتصف القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي بلغت عدد حلقات العلم فيه 110 حلقة علمية، خُصص بعضها للسيدات، والتي تصدرتها في عام 1415هـ، 1024م، واعظة زمانها أم الخير الحجازية، وكا يُعقد فيه مجالس القضاء ومجالس القصص «التاريخ»، الأمر الذي جعله أقدم جامعة علمية في مصر حيث سبق الأزهر في هذا المجال بنحو 600 عام كاملة.

جامع العسكر
ظلت مدينة الفسطاط هي عاصمة مصر طوال حكم الخليفة عمر بن الخطاب ومن تلاه من خلفاء، وكذلك طوال حكم الدولة الأموية، حتى دخل العباسيون إلى مصر بجيوشهم تحت قيادة صالح بن علي مطاردين آخر خليفة أموي وهو مروان بن محمد، واستقر ابن علي هو وجيشه في منطقة شمال شرقي الفسطاط كان يُقال لها حمراء القصوى، وهي المكان الذي كان يسكنه الروم القادمين مع عمرو بن العاص ثم تحولت إلى صحراء جرداء.
وبعد أن نجحت جيوش العباسيين في القبض على مروان بن محمد وقتله في أبو صير، وصارت الخلافة خالصة لبني العباس أمر صالح بن علي ببناء مدينة جديدة في هذا المكان، وصارت عاصمة ثانية وأطلق عليها العسكر، وحاليًا يوجد مكانها سور مجرى العيون ومستشفى 57357 وكانت تمتد حتى شارع مراسينا في السيدة زينب.
كان بناء العسكر في عام 132هـ، والسبب في بناءها قد يرجع للتخريب الذي أوقعه مروان بن محمد في الفسطاط قبل أن يهرب، أو لأن العباسيون كرهوا أن يحكموا من مقر حكم الأمويون الفسطاط، ولكن في الأغلب أن المدينة تم بناؤها كي تكون مقر إقامة لجند العباسيين، حيث كانت الفسطاط آهلة بمن سكنها.
في عام 169هـ/ 785م، شيد الفضل بن صالح بن علي جامعًا لمدينة العسكر، ليصير ثاني جوامع مصر، والذي ظل باقيًا حتى عام 517هـ، 1123م، ولكنه اندثر ولم يبق منه شيئًا، وأصبح حتى موقعه مجهولًا، ومن لحظة تأسيس جامع العسكر نستطيع أن نقول أن مدينة العسكر صارت مستقلة عن الفسطاط، فكما يقول المقدسي «لا مدينة إلا بمنبر» أي مسجد جامع.
وسمح السري بن الحكم والي مصر عام 200هـ/ 816م، لأهل مصر بالبناء في العسكر، فاتصلت المباني بينها وبين الفسطاط حتى صارتا مدينة واحدة، وظلت العسكر مقر حكم العباسيين حتى مجئ أحمد بن طولون والذي استقل بحكم مصر وأسس عاصمة جديدة، وبنى لها مسجدًا جامعًا ثالثًا.

جامع أحمد بن طولون
وصل حمد بن طولون إلى مصر، واستقر بدار الإمارة في مدينة العسكر، واستكثر من الرجال والأتباع والجند، حتى ضاقت به وبرجاله العسكر بعد عامين من إقامته فيها، وفي عام 256هـ/ 870م، بدأ في بناء عاصمته والتي أُطلق عليها القطائع وبنى مسجدًا جامعًا كما هي العادة في ابتداء بناء المدن، وبنى قصرًا منيفًا، وبنى قناطر وحصنًا وبيمارستانًا، والبيمارستان هو مكان علاج المرضى أي المستشفى.
في عام 263هـ /876م، شرع أحمد بن طولون في بناء مسجدًا لا زال باقيًا بأغلب عناصره المعمارية إلى اليوم، وقد حاكى أحمد بن طولون في مدينته القطائع، المدينة التي نشأ بها وهي مدينة سامراء في العراق، وكان ضمن ما تأثر بطرز مدينة سامراء، الجامع الطولون، وقد بناه فوق ربوة صخرية مرتفعة يقال لها جبل يشكر، لتكون أساسًا متينًا له وفي ذات الوقت يكون مرتفعًا عن فيضان النيل، إضافة إلى أن تلك الربوة تشرف على الميدان الذي أنشأه أمام قصره، وكذلك تقع على الحد الفاصل بين مدينته ومبين مدينة العسكر.
انتهى بناء جامع أحمد بن طولون عام 263هـ /876م، أي بعد مرور 3 سنوات من انطلاق إشارة البدء في البناء، والجامع ذو مساحة ضخمة للغاية، فهو من أكبر الجوامع الأثرية الباقية في مصر وأقدمها، حيث تبلغ مساحته بالزيادات المحيطة 6 فدادين ونصف، وعالج المعماري ارتفاع الجامع عن منسوب الطريق، حيث أن الزيادة التي حوله تعتبر في مستوى أقل من المربع الذي يكون صحن الجامع وأروقته، فهي مرحلة انتقالية بين مستوى سطح الأرض ومستوى الجامع من الداخل.
وينفرد جامع أحمد بن طولون بأنه بلا أعمدة تقريبًا، حيث يحمل أسقف الجامع دعامات، يصل عددها إلى 160 دعامة، والتخلي عن البناء بالأعمدة، ويرجع هذا إلى أن الجامع متأثر بعمارة سامراء، التي أسسها الخليفة العباسي المعتصم في شمالي بغداد عام 221هـ /836م، حيث يسبق جامع إبن طولون في البناء بالدعامات جامع سامراء وجامع أبي دلف، وهو ما يدحض القصة الوهمية التي روتها بعض المصادر من أن أحمد بن طولون كان يعتزم هدم الكنائس لأخذ أعمدتها كي يبني جامعه الذي يحتاج 200 عمود ولكن مهندسًا مصريًا مسيحيًا اقترح عليه البناء بالدعامات فأنقذ الكنائس من الهدم وهي قصة مختلقة، حيث تمتع عصر أحمد بن طولون بعدالة كبيرة في التعامل مع الإخوة المسحيين من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا طراز عراقي قادم إلى مصر من سامراء مع أحمد بن طولون سواء في طريقة البناء، أو في الزيادة المحيطة بالجامع أو في مادة البناء وهي الآجر، وذلك حسبما ورد في كتاب الدكتور أحمد عبد الرازق العمارة الإسلامية.
جامع أحمد بن طولون أحاطته رواية أخرى وهي أن إبن طولون طلب من المعماريين أن يبنوا له جامعًا ان احترقت مصر لم يحترق وإن غرقت لم يغرق، ويبدو أن المقولة من وضع المؤرخين كي يفسروا سبب استخدام الآجر «الطوب المحروق» في البناء، وتفسير ذلك بسيط حيث أن الجامع كما أسلفنا عراقي الطراز بما في ذلك مادة البناء، وكذلك كان الآجر شائع الاستخدام في مصر فقد استخدمه قرة بن شريك في تجديدات جامع عمرو بن العاص عام 93 هـ، وظل البناء بالآجر في مصر حتى استخدم الحجر في البناء للمرة الأولى بواجهة جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي.
والجامع الطولوني فتح في جدرانه 129 نافذة لكل منها زخارفها التي عولجت على أسس هندسية مدروسة، وله 42 بابًا، وله مئذنة مختلفة عن كل مآذن مصر حيث يدور سلمها حول جسدها من الخارج بدلًا من أن يدور بداخلها كما هو المعتاد، كما يتمتع الجامع بنادرة أخرى وهي النهايات الخاصة بالجدران، والتي تشبه الصفوف الواقفة بجوار بعضها البعض، وعن تلك النهايات يقول الدكتور محمد حمزة الحداد في كتابه العمارة الإسلامية، إن هذه النهايات والتي تُعرف اصطلاحًا باسم الشرافات، تعد الأندر على مستوى العالم، فقد جاءت بشكل آدمي مجرد حيث كان يكره الفنان المسلم أن يصنع الصور أو التماثيل داخل الجوامع، وهي تقف بطريقه تذكرنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبناين المرصوص يشد بعضه بعضًا.

الجامع الأزهر
استطاع الفاطميون أن يسيطروا على مصر بعدما دخلها جوهر الصقلبي قائد جيوش المعز لدين الله الفاطمي عام 358 هـ، وهو يصطحب معه 100 ألف جنديًا، وأسس مدينة وعاصمة رابعة لمصر وهي القاهرة، وبنى فيها قصرًا ضخمًا لمولاه المعز لدين الله، عُرف بالقصر الشرقي الكبير، وبجانب هذا القصر بنى مسجدًا جامعًا جديدًا يُعد هو المسجد الجامع الرابع في مصر الإسلامية، وقيل له الأزهر.
بدأ جوهر ببناء الجامع الأزهر عام 359هـ /970م، وانتهى منه عام 361هـ /972م، وكانت أول جمعة فيه يوم السابع من رمضان لعام 361هـ / 22 يونيو 972م، والجامع وقت تشييده كان أكثر بساطة من الوقت الحالي، حيث كان عبارة عن بناء مربع له 3 أرقوة فقط، الرئيسي منها هو رواق القبلة بدون رواق مقابل له، ورواقين على الجانبين وفي المنتصف صحن سماوي مكشوف.
وعن سبب تسميته فقد يكون الأزهر اسمًا مستمدًا من اسم السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو تمينًا بما سيكون له من مستقبل زاهر في نشر العلم، أو لأن حوله القصور الزاهرة، وفي العموم كانت من عادة الفاطميين التسمية على أفعل التفضيل، مثل الأزهر والأقمر والأفخر والأنور وغيرها من أسماء الجوامع التي ميزت العصر الفاطمي.
كان الغرض من إنشاء الجامع الأزهر هو أن يكون خاص بالفاطميين الشيعة وتعاليمهم، كما أن القاهرة كمدينة كانت مدينة مغلقة على الخليفة وحاشيته، والحقيقة أن هذا من حسن سياسة جوهر الصقلبي الذي لم يحب أن يفاجئ المصريين وهم سنة بخطب الشيعة في جامعي ابن طولون أو عمر بن العاص في الفسطاط.
واعتنت العصور المتتالية بالجامع الأزهر الشريف لاسيما وهو جامع العاصمة الرئيسية للبلاد، والتي تضخم حجمها في عصر صلاح الدين الأيوبي، والذي أمر بتعطيل صلاة الجمعة والحركة التعليمية في الأزهر، وقصر الصلاة على جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي استنادًا إلى فتوى الإمام الشافعي أنه لا صلاة جامعتين في مدينة واحدة.
ثم اعتنى المماليك بالجامع الأزهر الشريف حيث أذن السلطان الظاهر بيبرس البندقداري، للأمير أيدمر الحلبي بإعادة الخطبة إلى الجامع الأزهر الشريف، حيث عمل على استعادة ما اغتصب من أراضيه وأعاد تجديد حوائطه وجعل له منبرًا جديدًا وأصلح سقوفه وأعاد فرشه وإنارته فعاد للجامع بهاؤه من جديد، وكانت أول خطبة جمعة فيه يوم 18 ربيع الأول عام 665هـ /1266م.
وفي زمن الناصر محمد بن قلاوون تعرض الجامع لتصدع كبير بعد زلزال عام 702هـ فأمر بإعادة عمارته، وزاد على الجامع الأمير علاء الدين طيبرس نقيب الجيوش في زمن الناصر محمد بن قلاوون مدرسة وهي إلى يمين الداخل، وذلك عام 709هـ، من باب الجامع، ثم جاء الأمير علاء الدين أقبغا من عبد الواحد استادار الناصر محمد بن قلاوون، وأضاف مدرسة أخرى إلى يسار الداخل وهي المدرسة الأقبغاوية، وذلك عام 734هـ، وفي عصر المماليك الجراكسة أضاف السلطان الأشرف برسباي صهريج لصحن الجامع وفوقه قبة، كان الماء يسيل منها فيما يشبه النوافير وذلك عام 828هـ، ثم في عهد السلطان الأشرف قايتباي أجرى على الجامع إصلاحات كبيرة، وهدم بوابته الرئيسية وأعاد بنائها وإلى جوارها مئذنته الرشيقة القائمة إلى اليوم، وذلك عام 873هـ.



