
مصر لا تعترف بالحدود عندما تتعرض أراضى أشقائها للخطر. لهذا فإنها الملاذ الآمن تاريخيا لمواطنى الدول الشقيقة، عندما تتكاثر عليهم المحن، أو تقع بلادهم فى الحروب. كانت ولاتزال ملاذا آمنا للشوام والعراقيين والخليجيين واليمنيين والسودانيين، وعشرات الآلاف من الأفارقة. وفى هذا السياق فقد تم فتح المعابر للسودانيين كجزء من سياسة التضامن مع الشعب السودانى، الذى يتعرض الآن لظروف شديدة الصعوبة بسبب القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع. وتنظر مصر إلى القتال على أنه شأن داخلى، لا يجب أن تنحاز فيه إلى طرف ضد طرف. لكنها تحاول فى الوقت نفسه التقريب بين الأطراف المختلفة لمصلحة الشعب السودانى، واستقرار المنطقة ككل. ومن الطبيعى أن يكون ضمان سلامة المصريين فى السودان، وإعادتهم سالمين إلى وطنهم وذويهم المسئولية الأولى الملقاة على عاتق الحكومة منذ الساعات الأولى لانفجار القتال، بما فى ذلك القوة العسكرية المصرية التى كانت فى مهمة تدريبية مشتركة مع الجيش السودانى قبل بدء القتال، طبقا لبروتوكول تعاون عسكرى. وحتى ٢٧ من الشهر الماضى أتمت مصر إجلاء ٥٣٢٧ شخصا من أبناء الجالية المصرية، إلى جانب نقل ما يقرب من ١٦ ألفا من أفراد جاليات أخرى. ويبلغ عدد أفراد الجالية المصرية فى السودان حوالى ١٠ آلاف شخص. وتقدر المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد اللاجئين وطالبى اللجوء السودانيين فى مصر حتى أواخر شهر أبريل الماضى بحوالى ١١ ألف شخص، بينما تقدر منظمة الهجرة الدولية عدد السودانيين المقيمين إقامة دائمة فى مصر بحوالى ٤ ملايين سودانى، أى ما يقرب من ١٠٪ من مواطنى السودان، يتمتعون بحقوق الملكية والتنقل والعمل وممارسة النشاط الاقتصادى الخاص. ويتزايد عدد طالبى اللجوء إلى مصر بالمئات كل ساعة.
موجة الهروب الضخمة من جحيم الحرب خلال فترة قصيرة زمنية منذ منتصف الشهر الماضى أدت بالقطع إلى إرباك المجهود الإدارى فى المعابر البرية لتسجيل أعداد وبيانات اللاجئين، خصوصا وأنه لا توجد تسهيلات كافية للإيواء والإقامة على الجانب السودانى من الحدود المشتركة. ومن الضرورى هنا أن تتعاون منظمات العمل التطوعى، ومنظمات الإغاثة الإنسانية والصحية، من أجل توفير ظروف إيواء أفضل على الجانب السودانى، بما فى ذلك توفير مياه الشرب والغذاء والأدوية والخيام والمراحيض المتنقلة، لمنع التكدس والمشاكل والحد من انتشار الأمراض بين طالبى اللجوء. وتعانى جهود الإغاثة فى الوقت الحاضر من ظروف شديدة الصعوبة بعد إجلاء العشرات من العاملين فى برنامج الغذاء العالمى وبعثة الأمم المتحدة والصليب الأحمر. بينما تضاعفت الحاجة لتنسيق جهود تسجيل طالبى اللجوء بعد انتشار حالة من الفوضى فى الخرطوم بسبب فتح السجون وإطلاق سراح المجرمين المحكوم عليهم. ومن الملائم ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع تسرب المجرمين والعناصر الإرهابية إلى طوابير طالبى اللجوء، لأن ذلك يحمل تهديدا صريحا للأمن القومى المصرى، من شأنه أن يضيف إلى التعقيدات الحالية فى جنوب ليبيا.

وإذا كانت مصر تفتح حدودها لأشقائها من باب التضامن الأخوى، فإن هذا التضامن يحتاج إلى مساندة إقليمية ودولية حتى يكتسب القوة الملائمة، فى وقت تعانى فيه مصر من أزمة اقتصادية. ومن الملاحظ أن أهالى أسوان وقرى النوبة فى مصر قد فتحوا بيوتهم للاجئين السودانيين، ويقدمون لهم كافة أشكال المساعدة الممكنة. لكن استمرار هذا الكرم الأخوى سيكون صعبا إذا استمر القتال المتقطع فى السودان، خصوصا فى ولاية الخرطوم التى تستوعب وحدها ما يقرب من ثلث عدد سكان البلاد. وإذا كان عدد كبير من السودانيين قد نزح إلى ولايات أخرى، فإن الأغلبية العظمى من النازحين نفسها فى وضع أصعب يوما بعد يوم، مما يستوجب إدراجها فى قائمة اللاجئين المحتملين، ممن يسعون لطلب اللجوء فى بلدان أخرى. وإذا كانت منظمات الهجرة تقدر أعداد الفارين من حرب الجنرالات وأمراء الحرب إلى الدول المجاورة بحوالى مليون شخص، فإن معظم البلدان المجاورة، باستثناء مصر، تعانى من عدم استقرار أمنى وسياسى، ومع ذلك فإن الوضع فى مصر يستوجب تكامل جهود الإغاثة وإيواء اللاجئين فى كل الدول المحيطة بالسودان بما فيها مصر. وتعانى الأمم المتحدة من نقص فى موارد الإغاثة والمساعدات الإنسانية يقدر بحوالى ١.٥ مليار دولار فى الوقت الحاضر. وبسبب نقص الموارد فإن التمويل المتاح لمنظمات الأمم المتحدة يغطى حتى الآن ما يقرب من ١٤٪ فقط من الاحتياجات العاجلة.
الاصطفاف حول الدولة
يمثل الهروب من الحرب سواء بالنزوح إلى ولايات هادئة نسبيا، مثل ولاية البحر الأحمر والولاية الشمالية، أو إلى حدود الدول السبع المجاورة للسودان: مصر وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا، بداية اصطفاف عسكرى وسياسى واجتماعى جديد فى السودان حول ثلاثة محاور أساسية: الأول هو محور الدولة، الثانى هو محور القبيلة، الثالث هو محور الحركات المسلحة، والرابع هو محور القوى السياسية المدنية.
على المحور الأول والأهم يجرى بذل مجهود كبير لتوحيد إرادة كل من الجيش والشرطة فى مواجهة قوات الدعم السريع. وعلى المستوى الميدانى فإن الجيش يتفوق تسليحيا ولوجيستيا، من حيث امتلاكه لسلاح الطيران والأسلحة الثقيلة والقدرة على التنسيق العملياتى بين الأفرع المختلفة. وتتزايد أهمية هذا التفوق مع تمركز قوات الدعم السريع فى العاصمة الخرطوم. هذا التمركز يحرم قوات الدعم السريع من الميزة النسبية الرئيسية على الجيش فى حرب الشوارع المتحركة، ويفرض عليها أن تخوض «حرب دفاع عن المواقع»، وهو ما يمنح الجيش ميزة نسبية إضافية لقدرته على استخدام الطيران فى ضرب المواقع من الجو، واستخدام الدبابات والأسلحة الثقيلة فى عزل مواقع قوات الدعم السريع، وتمشيط الأحياء والمربعات السكنية، لإبادة تلك القوات التى تفتقر بطبيعة تكوينها إلى القدرة على الدفاع عن المواقع وضعف التنسيق العملياتى بين الأسلحة المختلفة، لأنها بالأساس قوات مدربة على الكر والفر والسلب والنهب وشن الهجمات كمجموعات صغيرة. ومن المؤكد أن هناك أطرافا إقليمية يهمها تطوير الاصطفاف حول محور الدولة، كما أن هناك أطرافا أخرى لها مصالح فى تعزيز قوة الجماعات المسلحة غير الحكومية، والنزعات القبيلية. وإذا سارت الحرب إلى مداها، فإن الخرطوم ستتحول إلى مجرد أكوام من الخراب، بسبب القصف الجوى واستخدام الدبابات والأسلحة الثقيلة.

من التصوف إلى السلاح
يمثل السودان تكوينا اجتماعيا فسيفسائيا، تبرز فيه تكوينات القبائل العربية فى مواجهة القبائل الأفريقية، والمناطق الحضرية فى مواجهة القرى الزراعية، والمناطق البدوية التى يسيطر عليها الرعى كنشاط اقتصادى رئيسى فى مواجهة الصحراء والطبيعة القاحلة، والشرق فى مواجهة الغرب، والحركات الصوفية بامتداداتها السياسية المتنوعة، فى مواجهة الحركات المسلحة. الجديد فى تاريخ السودان المعاصر هو أن القوى السياسية القبلية الجديدة، إتجه كل منها لتكوين ظهير عسكرى، ليصبح هو قبضته المسلحة التى يستخدمها فى حالات الدفاع والهجوم السياسى على السواء، بعد أن كانت الحركات الصوفية هى الظهير الشعبى للتنظيمات السياسية خلال فترة الاحتلال البريطانى، وفترة ما بعد الاستقلال حتى مجئ جعفر النميرى. الآن يوجد فى السودان حوالى ٨٠ حركة سياسية - مسلحة تنتشر معظمها فى دارفور، فلا توجد تقريبا قوة سياسية فى دارفور بدون ظهير عسكرى. كما أن هذه الحركات المسلحة تنتشر فى كل أنحاء السودان تقريبا. وتتغذى القوى السياسية المسلحة على الخلافات وصراعات المصالح بين القبائل. وإذا استمرت الحرب الحالية، فإن ما تبقى من السودان سيكون معرضا للإنشطار إلى دويلات صغيرة، بما فيها دارفور. وكانت قوة الرد السريع قد ولدت فى دارفور عام ٢٠٠٣ بقرار من الرئيس السابق عمر البشير، اعتمادا على القبائل العربية ضد القبائل الأفريقية. لذلك فإن كون هذه القوات طرفا فى الحرب الحالية من شأنه أن يعيد بعث الصراع بين العرب والأفارقة فى السودان إلى ذروة جديدة، خصوصا مع ضعف الدولة وغياب سلطتها تقريبا فى كل أنحاء السودان، بما فى ذلك العاصمة الخرطوم.
وقد تحولت الحركة السياسية المدنية التى كانت قيادة الثورة فى عام ٢٠١٩ إلى مجرد متفرج، يكتفى بإصدار البيانات التى تناشد القوى المتحارية بوقف القتال، والعودة إلى مائدة المفاوضات، والعمل على تنفيذ الإطار السياسى للعملية الانتقالية التى تهدف إلى نزع البندقية من السياسة وتسليم السلطة المدنيين. إن القتال بين العسكريين أدى عمليا إلى إعادة السودان عشرات السنين إلى الوراء، كما إنه حول القوى السياسية المدنية من صانع للأحداث إلى مجرد متفرج عليها لا حول له ولا قوة؛ فالحرب، خصوصا فى الخرطوم أحالت السياسة إلى حطام، ومجرد بيانات إنشائية لا قوة لها. كما أن القتال الحالى تسبب فى تغيير بوصلة الاهتمام للمجتمع الدولى بما يجرى فى السودان فى اتجاه وقف الحرب وتطبيع الحياة اليومية، وليس التحول الديمقراطى. ولن تستطيع القوى المدنية فى الوقت الحاضر منافسة العسكريين فى ميادين النفوذ السياسى، إلا إذا اجتمعت الإرادتين الإقليمية والدولية وكذلك الإرادة المحلية على كلمة واحدة تقضى بإبعاد صراع العسكريين عن المشهد السياسى، وربط عملية إعادة البناء السياسى والاقتصادى بعد الحرب بتحول ديمقراطى على نطاق واسع، تلعب فيه القوى المدنية دورا قائدا.
عدم الثقة والصراع «الصفري»
خطورة الوضع الأمنى فى السودان حاليا لا تعود فقط إلى القتال الدائر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وهى قوات شبه نظامية تمثل جزءًا من المنظومة العسكرية للدولة، إلى جانب كل من الجيش والشرطة، وإنما تنبع الخطورة من عدم الثقة بين طرفى الصراع الحالى، إلى حد أن كلا منهما يسعى لنفى وجود الآخر تماما. لهذا نجد ضعف الالتزام باتفاقيات الهدنة المؤقتة، ومحاولة كل منهما استغلال تلك الاتفاقيات من أجل تعديل خطوط وقف إطلاق النار لزيادة قوته النسبية، وإضعاف الخصم. كما يرفض كل من الفريق البرهان والفريق دقلو التفاوض مع الآخر إلا من موقع القوة، التى تسمح للأقوى بأن يملى شروطه على الضعيف. وفى حال استمر القتال فى أى صورة من الصور، فسوف يكون مستقبل السودان أسوأ كثيرا مما نراه فى ليبيا واليمن وسوريا، كما قال الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، الذى أطيح به فى أكتوبر ٢٠٢١.
انقسام الإرادة دوليًا وإقليميًا
من الملاحظ أن عمليات إجلاء الجاليات ونقل أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية، فى الأيام الأخيرة كشفت عن بعض الملامح الجديدة فى علاقة المنطقة بالعالم. وبصرف النظر عن حرص كل دول العالم على إجلاء رعاياها من السودان، تحسبا لتدهور الأمور أكثر فأكثر، فإن عمليات الإجلاء التى تمت تكشف تغيرات فى نمط العلاقات الإقليمية والدولية. كان من أبرز هذه التغيرات بروز دور السعودية فى عمليات إجلاء رعايا الدول الأخرى وبعثاتها الدبلوماسية، بما فى ذلك الصين وإيران؛ فكانت السفن السعودية صاحبة النصيب الأكبر فى نقل الهاربين من جحيم القتال فى السودان إلى ميناء جدة أولا، ثم استكمال الترتيب مع الدول الأخرى لنقل رعاياها إلى بلدهم. وفى جدة لقى أفراد الجاليتين الصينية والإيرانية اهتماما كبيرا. من الواضح أن الاهتمام الدولى بالسودان لا يعكس فقط السعى لتجنب الخسائر بسبب القتال، ولكنه يتضمن أيضا تثبيت مواقف دبلوماسية جديدة فى أفريقيا، التى أصبحت تمثل أحد أهم ساحات التنافس على النفوذ بين القوى التقليدية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والقوى الجديدة مثل الصين وروسيا والسعودية. ومع أن هناك اتفاقا بين الجميع على وقف إطلاق النار، فإن مضمون ذلك يختلف من قوة إلى أخرى. ويكشف التصريح الذى ألقاه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بشأن مشروعية استعانة السودان بمجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، مقدار الغموض الذى تنطوى عليه الدعوة إلى وقف إطلاق النار، قبل بلورة موقف سياسى واضح بشأن ما سيؤول إليه وقف إطلاق النار. وبسبب عدم اتفاق الإرادتين الإقليمية والدولية، وضعف موقف القوى السياسية المدنية، وتبنى كل من الجنرالين المتحاربين لرؤية تنطوى على معادلة صفرية للصراع: «إما أنا أو انت"! فإن الصراع سوف يطول، كما طالت ولاتزال صراعات أخرى فى المنطقة بدون حل نهائى حتى الآن فى ليبيا وسوريا واليمن. ومن ثم فإن امتداد الحرب فى السودان لن يكون حالة استثنائية جديدة فى المنطقة.




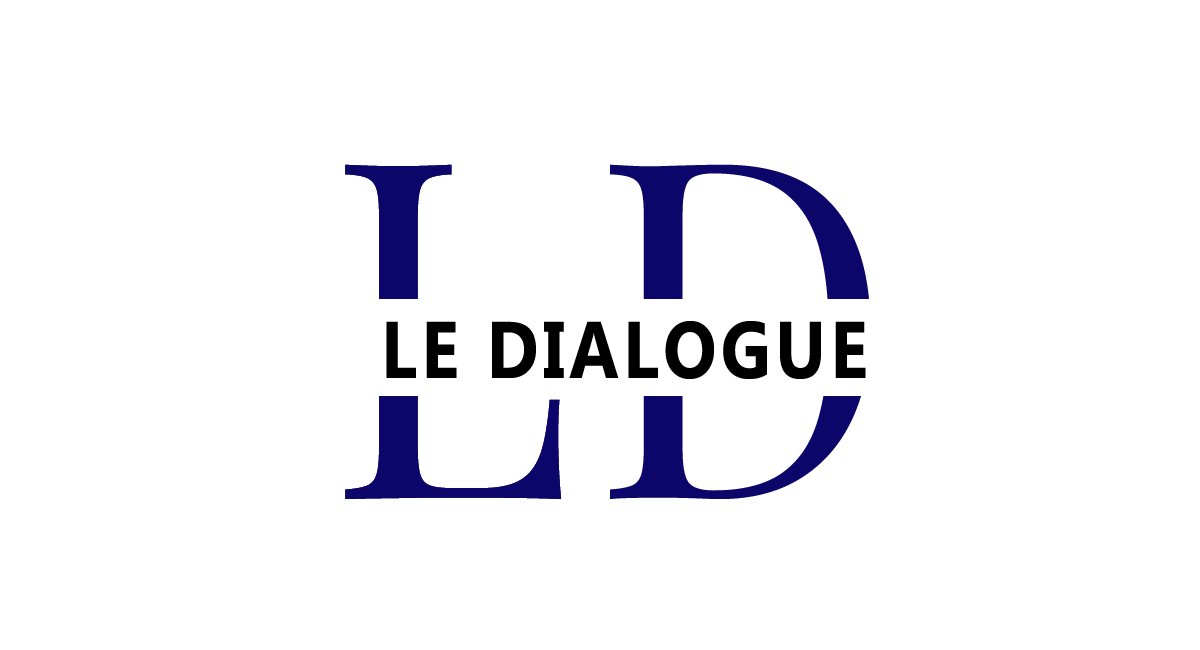 بالعربي
بالعربي
