
حملة عدائية شرسة تقودها واشنطن وإجراءات قاسية تستهدف فصل الصين عن العالم
"الصين تختار السلام».. ثلاث كلمات تصلح عنوانًا للسياسة الخارجية للدولة الكبرى التى دخلت حلبة المنافسة على النفوذ فى العالم، بعد أن كانت دولة فقيرة تعانى من المجاعة فى منتصف القرن الماضىى. فى حلبة المنافسة الصين اختارت السلام، واختيار تسنده القوة، ولا يستقيم بدونها، خصوصًا وهى تواجه حملة عدائية شرسة متعددة المستويات، تقودها الولايات المتحدة ومن ورائها دول حلف الناتو، تشمل التشكيك فى شرعية نظامها السياسى، وإجراءات قاسية تجارية وتكنولوجية ومالية وإعلامية وتعليمية تستهدف فصلها عن العالم، وليس فقط فصلها عن الولايات المتحدة، التى تقوم بتحرشات عسكرية على حافة حدودها البحرية والجوية.
القوة التى تسند خيار السلام الصينى ليست مستحدثة إستحداثًا طارئًا، وإنما هى قوة مستدامة، تتوفر لها محركات تدفعها، وأجنحة تطير بها وتعلو فى مجالات الإقتصاد والدفاع والدبلوماسية والتكنولوجيا. وتعمل محركات القوة الصينية فى ميادين تكوين «فائض القوة»، الأمر الذى يمكنها فى المستقبل القريب من أن تصبح قوة رئيسية نموذجية متكاملة الأركان، محليًا وإقليميًا وعالميًا. ولا يوجد مبرر يجعل الصين تحاول طلب القوة عن طريق اعتراض طريق الآخرين، أو بذل جهود من أجل إعاقة حركتهم، وفرض العقوبات عليهم كما تفعل الولايات المتحدة. هذا يعنى أن محركات القوة الصينية تكرس حركتها من أجل إنتاج «طاقة إيجابية» للبناء مع آخرين، على العكس من الولايات المتحدة التى تكرس مجهودها على محاولة إعاقة الآخرين وشل حركتهم، إعتقادًا من قيادتها بأن هذا هو الطريق الوحيد للمحافظة على تفوقها وهيمنتها. ولذلك فإن السلوك الدولى للولايات المتحدة ينتج «طاقة سلبية» رجعية، هدفها تعطيل التقدم.
ويمكننا أن نستنتج بقدر كبير من الثقة، أن استراتيجية بناء القوة فى الصين مرت بمرحلتين رئيسيتين حتى الآن، وتدخل مرحلتها الثالثة. المرحلة الأولى، ركزت فيها القيادة الصينية على بناء مقومات القوة الذاتية فى الداخل، وهى مرحلة تخللتها فترات من الصعود والهبوط، والمكاسب والتضحيات، إنتهت إلى طريق الانفتاح الاقتصادى والسياسى على العالم فى عام ١٩٧٨، ونصجت قوتها الذاتية على هذا الطريق حتى بلغت ذروة عالية عام ٢٠١٢. خلال تلك المرحلة لم تلمع السياسة الخارجية للصين كما سنراها فيما بعد، رغم اهتمامها بتطوير علاقات تشابك على المستوى الإقليمى.
بعد ذلك بدأت المرحلة الثانية عام ٢٠١٣ بإطلاق مبادرة «الطوق والطريق» (أنا أفضل هذه التسمية باللغة العربية على التسمية الشائعة المختلطة بالرقص! ألا وهى «الحزام والطريق")، وهى مرحلة إنطلقت من منصة «فائض القوة الذاتية» الذى حققته الصين قبل إطلاق المبادرة، بما فيه من مكونات اقتصادية، منحتها مزايا كبيرة فى إقامة استثمارات ضخمة فى مجالات البنية الأساسية التقليدية والتكنولوجية، خصوصًا وأنها كانت عمليًا قد انتهت من بناء شبكات البنية الأساسية الداخلية طبقًا للمعطيات التكنولوجية المتاحة. عند ذلك أصبح من الضرورى فتح مجالات خارجية لتصريف فائض القوة من خلال مشروعات تحقق ربحًا مشتركًا للصين وللأطراف الأخرى المشاركة معها. ومن هنا جاءت عبقرية مبادرة «الطوق والطريق»، التى تقوم على استلهام التاريخ، وإعادة رسم خريطة المصالح الصينية مسترشدة بخبرات طريق الحرير القديم الذى كان يربط الصين بالعالم، على أساس معادلة win - win بينها وبين الأطراف الأخرى. ويمكننا أن نحدد الملامح الرئيسية للمبادرة فيما يلي:
أولًا: هى مبادرة اقتصادية لا سياسية،
ثانيًا: تقوم على أسس براجماتية لا أيديولوجية،
ثالثًا: تستهدف بناء الثقة والنفع المتبادل، على أساس مبدأ الربح المشترك، وليس مبدأ القوى يفوز بكل شيئ، أو ما يعرف بالمعادلة الصفرية zero-sum game فى الدبلوماسية الدولية التى تقودها الولايات المتحدة.

وعلى مدار عشر سنوات (٢٠١٣ - ٢٠٢٣)، منذ إطلاق الصين مبادرة «الطوق والطريق»، إستطاعت الصين تقديم نموذج جديد فى التعاون الاقتصادى المتبادل والتنمية فى ظروف صعبة، وتمكنت من إقامة خطوط لنقل التجارة بالسكك الحديد والسفن والطائرات، وإنشاء طرق وموانئ ومطارات، وشبكات للإتصالات، عبر ممرات طريق الحرير التقليدى، حتى أصبحت الصين أكبر مصنع وأكبر متجر فى العالم كله. ومع ذلك، فإننا يجب أن نأخذ فى اعتبارنا أن البنية الأساسية التى أقامتها الصين، ما تزال هشة فى بعض جوانبها، مثل مشروعات المبادرة فى مقاطعة جوادر فى باكستان، وفى سريلانكا (ميناء هامبانتوتا)، وفى بعض البلدان الأفريقية، وهو ما يحتاج إلى تطوير نوعى متوازن فى علاقات الصين مع شركائها على طول طريق الحرير. وإضافة إلى ذلك فإن مشروعات المبادرة فى بعض البلدان، مثل إيطاليا أو البرتغال، يمكن أن تتعرض لقيود تعود لأسباب جيوسياسية. وتواجه «مبادرة الطوق والطريق» بشكل عام إجراءات عدائية متنوعة ضد مشروعاتها المختلفة، خصوصًا المتقدمة تكنولوجيًا، التى تقوم بها شركات صينية ذات مكانة عالمية، مثل هواوى للإتصالات. ومن أجل إسناد مبادرة «الطوق والطريق» تم إنشاء منظمة شنغهاى للتعاون، والبنك الآسيوى لتمويل مشروعات البنية الأساسية الاقليمية، كما دخلت الصين فى مشروعات للتعاون الإقليمى المتعدد الأطراف، من خلال المشاركة فى إقامة مجموعة بريكس BRICS واتفاقيات التعاون المتعددة الأطراف فى جنوب شرق آسيا.
ومع وصول مشروعات مبادرة «الطوق والطريق» إلى أوروبا، وبروز قوة الصين التجارية والتكنولوجية والعسكرية، زاد القلق من زيادة نفوذها على حساب النفوذ الأمريكى، وتبنت الإدارة الأمريكية منذ عام ٢٠١٧ إستراتيجية عدائية تجاه الصين، خلال فترة حكم دونالد ترامب الجمهورى، ثم خلفه الديمقراطى جوزيف بايدن. وتعبر هذه الاستراتيجية عن نفسها بصراحة ووضوح فى استراتيجية الأمن القومى والوثائق المرتبطة بها، وفى سياسات الادارة، والقوانين التى يوافق عليها الكونجرس الأمريكى، وتتجلى القوانين والإجراءات العدائية ضد الصين فى ترسانة متكاملة تستهدف عرقلة تقدم الصين، وفصلها عن النظام العالمى. وتعتبر الولايات المتحدة أن حربها ضد الصين يجب أن تنطلق من منصة تحالف دولى، وليس مجرد حرب ثنائية بينها وبين الصين، وأن تكون حربًا شاملة متعددة المستويات، وليس مجرد حرب جزئية فى ميدان واحد، وأن تكون حربًا ممتدة تنتهى بتغيير النظام «الأوتوقراطى التسلطى» فى الصين، وليس مجرد حملة مؤقتة لتحقيق مكاسب جزئية. وتستعين واشنطن فى حربها ضد بكين بكل ما فى صندوق أدوات الحرب الباردة الموجود فى أرشيف الدبلوماسية الأمريكية من التشويه الإيديولوجيى، والمقاطعة الاقتصادية، والحملات الإعلامية السلبية، وسباق التسلح، والمناورات العسكرية الإستفزازية، حتى الحروب بالوكالة. ومن ثم فإن المواجهة الحالية تحاول فيها الإدارة الأمريكية إستنساخ أساليب الحرب الباردة الأولى، على أمل أن يؤدى استخدامها إلى نتائج مماثلة لما حدث فى نهاية الحرب الباردة الأولى بسقوط سور برلين والاتحاد السوفيتى وحلف وراسو، ومن ثم النظام الثنائى القطبية.. وقد طرحت هذه الحرب الباردة الجديدة أسئلة وتحديات خطيرة على القيادة الصينية، خصوصًا مع كثافة إجراءات الحرب، وتسارع معدلات تنفيذها خلال السنوات الأخيرة. وهو ما أدى إلى وضع أسس انتقال عملية بناء القوة فى الصين إلى المرحلة الثالثة التى نشهدها تتبلور فى الوقت الراهن من خلال مبادرتين كبيرتين، الأولى هى «مبادرة الأمن العالمي» Global Security Initiative، التى تم إطلاقها فى أكتوبر الماضى (٢٠٢٢) بواسطة الحزب الشيوعى الصينى، والثانية هى «مبادرة الحوار بين الحضارات» Global Civilization Initiative التى أطلقها الرئيس الصينى شى جين بينج فى ١٥ مارس ٢٠٢٣ بمناسبة مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعى الصين والأحزاب السياسية العالمية.
وتعكس كل من المبادرتين رؤية الصين للعالم ومكانها فيه، سواء على مستوى العلاقات بين الدول (مبادرة الأمن)، أو على مستوى الشعوب (مبادرة الحوار الحضارى). لكن الرؤية وكلا من المبادرتين تستند إلى «فائض القوة» الاقتصادية الذى تحقق وتراكم فى الصين خلال المرحلتين الأولى والثانية من عملية بناء القوة. وتتجه الصين خلال المرحلة الثالثة إلى استثمار فائض القوة الاقتصادية فى مجالات الدفاع والسياسة الخارجية. وإذا كانت المبادرتان المشار إليهما تمثلان كيفية استثمار فائض القوة فى السياسة الخارجية، فإن الجانب الآخر المهم، الذى يتمثل فى استثمارات فائض القوة فى مجالات الدفاع يتجلى فى مشروعات استراتيجية تتم بنجاح فى قطاعات الدفاع البحرى والصاروخى والفضائى، وهو ما يحتاج إلى حديث متصل يبين بعض جوانب التقدم الذى أحرزته الصين، خصوصًا فى عملية انتقالها من قوة عسكرية برية إلى قوة بحرية وصاروخية وفضائية من الطراز الأول، والتنسيق العسكرى عن قرب مع قوى رئيسية عالميًا وإقليميًا، فى إطار استراتيجية للردع المتعدد الأطراف.




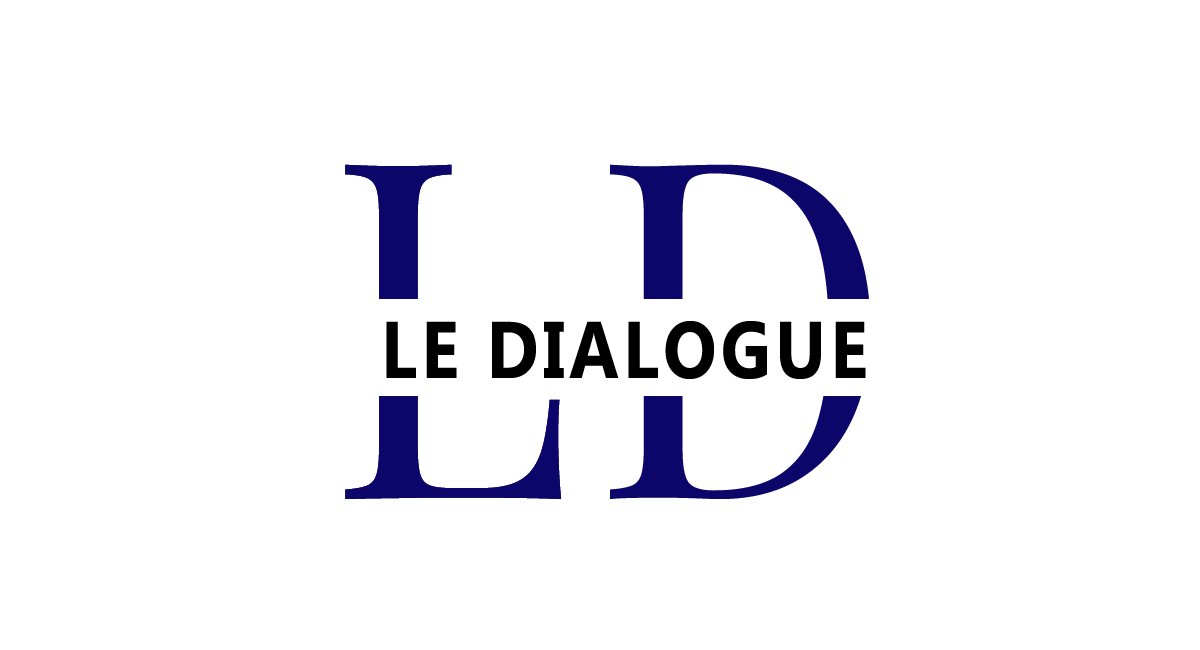 بالعربي
بالعربي
