
الزوجة الفرنسية تموت فى عملية ختان وحشية تحت قيادة داية القرية المصرية بهدف «تختين» الحضارة الغربية
سليمان فياض
يقف حامد فى المنطقة الوسطى المراوغة بين «باريس» و«الدراويش»، وإذا كانت الإقامة الطويلة فى فرنسا تحيله غربيًا فى التفكير والسلوك، فإن التاريخ البعيد فى القرية يضفى عليه لمسات عاطفية وشعورًا بالواجب تجاه جذوره التى يتشبث بها
قد تكون رواية الكاتب المصرى سليمان فياض شبيهة في بعض جوانب المعالجة لتجارب روائية سابقة، تناقش القضية نفسها، كما هو الحال عند الروائيين المصريين توفيق الحكيم في «عصفور من الشرق»، ويحيى حقى في «قنديل أم هاشم»، وفتحى غانم في «الساخن والبارد»، ويوسف إدريس في «البيضاء»، فضلًا عن الكاتب اللبنانى سهيل إدريس في «الحى اللاتيني»، والكاتب السودانى الطيب صالح في «موسم الهجرة إلى الشمال»، وأعمال أخرى غير قليلة؛ لكن رواية «أصوات» لسليمان فياض تنفرد بأن الصراع لا يخوضه فرد شرقى في أوروبا، ولا يتجسد عبر مثقف يتسلح بالوعى النظري. القرية المصرية التقليدية تنوب في مجموعها عن فرد بعينه، والمباراة «هنا فى مصر» وليست «هناك فى فرنسا»، والنهاية المأسوية الدموية تكشف عن أبعاد جديدة، وتبرهن على الفارق الشاسع بين حضارتين لا تلتقيان، وتؤكد أن التواصل بين العالمين المتناقضين ليس ميسورا، دون نظر إلى النوايا الطيبة والتسامح الشكلى الهش.
بعد ثلاثين عاما من الغياب، يعود حامد مصطفى البحيرى إلى قريته التى يفر منها طفلًا في العاشرة. يستقر في فرنسا بعد رحلة من المعاناة، ويرتقى إلى طبقة أصحاب الملايين. يمتلك فندقا ومطعما، ويتزوج الفرنسية الخالصة سيمون، وينجب منها ولدا وبنتا. الحنين إلى الأهل ومسقط الرأس دفعه إلى الزيارة، والترحيب الحار به لا يخلو من المبالغة والطمع في ثرائه. عندما يقصد القاهرة في زيارة عمل قصيرة، تنفرد أمه وحفنة من نساء القرية بسيمون، وتموت الزوجة في عملية الختان التى تتسم بالوحشية والعنف، تحت قيادة داية القرية. الهدف من العملية أن تكون واحدة منهن، والمغزى الأعمق هو «تختين» الحضارة الغربية حتى يمكن التعايش معها وفق معطيات الشرق وقوانينه. التساؤل الذى يطرحه الطبيب في السطر الأخير من الرواية هو جوهر الرؤية: «موتنا، أم موتها؟!».
البداية مع رسالة غير متوقعة يتلقاها مأمور المركز من حامد، وينم الأسلوب عن طبيعة شخصية كاتبها، الأقرب إلى ثقافة الغرب منه إلى السمات الشرقية المعهودة:

«سيدى المأمور: أرجو أن تساعدنى في البحث عن أهلي. من بقى منهم على قيد الحياة. لقد غادرت قريتي: «الدراويش» منذ ثلاثين عاما، وعمرى عشرة أعوام. وفتح الله عليّ منذ سنوات، فصرت من أغنياء باريس. وأشعر الآن بالحنين العميق إلى رؤية أهلى وبلدي، ومد يد العون إليهم ما وسعتنى القدرة. اسمى «حامد مصطفى البحيري» ولن تعدم من يعرف عائلتى في الدراويش. وأرجوك أن تخبرنى ببرقية على عنوانى المذكور أدناه، بكل ما ينبغى أن أعرفه الآن. وبرقيتكم المنتظرة إليّ، سأقوم بدفع تكاليفها وآمل، حين نلتقي، أن نصبح صديقين».
اللغة هادئة عقلانية منضبطة، تخلو من الإسراف الانفعالى العاطفي، وتنجو من النبرة الإنشائية الفضفاضة، كما أنها تتسلح بقدر كبير من الموضوعية والنزعة العملية، وهو ما يتجلى في تأكيد حامد على تكفله بدفع تكاليف برقية المأمور التى ترد على تساؤلاته. لا شك أنه يحب وطنه مصر وقريته «الدراويش»، والإعلان عن نيته في «مد يد العون» دليل على الانتماء الراسخ الذى لا يتبخر بعد سنوات طوال في الغربة.
يشيع خبر «عودة الغائب»، وتتنوع ردود الفعل من أبناء القرية. الأغلب الأعم منهم لا يعرفون شيئا عن حامد، ولعل الشهادة الأهم هى التى يقدمها محمد بن المنسي، ذلك أنه يتجاوز الإطار الفردى ضيق الأفق إلى دائرة الرؤية الموضوعية الشاملة: «أخذت عيوننا ترى ذلك الشيء الجديد الوافد، المثير للدهشة، يسقط على قريتنا من حالق، ونقع تحت وطأته في شعور بالتخلف والعار، والترقب المبهور الأنفاس، والخوف من أن نرى أنفسنا بعيون جديدة».
«الآخر» العائد بعد غيبة لم يعد مصريا خالصا، والشعور الضاغط بالتخلف والعار مبرر بالنظر إلى نجاحات المغامر المدهش صانع الأعاجيب. الحواجز والسدود المنيعة قائمة لا يمكن إهمالها أو إنكارها، وفى رسالة حامد الثانية، الموجهة إلى أمه وأخيه، ما يكشف عن حقيقة إنه مسكون بمشاعر الخجل من بؤس الواقع، ما يتطلب قدرا من التجميل للتغطية على القبح: «أرسل لكما برقيا ألفى جنيه، لبناء بيت على الجسر، صالح لإقامة زوجتى الباريسية، في بحر أسبوعين من تاريخه. استشيرا في ذلك مهندسا معماريا».
الفلاحون لا يعتمدون على المهندسين في بناء منازلهم، والمبلغ الذى يرسله حامد، بمقاييس المرحلة التاريخية، قرب نهاية الأربعينيات في القرن العشرين، يبدو خياليا يدير الرؤوس. العبارة التى تستدعى التأمل الطويل هى «صالح لإقامة زوجتى الباريسية»، كأنه على يقين من أن البيت القديم الذى يعرفه لا يليق بها.

لا يتورع شقيق حامد عن استقطاع جزء كبير من المبلغ لحساب دكانته وبيته، ولا يتم بناء البيت لضيق الوقت وارتفاع التكاليف، واللافت أيضا أنه يشعر تجاه أخيه بمزيج من الفخر والغيرة، وهى الثنائية التى تسيطر على كثير من المحتفين بحامد.
لا تفاصيل مشبعة عن طفولة الغائب العائد، ومن الذى يهتم بطفل لا يختلف عن عشرات الأطفال الفقراء؟، لكن شيخا من معمرى القرية يحكى عن بعض ما يتذكره: «سرق من ثلاثين سنة، خمسة قروش، من أبيه، الله يرحمه ويحسن إليه، ضربه المرحوم، وطرده من البيت، من ثلاثين سنة، ولكن الولد جعلها مبررًا، ولم يعد أبدا».
ذكريات كهذه تحتمل الصدق والكذب، لكن المليونير العائد كان بالضرورة واحدا من قطيع الأطفال متشابهى الملامح، أو بتعبير الطالب المثقف محمود المنسي، الذى يتهيأ لدخول كلية الطب: «كان ذات يوم، واحدا من صبيتها الحفاة، المرقعى الثياب، الدائمى الشكوى من المغص، والبول الأحمر، والصداع والدوار، وآلام العينين. وكان يمكن أن يظل كذلك، إذا قُدر له أن يعيش حيا في الدراويش، حتى الآن».
يقف حامد في المنطقة الوسطى المراوغة بين «باريس» و«الدراويش»، وإذا كانت الإقامة الطويلة في فرنسا تحيله غربيا في التفكير والسلوك، فإن التاريخ البعيد في القرية يضفى عليه لمسات عاطفية وشعورا بالواجب تجاه جذوره التى يتشبث بها.
في نشاط ودأب يعمل المأمور والعمدة وأعيان القرية لاستقبال حامد وسيمون، ويحرص المحتفون جميعا على تجميل واقع مزدحم بمفردات القبح والقذارة والإهمال، وكل ما يترتب على الفقر والجهل من تداعيات، لكن جهودهم هذه لا تتجاوز الظاهر السطحي. الهموم والآفات المتراكمة لا يمكن إصلاحها في يوم وليلة، ودوافع الاهتمام بالزيارة لا تخلو من مصالح شخصية وبحث عن منافع مادية أو معنوية. الزيارة المباغتة بمثابة الزلزال العنيف الذى يحرك الراكد الآسن، ويعرى في قسوة حقيقة المجتمع المصرى وليس قرية «الدراويش» وحدها.
تكتمل اللوحة المعقدة بعينى حامد نفسه، ذلك أن فرحته بالعودة لا تدوم طويلًا، كأنها الحلم الذى يتبدد مع صدمة الاستيقاظ. الإسكندرية قريبة الشبه من باريس، وكذلك القاهرة بدرجة أقل، لكن الاختلاف شاسع في الطباع والسلوك ومفردات الحضارة: «أزعجنى الفلاحون، وهم لا يزالون يعملون بأيديهم، جنبا إلى جنب، مع الحمير والجواميس والبقر. وأزعجنى مشهد القرى الطينية الواطئة المتلاحقة، والوجوه الذابلة السمراء، المصفرة الممصوصة، معلنة عن الأنيميا، والدوسنتاريا، ونقص الهيموجلوبين. وقلت لنفسي: هذا هو الوطن».
هل يتوهم حامد أن السنوات الثلاثين التى يبتعد فيها كفيلة بتغيير حيوات الفلاحين وأدوات عملهم ومساكنهم، والقضاء على الأمراض الخطيرة المزمنة؟!. الإصلاح لا يولد فجأة، والاقتراب من الحضارة الغربية ليس واردًا. العالمان مختلفان لا يلتقيان، والزوجة الفرنسية لا تشعر بالأزمة وتعلن عن سعادتها بما تراه كما يليق بسائحة لا تنهمك في المقارنة ولا تنشغل بما يعتمل في أعماق حامد من مشاعر. لا تخفى إعجابها بالشمس الساطعة المحرقة، وبالخضرة الممتدة والحياة البدائية، ولا تغيب عنها أيضا مظاهر التخلف. تتساءل في عفوية: «لماذا يبدو المرض على وجوه الناس؟ لماذا يزرع الناس بدون ماكينات؟ لماذا يمشى الأطفال حفاة؟.. كانت أسئلتها تقتلني. وكنت أقول لنفسي: هذه هى بلادي، وهؤلاء هم قومي».
لا جدوى من إنكار الواقع الكئيب المتجهم أو الخجل منه، والفارق الحضارى ليس قدرًا حتميًا لا فكاك منه، وهو مردود في جانب منه إلى صراع قديم لا بد من وضعه في الاعتبار عند القراءة الموضوعية التى تستهدف الوصول إلى الحقيقة الغائبة. نقلا عن الأجداد الراحلين، يستعيد العمدة بعض المذابح المروعة التى يرتكبها قوم سيمون في حملتهم الاستعمارية قرب نهاية القرن الثامن عشر: «قريتنا مات فيها من أبناء الدراويش والبلدان المجاورة، وبيد قوم سيمون، سبعة عشر ألفا».
كان ذلك قبل مائة وخمسين سنة، ولا شك أن وحشية الاستعمار الغربي، فرنسيًا كان أم إنجليزيًا، ذات أثر في تخلف مصر وتراجعها الحضاري، ولا شيء من المنطق في إدانة معطيات الواقع القائم والتغاضى عن مسببات الأزمة وجذورها. فكرة الثأر ليست مطروحة، لكن الوعى بالجرائم الأوروبية غير الإنسانية ضرورة لا غنى عنها، حتى لا يُساق المصريون إلى هاوية الشعور بالدونية.

من البديهى أن ينعكس التخلف المادى على السلوك والمشاعر والأحاسيس، ولا يقتصر هذا الانعكاس على هيمنة الطمع وشهوة استغلال ثراء حامد، بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى خلل أخلاقى أعمق وأشد ضراوة. شقيق حامد يشتهى سيمون، وزوجه زينب بدورها تشتهى شقيق زوجها، والطالب الشاب المثقف محمود المنسي، يشرب القليل من البيرة فيعترف لسيمون بحبه!.
في سياق كهذا، قوامه الارتباك والاضطراب، لا يبدو مستغربًا أن تنشغل العجوز أم حامد بقضية الانتماء الدينى لأحفادها، وأن يتحول عدم ختان سيمون إلى أزمة خطيرة جديرة بالمناقشة المستفيضة والبحث عن علاج حاسم لها. تختين المرأة الفرنسية يعنى إخضاعها بالقوة لقواعد الشرق المسلم الذى لا تنتمى إليه، والعجائز من نساء القرية، وأم حامد في طليعتهن، يحملن الزوج مسئولية الانفلات الذى يتسم به سلوك سيمون: «هو اسم النبى حارسه وضامنه، حامد، ليس منا. كيف يتركها هكذا تعمل ما تريده؟».
مع سفر حامد إلى القاهرة في مهمة عمل، تُتاح للأم وصاحباتها فرصة الحوار المطول عن قضية سيمون، وصولًا إلى اتخاذ قرار التختين الذى يعيد الأمور إلى نصابها، ويصون الشرف والعفة. المرأة غير المختنة، وفقا للثقافة الشرقية السائدة، هائجة جنسيا ولا تشبع من الرجال، ما يعنى أنها خائنة متعددة العلاقات. تموت سيمون في عملية الختان الوحشية، ولا فارق في جريمة كهذه بين النوايا الحسنة والسيئة.
لا تتسع الرواية لرصد رد فعل حامد على قتل سيمون، فهى تُقتل وتُدفن في غيابه، لكن الجريمة في جوهرها ليست عملية فردية بقدر ما هى تجسيد للصراع الحضارى العابر للأفراد.
يتكتم المأمور على جريمة القتل ويسعى إلى طمس ملامحها، امتدادًا للنمط الشرقى من التفكير المخاصم للصراحة والمواجهة، ولا شيء يملكه تجاه الزوج إلا التعاطف والشفقة: «مسكين أنت يا حامد. النداهة نادتك فقطعتَ بحارًا وبلادًا، لتفقد أعز ما تحرص عليه هنا، في بلدك».
يرى المأمور في قتل سيمون عملًا وحشيًا همجيًا، وهو محق في ذلك، ويحمّل أم حامد وزوجة أخيه مسئولية الجريمة، ويعود مجددًا للتفكير في الزوج الغائب عن مسرح الأحداث: «هل يجد حامد عزاء فيما حدث؟. بقدميه جاء لعذابه الأبدي. لو لم يغادر باريس، مستجيبًا لنداء النداهة، لما حدث له كل ما حدث».
هذا النمط من التفكير أحادى الجانب، وليد الانفعال العاطفى الذى لا يرى إلا ما يريد أن يراه، يتغافل عن الإحاطة بجملة المشهد. المأمور نفسه من يوصى الطبيب بالإعلان عن سبب كاذب للوفاة تجنبًا للفضيحة، وللظفر بالنجاة من المسئولية التى قد تلاحقه. يصل إلى القرية فيأمر العساكر والخفراء أن يفضوا تجمهر الفلاحين بالقوة، وعندما يدخل بيت البحيرى ويرى العمدة: «صحت به بغلظة، فنهض واقفا. رفعت يدي، وصفعته على وجهه، فبكى. رأيت أحمد واقفا في حالة انهيار. أردت أن أقبض على تفاحة آدم البارزة في عنقه، بأسناني، وأنزعها له، لكننى بصقت في وجهه، فلم يرفع يده، حتى لمسحها».
كيف للمأمور أن يدين همجية القتلة الجهلاء، وهو الذى يمارس سلوكا همجيا مماثلا؟.
الإدانة تطول الجميع على نحو ما، وحيثيات الدفاع والتبرير لا تغيب أيضا. يتساءل الطبيب قبل إسدال الستار على أحداث الرواية: «موتنا، أم موتها؟»، والإجابة النهائية اليقينية الحاسمة غائبة لا سبيل إلى الوصول إليها. يدفع حامد ثمنًا فادحًا جراء استجابته لنداهة العودة بفعل الحنين، وتبقى القضية المحورية عابرة لأزمة الفرد، ذلك أنها تتطرق إلى المبارزة مع حاضر ومستقبل الصراع المعقد بين الشرق والغرب.
لمطالعة موقع ديالوج.. عبر الرابط التالي:




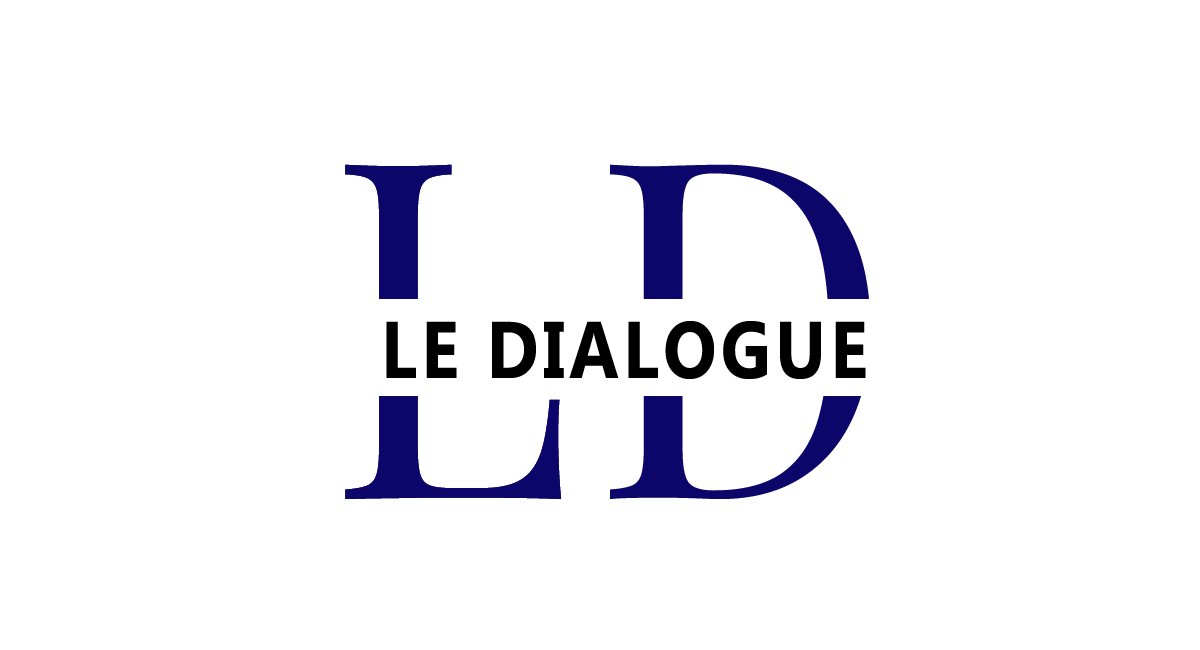 بالعربي
بالعربي
