
على مدارمشواره الإبداعي الذي استمر لعقود طويلة، تأثر إبداع الراحل الكبير صلاح عبدالصبور بأشكال عِدة، بدأ مع قراءاته المُتعددة التي تراوحت من شعر الصعاليك إلى شعر الحكمة، وخوضه في أفكار بعض أعلام الفكر الصوفي مثل أبو منصور الحلاج وبشر الحافي، وهما نفسهما اللذان استخدمهما في كتاباته لإظهار أفكاره وتصوراته في بعض القصائد والمسرحيات فيما بعد؛ كذلك اطلع على الشعر الرمزي الفرنسي والألماني عند بودلير وريلكه، والشعر الفلسفي الإنجليزي عند جون دون، ييتس، كيتس، وإليوت بصفة خاصة، وهو ما ظهر عندما ربط الكثيرين بين رائعة إليوت "جريمة قتل في الكاتدرائية" ورائعته "مأساة الحلاج".
كذلك فإن رحلة صلاح عبد الصبور لم تقتصر على الشعر فقط، ولكنه اقتحم من قبل عالم القصة القصيرة، ومن يمعن النظر في دواوين عبد الصبور الشعرية سوف يجد أن الأسلوب القصصي في شعره احتل مساحة كبيرة جدا عكست بالفعل حبه لفن القصة، لكن الشعر أخذه بعيدا عنها لأنه يحب تملك صاحبه ليكون أثيرا له ولا يرد أن يشاركه فنا آخر بل يستوعبه داخل دائرته ليعيد امتصاصه، وهو ما حدث بالفعل، فسرعان ما ودع كتابة القصة القصيرة ليخلص لتجربته الشعرية بشكل كامل. أصدر عبدالصبور العديد من المؤلفات، فصدرت له دواوين "أقول لكم"، "تأملات في زمن جريح"، "أحلام الفارس القديم"، "شجر الليل"، "الإبحار في الذاكرة "، كما كتب خمس مسرحيات شعرية هي "الأميرة تنتظر"، "مأساة الحلاج"، "بعد أن يموت الملك"، "مسافر ليل"، و"ليلى والمجنون"، وصدرت له عدة أعمال نثرية منها "حياتي في الشعر"، "أصوات العصر"، "ماذا يبقى منهم للتاريخ"، و"رحلة الضمير المصري".

مهمة الشعر ليست هي رؤية ما يراه البشر. لكن عبقرته تكمن في التقاط التفاصيل التي لا يراها سواه، وهو ما برع فيه صلاح عبد الصبور الذى كان مهموما بالتفاصيل وبرصدها داخل دواوينه الشعرية، وهو ما يظهر في قصيدته " شنق زهران: "إن زهران غلاما.. أمه سمراء والأب مولد.. وبعينيه وسامة.. وعلى الصدغ حمامة.. وعلى الزند أبو زيد سلامة". يقول الشاعر والناقد فخرى صالح إن عبد الصبور استطاع في ديوانيه "شنق زهران"، "والناس في بلادي" أن يقترب من تفاصيل الحياة اليومية للناس لإضفاء الشعرية على هذه الحياة التي لا يلتفت إليها الشعب، ويعدها موضوعًا غير شعري ويلحقه بعالم النثر. وفي سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية يحقن الشاعر قصيدته بما يتفوه به الناس وما يجري على ألسنتهم من أمثال وتعبيرات شعبية وكلام مكرور مستعاد وصفات نمطية، ويلجأ إلى التعبير المباشر بحيث تخلو القصيدة من الصور والاستعارات ويكتفي الشاعر بالتشبيه البسيط إذا أضطر إلى لغة التصوير والتعبير الشعري المألوف".
كما ظل عبد الصبور غارقا في التفاصيل اليومية، وهذا ظهر جليّا وبوضوح شديد في قصيدته "الحزن" التي كانت تمجد تفاصيل الحياة، والتي هوجمت في الوقت ذاته بأنها تنحدر بالقصيدة، ولكن "عبد الصبور" كان يؤمن أن الشاعر لا يمكن أن يكون منفصلا عن تفاصيل حياة البشر لذا ظل جريئًا في التعبير وسابحا ضد التيار، ومستعدا بشجاعة للوقوف في وجه النقد بهدوء شديد. وعلى الرغم من تحمس "عبد الصبور" للتفاصيل الصغيرة إلى أن العمق والتأمل لم يغب عن قصائده، وهو ما كان يؤكد أنه شاعر المفاتيح الكثيرة التي كانت تبحث بصدق عن قيمه الحرف الذى كابد من أجله الكثير، واستطاع بذكاء كبير عبر لغته أن يجعلها متنوعة ما بين قضايا متعددة.
وربما كانت رحلته مقرونة بالمحبة، إلا أنها لم تفارق الحزن، منذ انتقاله من الزقازيق للقاهرة، فلقد لاحظ أن الحزن يفترش طريقه فتأكد أنها فكرة تستقر في قلب كل مبدع يريد تغيير العالم بشكل صادق. هكذا تأثر صلاح عبدالصبور بالإيطالي لويجي بيرانديللو، وظهر ذلك واضحًا في مسرحيتي "ليلي والمجنون" و"الأميرة تنتظر"، عندما ظهرت فكرة المسرح داخل المسرح، كذلك اقترن اسم الراحل بالشاعر الإسباني لوركا، عندما قدّم المسرح المصري مسرحية "يرما"، والتي صاغ عبدالصبور الكثير منها شعرًا، كما ظهر تأثره بالشاعر الإسباني من خلال عناصر عديد بمسرحيات "الأميرة تنتظر"، "بعد أن يموت الملك"، ليلي والمجنون"؛ وتأثر بكُتّاب مسرح العبث، خاصة أوجين يونسكو، وهو ما بدا في مسرحيته "مسافر ليل"، فقد وجدهم جميعا يشاركونه فكرة الحزن، فأدرك أن الفكرة ليست مقتصرة عليه، ولكنها تسيطر على كل مبدع يريد أن يغير العالم ليرسمه من جديد بأنامله ليعانق مدينته الفاضلة، وهو ما جعله يئن داخل ذاته.
كذلك كان الحب مقترنا بالإبداع لدى الرجل، فشكَّل له الملتجئ الوحيد الذى هرب إليه ليكتب مأساته عن المصير والوجود الإنساني، فجاءت لغته طازجة ومحملة بالحنين لكل القيم النبيلة التي اندثرت، يقول الكاتب والناقد اللبناني عبده وازن عن تلك اللغة المميزة: "تنتمي لغة صلاح عبد الصبور الشعرية إلى تراث الحداثة مثله مثل بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي ونازك الملائكة وسواهم، إلا أن "شيئا" ما في شعره يظل عصيّا على حكم الزمن. "شيء" كالجمر الذي لا يخبو تحت الرماد". في الوقت نفسه، لم يستطع صلاح عبد الصبور أن يهرب من الحزن الدفين الذى مزق قلبه الرقيق، فعبر عنه في قصائده لكنه كره أن يلقبه النقاد بالشاعر الحزين. كان وفيا ولم يستخدم الفكرة لاستعطاف قلب القارئ ليتعاطف مع شعره، ولكنه وجد فيه مساحة شديدة من الإخلاص للتعبير عن أزمة الوجود الإنساني. لذا يظل يكتب عبر قصائده ليعالج تلك الأزمة التي تلازم رحلة الإنسان، وكلما تعالت نظره النقاد اليساريين له كشاعر حزين كان يرد عليهم: " يصفني نقادي بأني حزين، ويدينني بعضهم بحزني، طالبًا إبعادي عن مدينة المستقبل السعيدة بدعوى أني أفسد أحلامها وأمانيها، بما أبذره من بذور الشك في قدرتها على تجاوز واقعها المزهر إلى مستقبل أزهر، وقد ينسى هذا الكاتب أن الفنانين والفئران هم أكثر الكائنات استشعارا للخطر، ولكن الفئران حين تستشعر الخطر تعدو لتلقي بنفسها في البحر هرباً من السفينة الغارقة، أما الفنانون فإنهم يظلون يقرعون الأجراس، ويصرخون بملء الفم حتى ينقذوا السفينة أو يغرقوا معها". وعندما يتعاظم حنقه في دائرة الحزن يردد: "لست شاعراً حزيناً، ولكنى شاعر متألم، وذلك لأن الكون لا يعجبني ولأني أحمل بين جوانحي كما قال "شيلي" شهوة لإصلاح العالم".
نبض الفكر.. كيف يرى عبدالصبور الشعراء؟
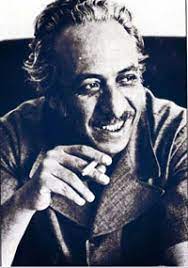
ومن يريد أن يعرف أوجهًا كثيرة للشاعر صلاح عبد الصبور فعليه بقراءة كتابه "نبض الفكر" ليعرف وجوهًا متعددة للشاعر، فهو المفكر والباحث عن تجارب شعراء سبقوه ليظهر وجه التشابه بينه وبينهم فيما يتعلق بالهم المشترك باتجاه المصير الإنساني. فقد تطرق إلى عدد كبير من الشعراء العرب من الماضي والحاضر، كما عرض لشخصيات ثقافية أجنبية مثل الروائي الروسي دستويفسكي والشاعر والمسرحي الإنجليزي شكسبير والشاعر الفرنسي سان جون برس والشاعر والناقد الإنجليزي الأمريكي ت.س إليوت، والشاعر والروائي اليوناني كازانتزاكيس وسواهم، وحاول أن يقدم في كتابه رؤيته لهؤلاء الشعراء بعيدا عن ضجة الانفعال بل بدا باحثا هادئا داخل الكتاب.
في الكتاب قام عبدالصبور بتحقير ذاته بالمقارنة بذات "المتنبي"، فظهرت صورة الأخير في كتابه بأنه شاعر يفوقه في البطولة والفحولة، كما كتب عن فتنة أبى العلاء بالمتنبي والتي كان يشاركه تلك الفتنة واصفا شخصيته القلقة بجملة بديعة: "كأن الريح تحته يصرفها يمينا وشمالا"، بل يضيف: "إن للمتنبي فتنة كفتنة الحب الأول"؛ ثم ينتقل إلى أبي حيان التوحيدي الذى أقدم على حرق كتبه في أواخر أيامه ويصفها: "من أوجع الصفحات في التاريخ"، ولكنه يقول: "ومن حُسن حظنا أن أبا حيان حين أحرق كتبه لم يحرق إلا ما تأخر زمنه منها، أي ما كتبه في العشرين عامًا الأخيرة من عمره. وكتبه في معظمها شبيه باليوميات، وفيها كثير من أدب الاعتراف، فكتابه الرائع "الإمتاع والمؤانسة" هو ثمرة أربعين ليلة من السمر كان فيها أبو حيان ينادم أحد وزراء عصره ويفيده علم الأدب ومذاهب الفكر. بينما يجري كتابه "الإشارات الإلهية" مجرى الخواطر والتأملات الصوفية والخلقية. أما كتابه «مثالب الوزيرين» فهو أشبه بمقالة طويلة في هجاء الصاحب بن عباد وابن العميد وحكاية ما كان بينهما من نوادر وتغامز وجفوة.
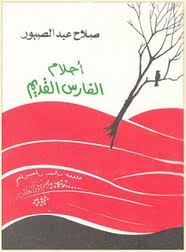
الصحفي المُحافظ
"إن الذين يمارسون لحظة استمرار الحياة دون زواج، إما عابثون أو ثوار، أما العابثون فهم عادة لا يحترمون أي قيمة اجتماعية حتى ولو ثبت لهم صلاحيتها، أما الثوار الذين يبالغون في الشعور بذواتهم.. ويغفلون عن الإحساس بالمجتمع، ويناصبونه العداء مدفوعين بالنوايا الطيبة والرغبة الصادقة في تغييره فإنهم يستحقون الشفقة".
إذا ما تجولنا في مقالات عبد الصبور حول الحب والحياة والفن، والتي استمرت منذ عام 1957، وحتى عام 1975 - قبيل تولي عبد الصبور منصب المستشار الثقافي في سفارة مصر بالهند كان حريصا على تجميع المقالات ذات الموضوعات المتقاربة في كتب صغيرة، فصدر له "على مشارف الخمسين، وتبقى الكلمة، حياتي في الشعر، أصوات العصر، ماذا يبقى منهم للتاريخ، رحلة الضمير المصري، حتى نقهر الموت، قراءة جديدة لشعرنا القديم، ورحلة على الورق".
وبالحديث عن "أقول لكم" فهو ينقسم إلى ثلاثة أبواب؛ أولها "عن الحب"، الذي أظهر عبد الصبور كصحفي محافظ، يدافع عن الأعراف في مواجهة ثورات الشباب وضد ما اسماه بالتقليد الغربي، ويسرد من المواقف ما يُعزز نظرته التي تؤكد مسئولية المرأة عن قسم كبير مما لحق بالمجتمع من أوبئة، بل يُصرح في أحد المواضع بأنه يرى أغلب النساء العاملات "ما نزلن من بيوتهن إلا لاصطياد رجل، والحب في سطوره إن لم يكن في إطار اجتماعي مقبول فهو لهو".
و"عن الحياة" فقد سجّل عبد الصبور كل ما يقع تحت يده من قضايا اجتماعية، سواء في مصر أو خارجها، وتحدث في معظم مقالاته عن الحرية من وجهة نظره، حرية الاعتقاد، حرية المواطنة، وكان ناقمًا على التمييز العنصري، فدافع عن حقوق السود في أمريكا، وهاجم فساد الإعلام في العالم أجمع، وسجّل ما أعجبه أو صادفه بين قراءاته.
و "عن الحب والفن"، يلتفت عبد الصبور إلى علاقة الفن بالمجتمع، مُنددًا باللجان الفنية التي تُبيح غناء كلمات مثل "يا جارحني، يا مسهرني"، رغم أنه كشاعر يُنادي بحرية الكلمة، بل ووقف بالفعل في وجه قالب الشعر المحافظ لصالح قصيدة التفعيلة، كما كتب عن فساد الإدارات الثقافية الحكومية في الإذاعة وغيرها، وكان يُغرق بنقده كل كبيرة وصغيرة بلسان الصحفي الجاد المحافظ لا بلسان الشاعر الثائر.
الحلاج ومجنون ليلى والبحث عن خلاص

عند قراءة مسرحية "مأساة الحلاج"، وهي واحدة من النصوص التي تحتل صدارة المسرحيات الشعرية في تاريخ الشعر العربي، تتأكد موهبة صلاح عبد الصبور الفذة وهو يعيد لنا صلب "الحلاج" شعريا ليعيد لنا صفحات قاسية في التاريخ ارتكبت بحق المبدعين والشعراء ليبرز مأساتهم، وعند قراءة المسرحية سنجد أن الشاعر اختار مصير الحلاج الذى يتشابه مع مصيره الإنساني ليبدع لنا رائعة تضاف إلى مشواره الشعرى لتزيده ثراءً.
مسرحية "مأساة الحلاج" تكشف عن القدرات الفنية العالية للشاعر وهو يهرب إلى التاريخ ليبدي رأيه في قضايا معاصرة صاحبته وجوده ويعالجها بعقل رصين ليعبر عن مأساة الحلاج والتي تمثلت في عجزه الفادح عن تحويل الكلمة إلى فعل، ليُعانق مأساة الشاعر الشخصية، فلقد أصر على استدعاء شخصية تاريخية ليقوم بصلبه على جذع شجرة وكأنه يعانق الموت مع الحياة ثم يمر عليه كل من الواعظ والفلاح والتاجر، الأخير يريد أن يعرف قصته حتى يحكيها لزوجته في المساء حين يعود ، والفلاح فضولي بطبعه ، أما الواعظ فيريد تعميق التقوى في قلوب الخلق، فنراه يبحث عن موعظة وعبرة يلقيها في خطبة الجمعة. ينظر "الحلاج" إلى كل تلك النماذج التي تمر عليه، ويبدأ في سرد مأساته، فرغم كل هذا الزخم حوله إلا أنه يشعر بالغربة والوحدة..
وفي إبداع آخر، تعتبر مسرحية " ليلى والمجنون" من أهم المسرحيات التي أبرزت علاقة السلطة بالمثقف حاول فيها التمرد على النظام السياسي. حيث جعل من بطلها "سعيد" نموذجا للمناضل الوطني المصري الذى يتمرد على السلطة قبل ثورة 1952 ويبدأ الشاعر في الوصف الجسماني لملامح سعيد على لسان ليلى التي تحب سعيد عبر المسرحية وهو يكافح ضد السلطة ولكنه يتحول في النهاية إلى شخص مهزوم؛ بينما لا تسأم ليلى من حبه ترى فيه مناضلًا سياسيًا وتعشقه، ولكنه لا تعرف أن به خراب نفسى كبير جراء فشله في التمرد على النظام. تذهب إلي شقته بحثًا عن الحب فلا تجد عنده إلا التآكل، والخراب النفسي، وتذكارات الطفولة السوداء.



