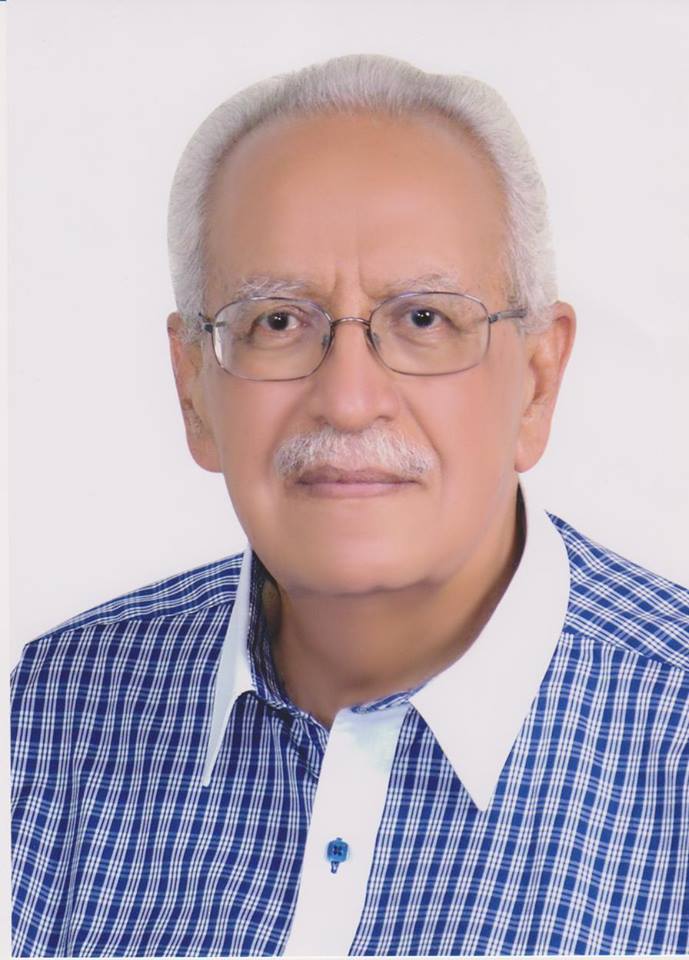[email protected]
يحرص الخطاب السياسي الرسمي في بلادنا، من حين لآخر، على تأكيد فكرة أن “,”الدين أمر بين الإنسان وربه.. وأن المصريين بمسلميهم وأقباطهم شركاء وطن واحد ..“,”.
ولعل ذلك الحرص يعيد إلى الذاكرة الوطنية ملابسات اختيار سعد زغلول لشعار “,”الدين لله والوطن للجميع“,”؛ ليكون عنوانًا لثورة المصريين الوطنية عام 1919؛ ورغم أن الأمة قد أجمعت والتفت حول هذا الشعار آنذاك؛ فلا بد لنا من التسليم بأنه قد طرأت علينا تغيرات فكرية وسياسية واجتماعية، بل ودولية، تجعل من الضروري إعادة النظر فيما طرأ على دلالة ذلك الشعار من تغيرات؛ بحيث أصبحنا حيال مواقف متعارضة حيال القبول بهذا الشعار وحيال تأويلاته أيضًا.
لقد ظل ذلك الشعار فعالاً منذ ثورة 1919، في ظل دولة مصرية لم تخل دساتيرها المتعاقبة –اللهم إلا دستور الجمهورية العربية المتحدة- من نص يشير إلى أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، ولم يبرز طيلة تلك السنوات تناقض بين شعار ثورة 1919 وبين تأويل “,”وسطي إسلامي“,” ارتضاه الشعب وعشنا جميعًا في كنفه، إلى أن برز تناقض حاد بين نظام يوليو 1952 وجماعة الإخوان المسلمين.
ورغم تصاعد حدة الاتهامات المتبادلة، سواء بالعلمانية والإلحاد أو بالإرهاب والعنف؛ ورغم تعرض أعضاء الجماعة لموجات من التعذيب البشع، ورغم إقدام أعضاء الجماعة على ممارسة أشكال من العنف، فإن شيئًا من ذلك الصخب لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن كلا الطرفين كانا يتصارعان على أرضية فكرية واحدة، هي الأرضية الإسلامية: كلاهما يزايد على الآخر معلنًا أنه الممثل الشرعي للإسلام “,”الصحيح“,”، ولعل الأمر لم يختلف كثيرًا من هذه الناحية حتى الآن.
لقد طالب الإخوان المسلمون بالمشاركة في السلطة، وبأن ترجع إليهم سلطة يوليو قبل اتخاذها لقراراتها لكفالة المرجعية الدينية الإسلامية لتلك القرارات؛ ولم يعترض قادة يوليو على تلك المقترحات من حيث المبدأ، فلم يعترضوا على مشاركة الإخوان المسلمين في الوزارة، ولا في ضرورة استناد قراراتهم السياسية لمرجعية دينية إسلامية؛ بل كان الاعتراض على حق الإخوان في تحديد ممثليهم المشاركين في الوزارة، وحق قادة يوليو في اختيار المؤسسة التي تمثل بالنسبة لهم المرجعية الدينية.
ولذلك مضى قادة يوليو يزايدون على إسلامية جماعة الإخوان، فشهدت فترة حكم عبد الناصر إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي (1954م)، وإنشاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (1960م) وإنشاء إذاعة القرآن الكريم (1964م)، وإنشاء جامعة الأزهر (1961م)، كما توسعت في إنشاء المعاهد الأزهرية، وتزايدت أعداد المساجد من أحد عشر ألف مسجد قبل الثورة، إلى واحد عشرين ألف مسجد عام 1970، أي أنه تم بناء ما يعادل عدد المساجد التي بنيت في مصر منذ الفتح الإسلامي وحتى عهد عبد الناصر.
وأصبحنا منذ ذلك التاريخ، وعلى المستوى الجماهيري، حيال مجموعتين من المرجعيات الإسلامية: مجموعة “,”رسمية“,” تتمثل في مشيخة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء؛ ومجموعة “,”غير رسمية“,”، تتمثل في الإخوان المسلمين، وما عرف –بعد ذلك في عصر السادات- بالجماعات الإسلامية على تنوعها.
ولم يكن الرئيس محمد أنور السادات في حاجة لبذل جهد كبير ليكرس للدولة عنوانًا جديدًا هو “,”دولة العلم والإيمان“,”، وليعلن ذلك العنوان رسميًّا في كلمته أمام وفود مؤتمر علماء المسلمين في 14 سبتمبر 1972 داعيًا لضرورة “,”أن نستحضر كل مقومات عقيدتنا وتاريخنا ونضالنا وكفاحنا في أسلوب نعني به دولة العلم والإيمان“,”.
وفيما يبدو فإن السبعينيات تحتل موقعًا خاصًّا في موضوع الوحدة الوطنية؛ فقد شهد شهر سبتمبر 1972 بداية مسلسل ما عرف باسم حوادث الفتنة الطائفية، التي كان أبرزها أحداث الخانكة، يومي 6 نوفمبر و12 نوفمبر 1972، كما شهد صدور قانون حماية الوحدة الوطنية في 27 سبتمبر 1972.
وكرّت السنون، وما زلنا جميعًا في إطار المفاضلة بين التأويلات والقراءات المتعددة للإسلام؛ ورغم ذلك ترتفع أصوات تهاجم شبحًا تطلق عليه العلمانية الملحدة، لا وجود له في بلادنا، فإذا عز الإمساك بذلك الشبح متلبسًا لجأت تلك الأصوات للتأويل؛ لتدعي أنها أمسكت به متخفيًا في عباءة إسلامية!