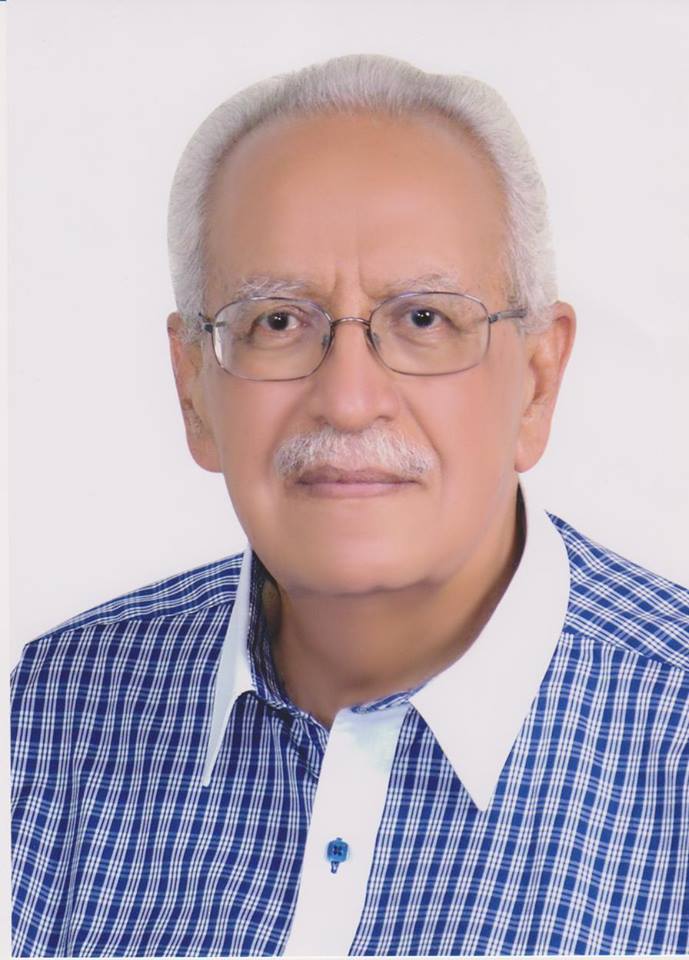[email protected]
ثمة حقيقة ثابتة يؤكدها تراث مدارس العلاج النفسي، فضلاً عن علم النفس السياسي، وقبل ذلك كله دروس التاريخ: لم يعرف التاريخ البشري من استطاع أن يقنع الجميع برؤيته، مهما كانت مشروعية ونبل مقاصده وأهدافه، وأن قدرة الفرد والجماعة -على حد سواء- على الحركة الرشيدة يتوقف على القدرة على دفع ثمن الاختيارات، وأن الأمر في النهاية يحسمه اتفاق وتعارض المصالح.
تعرفت يومًا على رجل فاضل كان مسئولاً بحكم وظيفته عن عدد من العاملين في إحدى المؤسسات، وكان يسعى جاهدًا لكسب رضا الجميع، فضلاً عن رضا رؤسائه أيضًا، وسرعان ما اصطدم بحقيقة أن المصالح تتعارض، وأنه إذا ما قرر أمرًا فإنه بالضرورة سوف يحظى برضا البعض ولكنه سوف يُغضب البعض الآخر. ونظرًا لأنه لم يكن بقادر –بحكم تكوينه النفسي- أن يتحمل مواجهة غضب البعض، فقد آثر اختيار طريق بدا له مأمونًا: أن يوحي لكل معترض -ولكن على انفراد- أنه في صفه، ولا بأس من أن يصدر قرارًا جديدًا لإرضائه، حتى لو كان متناقضًا مع قرار سبق له إصداره، ثم يكرر ذلك كلما واجه غضبًا من محتج جديد؛ فإذا ما اضطر للدفاع علنًا عن مجمل قراراته، لم تصدر عنه سوى جمل ناقصة، وتبريرات متهاوية، وغمغمات مغلفة بالخجل لا تكاد تفصح عن شيء، وكان طبيعيًّا والأمر كذلك أن يجترئ عليه المرءوسون والرؤساء.
إن سعي المرء لكسب الصداقات أمر واجب، وقد تنجح سياسة “,”محاولة كسب الجميع“,” إذا كنا بصدد جماعة صغيرة، كالأسرة مثلاً، أو “,”شلة“,” من الأصدقاء، حيث يمكن توحيدها على هدف واحد مقابل قبول أفرادها بقدر معقول من التأجيل أو حتى التنازل عن بعض أهدافهم الشخصية العاجلة، ولكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق إذا ما كنا نتحدث عن الأهداف السياسية أو الاقتصادية لمؤسسة أو لحزب أو لدولة؛ حيث تحل “,”التحالفات والمحاور“,” محل “,”الإجماع“,”، وتحل “,”المصالح العملية“,” محل “,”الصداقات الرومانسية“,”، رغم ولع رجال السياسة كثيرًا بالحديث عن علاقات “,”الصداقة التاريخية“,” بين الدول والشعوب.
يستحيل على مؤسسة اقتصادية مثلاً أن تحظى بدعم منافسيها، كما يستحيل على حزب أن يحظى بتأييد “,”الجميع“,”؛ فذلك أمر يتنافى مع طبيعة الأمور؛ ولذلك فإن الحصول على ما يقرب من 100% من أصوات الناخبين في أية انتخابات يعد أمرًا مثيرًا للسخرية، ويستحيل كذلك على دولة أن تحظى بتأييد دول العالم قاطبة إلا في حالة واحدة تكاد تكون مستحيلة في عالم اليوم: أن تتبنى سياسة صاحبنا الذي أشرنا إليه في مستهل المقال، بألا تحدد أهدافها الحقيقية، وأن تلونها حسب مقتضى الحال، وقد كانت مثل هذه “,”الإستراتيجية“,” دومًا قصيرة النظر محدودة الدوام، وأصبحت اليوم في حكم الوهم المستحيل في عصر الانفجار الإعلامي؛ حيث لم يعد ممكنًا عزل الخطاب الداخلي عن الخطاب الخارجي، أو عزل الخطاب الموجه لدولة معينة عن ذلك الموجه لدولة أخرى.
ولم يعد هناك مجال كبير لهمسات في غرف مغلقة، أو لأحاديث تحمل مضمونًا يتغير بتغير اللغة، وبمكان محطة البث، وبهوية المخاطب. ويصبح طبيعيًّا لمن يسعى لكسب الجميع بذلك الأسلوب أن ينتابه الفزع إذا ما أجبر على الإعلان عن قراراته والإفصاح عن أهدافه وتحالفاته بوضوح، حتى لو كانت مشروعة من وجهة نظره، ويصبح دفاعه عنها مشوبًا بالخجل والتلعثم ومحاولة التلاعب بالألفاظ، متعرضًا بذلك لتهجم الأعداء، الذين يبتزونه ويزايدون عليه؛ لكشف المزيد مما يخفيه ويسعى لستره، وهجوم الحلفاء، الذين يرون أنه يخذلهم ويتخلى عنهم، وفي النهاية يكون مهددًا بخسران الجميع.
إن أهداف وسياسات الدول في هذا العالم تتباين وتتعارض وفقًا للمصالح؛ ومن ثم فعلى كل دولة أن تحدد أهدافها أولاً، وأن تحسب جيدًا قدراتها الواقعية، وأن تدرس تفاصيل العالم الواقعي حولها، ثم تقيم تحالفاتها مع من لا تتعارض مصالحهم مع مصالحها، وأن تدفع الثمن الحتمي لتلك التحالفات متمثلاً في تحمل غضب الآخرين وعدائهم، إلى أن تتغير خريطة المصالح فتتغير تبعًا لها طبيعة التحالفات.
ولا يعني ذلك بحال أن تكون تلك التحالفات عدوانية متقاتلة بالضرورة؛ بل على العكس، فإن إعلان تحالفات واضحة الحدود والأهداف، والدفاع عنها دائمًا بوضوح ودون خجل أو تردد أو تلعثم، يكون مدعاة لحوار واضح بين الحلفاء، ولحوار واضح أيضًا –رغم سخونته- مع التحالفات الأخرى ذات الأهداف المعارضة أو حتى المناقضة؛ في حين أن الغموض يخلق حافزًا لدى الجميع للضغط بكل الوسائل بهدف حسم هذا الغموض في صالح طرف أو آخر.
خلاصة القول إنه من المستحيل أن نتبنى سياسة نراها ضرورية للحفاظ على أمننا الوطني، بدءًا من الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل، والسعي لتدمير الأنفاق تحت حدودنا مع قطاع غزة، وتأييد الحق الفلسطيني في عودة اللاجئين وإقامة دولة عاصمتها القدس على حدود 67، ونتوقع أن تلقى تلك السياسة تأييدًا من الجميع، بل لا سبيل للهروب من مواجهة غضب ورفض وتهجم ومزايدات من يتبنون أهدافًا وسياسات مناقضة.. وهم كثر.