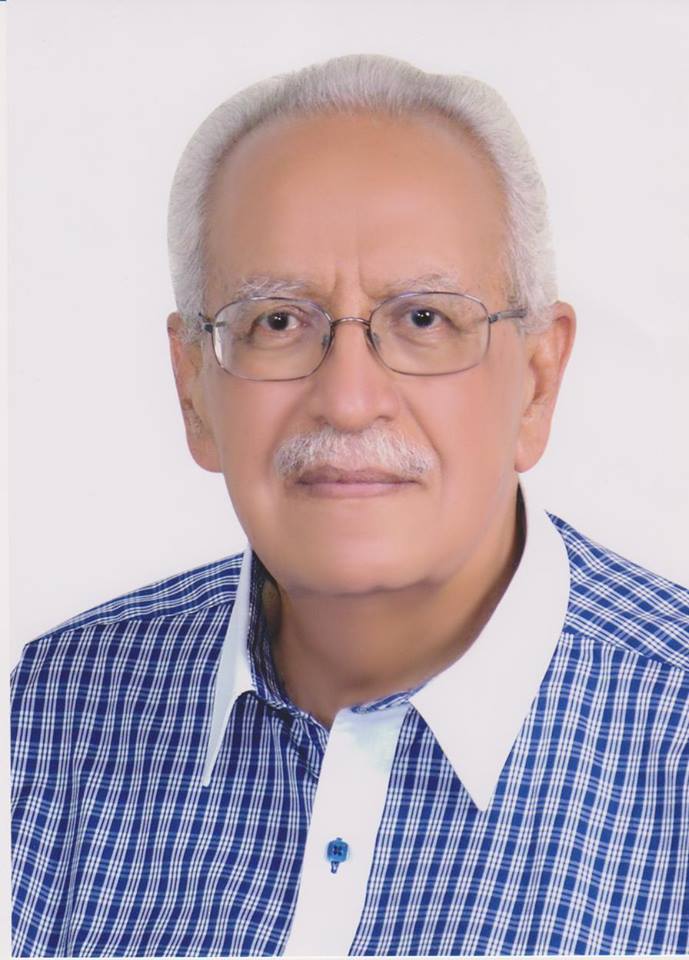نشهد في كثير من مؤسساتنا العلمية والإعلامية والسياسية جدلا حول العلاقة بين الدين والعلم والسياسة: الدين وكيف نحفظه ونحافظ عليه، والعلم وكيف نأخذ بأسبابه، وقراراتنا السياسية المصيرية ومعايير اتخاذها، و ذلك في عصر تتسارع فيه المنجزات العلمية وتتصاعد فيه الصحوة الدينية، وتتعقد فيه المشكلات السياسية إلى حدّ ينذر بأننا على أبواب تغييرات يراد بها ألا تقف عند حدود السياسة، بل أن تتجاوزها إلى محاولة تعديل الجغرافيا، بل والتاريخ أيضا.
سوف يمضي هذا الصخب وما يصاحبه من حراك إلى غايته، شأن بلادنا في ذلك شأن غيرها، ولكن مكمن الخطورة فيما نرى أننا خلال هذا الصخب تختلط لدينا الأمور: قد نحكم على القضايا العلمية بمعايير سياسية أو دينية فيتخلف العلم وتنتكس الحرية، وقد نحتكم في قضايا الدين إلى معايير العلم أو نخضعها لمقتضيات السياسة فنفقد الدين قدسيته في الحالتين ونفتح الطريق واسعا للانتهازية السياسية دون أن يكسب العلم شيئا.
أمثلة ذلك الخلط عديدة تفوق الحصر، لعل أشدها خطرا:
• محاولة تفسير النصوص الدينية المقدسة بما يبدو لنا متفقا مع مستحدثات العلم ومن ثم رفض ما لا يتفق مع تلك التفسيرات من حقائق علمية.
• محاولة التنقيب بحثا عن تأويلات للنصوص الدينية المقدسة تتفق مع التوجهات السياسية للسلطة أو لمناوئيها.
• تغليف توجهات الجماعات السياسية بغلالة علمية زائفة في محاولة للإيحاء باتفاقها مع مستحدثات العلم خاصة في المجالات الاجتماعية.
ويستند ذلك الخلط على فكرة مؤداها أن ثمة مرجعية واحدة ينبغي أن تحدد مواقفنا حيال ما نتلقاه في كل مجالات الحياة، وهو ما سنحاول مناقشته في السطور التالية لعلنا نسهم بذلك في إنارة الطريق أمام الساعين للتقدم والتصدي لما يراد بنا وبأوطاننا.
لعلّه ممّا يستوقف النظر أن ثمة تشابها بين مجالي المعرفة الدينية والعلمية، يتجلّى في أمرين أساسيين:
* الأمر الأول: أن قبول حقائق العلم والدين لا يستند إلى رأي غالبية الجمهور، ولعل ذلك يتفق مع حقيقة أن أصحاب الاكتشاف العلمي لا يكونون في البداية سوى قلة أو حتى فردا واحدا يأتي بجديد يختلف عما هو معروف، وكذلك فإن أية رسالة دينية لا تحظى في البداية سوى بقبول أقلية محدودة تواجه أغلبية سائدة.
* الأمر الثاني: أن ثمة اتفاقا على الطابع العام العالمي للحقائق العلمية والدينية، فالعلم بحكم تعريفه إنما هو علم بما هو عام، كذلك فإن مضمون الخطاب الديني لا ينصرف إلى قوم بعينهم في حقبة تاريخية معينة، بل يتجه إلى البشر جميعا في كل زمان ومكان.
وغنيّ عن البيان أن القاعدة المعتمدة في مجال السياسة تختلف عن ذلك تماما، إذ تقوم على وجوب انصياع الجماعة لما يحظى بموافقة أغلبيتها، ولعل شاعر النيل حافظ إبراهيم قد عبر عن ذلك خير تعبير حين قال:
رأي الجماعة لا تشقى البلاد به.. رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها
ورغم الاتفاق الذي أشرنا إليه بين مجالي الدين والعلم، فإنهما يقفان على طرفي نقيض من حيث المعيار المقبول للحكم بصحة أية قضية مطروحة للنقاش، وطبيعة الموقف من أصحاب الرأي المخالف:
أولا:
التجربة العلمية المضبوطة هي المرجع الأوحد لقبول العلماء أو رفضهم لأية فكرة، في حين أن الاحتكام لتلك التجربة لا يعول عليه كثيرا في المجال الديني.
ثانيا:
لا يعول رجال العلم كثيرا على الثقة في سمعة مصادر المعلومات أو مكانتهم الاجتماعية أو حتى نقائهم الأخلاقي، في حين أن تصديق الرسالات الدينية قد انطلق أساسا من مصداقية أصحاب الرسالات لدى من آمنوا بهم.
ثالثا:
القانون العلمي قابل دوما للمراجعة والنقض، بل إن قابليته للتفنيد تُعدّ من شروط صياغته، في حين أن النص الديني المقدس ثابت أزلي أبدي غير قابل لتنقيح أو مراجعة، ومن ثم تنحصر المراجعات في مجال التأويلات التي تحتل الثقة في صلاح وعلم أصحابها مكانة متميزة في المفاضلة بينها.
رابعا:
من ينقض قانونا علميا بأسلوب تجريبي يلقي من الجماعة العلمية كل التقدير والاحترام مهما علت مكانة صاحب القانون القديم، وأيا كان صاحب الاكتشاف الجديد، أما في مجال الجماعة الدينية فإن ناقض النص المقدس يعتبر مذنبا يجب عقابه بشكل ما، حماية لغيره من الأفكار المضللة، ما لم يعترف بخطيئته ويرجع عنها.
خلاصة القول:
إن حقائق علم النفس وغيره من العلوم الاجتماعية، تؤكد أنه لا سبيل لوحدة أو توحيد مرجعية قبول الحقيقة، للمرء أن يكون متدينا سياسيا عالما، شريطة أن يعامل حقائق كل مجال تبعا لمعايير ذلك المجال، أما بالنسبة للدول والجماعات الكبرى فإن الأمر يصبح أشد خطورة، ولسنا في حاجة للإشارة إلى ما تفيض به وقائع التاريخ القديم والحديث، بل والمعاصر، من ثمن باهظ دفعه ويدفعه البشر ثمنا لمحاولة مثل ذلك الالتزام المستحيل.