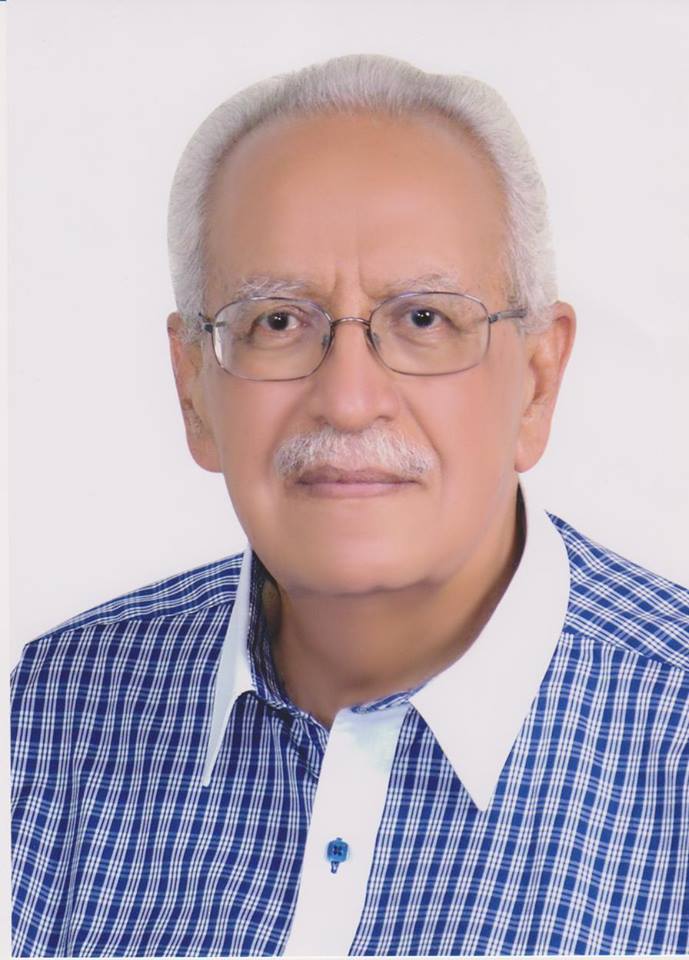[email protected]
كنا نلقن أطفالنا منذ البداية عددًا هاما من الدروس، في مقدمتها أن “,”صاحب القرار“,” ليس ملزَمًا بتقديم تفسير لقراراته. إنه ليس مطالبًا بالإجابة على السؤال “,”لماذا؟“,”، وأن مجرد استخدام هذا الأسلوب الاستفهامي قد يعتبر في حد ذاته إهانة لصاحب القرار، خاصة إذا ما تعلق الأمر بقرار يبدو ظالمًا بصورة أو بأخرى. إننا ندرب الطفل -بل والكبير- على أن المطالبة بالشفافية والتفسير تعد نوعًا من الاجتراء على صاحب القرار. وبدا كما لو أن هذا المفهوم قد ترسخ لدى الجميع، سواء من يتخذون القرارات أو من تُتخذ حيالهم. والأمثلة تفوق الحصر.
كثيرًا ما كنا نعتبر مجرد التظلم، أي التساؤل عن مبرر العقاب أو الحرمان أو عدم المساواة، إهانة موجهة لصاحب القرار. كثيرًا ما شاهدنا راشدًا يعاقب طفلاً، أو رئيسًا يعاقب مرءوسًا، فإذا ما تساءل الطفل أو المرءوس عن السبب فيما يعتبره ظلمًا، أو أبدى عدم اقتناعه بالمبررات المطروحة، استشاط الكبير غضبًا، وازداد شدة في عقابه، وتناثرت منه تعبيرات من نوع: “,”كيف تجرؤ على الرد علي؟“,”.
أما إذا ما جرؤ الطفل، أو المرءوس، على طلب تفسير ما يراه تمييزًا في المعاملة؛ فإنها الطامة الكبرى، وسرعان ما تتردد العبارة الشهيرة: “,”لا أحب أن أسمع كلمة إشمعنى“,”. لقد دخلت تلك الكلمة، الأقرب للفصحى والتي تعني حرفيًّا “,”ما معنى“,”، دخلت في قائمة التعبيرات غير المهذبة، بل التي يحظر استخدامها اجتماعيًّا في حوار المظلوم- الظالم.
إن انتشار التساؤل عن الأسباب يعد بمثابة المحرك لتقدم المجتمعات علميًّا واجتماعيًّا. لقد كانت التساؤلات المندهشة، حيال أمور تبدو طبيعية معتادة، بمثابة الومضة الأولى بالنسبة للعديد من أعظم الاكتشافات العلمية، التي ننعم باستخدام تطبيقاتها التكنولوجية في عالم اليوم.
كذلك فإن التساؤل عن الأسباب، وخاصة أسباب الحرمان، كان عبر التاريخ بمثابة القوة الدافعة للتقدم الاجتماعي؛ حيث يمثل الشرط الأساسي لاكتشاف المظالم والوعي بها؛ ومن ثم البحث عن سبيل لتجاوزها.
ولقد ظلت مجتمعاتنا تضيق بالشفافية، وأصبحت الظاهرة أشد خطرًا حين انتشرت لدى من تُتخذ حيالهم القرارات، ولم تعد قاصرة على من يتخذونها. وأخذ استخدامنا لأداة الاستفهام “,”لماذا“,” يزداد خفوتًا، ووصلت إدانة استخدامها إلى حد التجريم، بل التحريم، خاصة إذا ما اقتربت من نطاق المحرمات الثلاثة الشهيرة: الجنس، والدين، وكذلك السياسة بمفهومها الواسع.
وقد يبدو للوهلة الأولى أن حصول المحروم، أو المظلوم، على إجابة تفسر السبب لما يشعر به، أمر مفيد للمظلومين الذين يعانون حرمانًا فحسب، وحقيقة الأمر أن مثل تلك الشفافية أو المكاشفة تكون مفيدة للجميع، كأفراد وكمجتمع على حد سواء؛ فقد لا يكون الظالم واعيًا بظلمه فيتراجع عنه -عند اكتشافه- تائبًا معتذرًا، فضلاً عن أنه قد يتبين أسباب ارتكابه لذلك الظلم. وفي بعض الحالات قد يتبين المحروم أو المظلوم أن حرمانه أو إخفاقه كان له ما يبرره؛ ومن ثم يتحمل مسئوليته عنه، ويعدل بالتالي من سلوكه الخاطئ.
ورغم ذلك فقد مضينا طويلاً في طريق تجريم وتحريم التساؤل عن الأسباب، إلى أن فاض الكيل وانفجرت أحداث 25 يناير 2011؛ لتطيح بكل شيء، وتزيح الغطاء عن المرجل لتتدافع أمواج من التساؤلات التي طال كبتها.
واللافت للنظر أن من بيدهم مقاليد الأمور الآن يتوهمون أنه ما زال ممكنًا العودة إلى ما كان يبدو استقرارًا في الزمن القديم، واستعادة النموذج الذي هوى.. نموذج الحاكم الذي يعرف ما لا نعرف، و يومئ ولا يفصح، ويتخذ من القرارات المفاجئة ما لا يجد نفسه ملزمًا بمكاشفتنا بأسبابها. ويتناسى هؤلاء أن الجماهير قد تغيرت، وأصبح حق التساؤل فيما كان محرمًّا قوتًا يوميًّا لها، وأن محاولة إعادتها للقمقم بالغة الصعوبة.