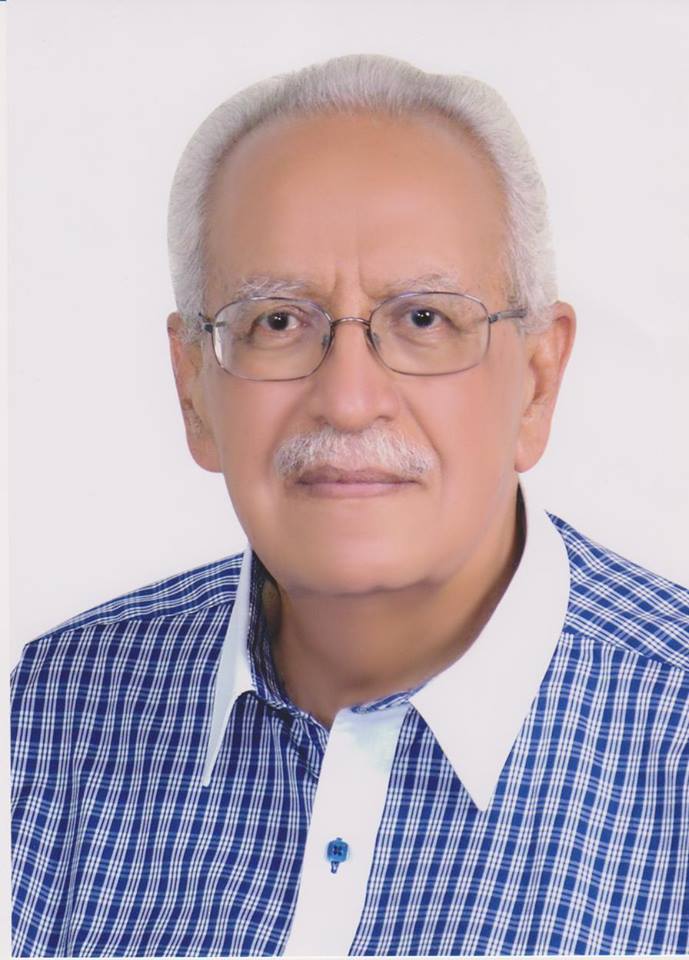حين أتابع أحداث جرائم العنف السياسى الجارية، أيا كانت هوية أو انتماءات مرتكبيها، تتجسد أمامى ملامح صورة قاتمة لما وصلنا إليه. أقلية بحكم العدد تمارس أبشع درجات العنف. وأغلبية بحكم العدد أيضًا تلتزم بأقصى درجات السلبية. قد يوجد نفر هنا أو هناك يتخذ موقفًا إيجابيًا مساندًا أو حتى معارضًا. ولكن تظل الصورة فى مجملها على ما هى عليه.
وليس من شك فى أن مواجهة ما يجرى بأقصى درجات الشدة والحكمة أمر لا يختلف عليه أحد. ولا شك، كذلك فى أن تقصى الجذور التاريخية الاجتماعية الاقتصادية السياسية الفكرية لذلك الذى يجرى، أمر لازم أيضا لأى معالجة جادة. ولا بأس كذلك إذا ما لزم الأمر من محاولة تحديد على عاتق من تقع مسئولية ما حدث، ولكن تبقى بعد ذلك بل قبل ذلك مهمة عاجلة ينبغى البدء فى انجازها الآن وفورًا، فلقد تأخرت طويلًا، وفضلًا عن صعوبتها، فإن إنجازها يتطلب وقتًا، والأحداث تتسارع من حولنا، إنها مهمة محاولة استنقاذ الأجيال القادمة من أطفالنا لكيلا يتكرر ما حدث، ولا أقول لكيلا يستمر.
إن أولئك الذين يمارسون العنف الآن، كانوا فى غالبيتهم أطفالًا منذ زمن قريب، بل لعل بعضهم مازال كذلك بمعنى ما. وإذا ما استمرت أساليب تنشئتنا لأطفالنا على ما هى عليه، فإن الأجيال القادمة لن تختلف كثيرًا عن جيل ممارسى العنف الراهن، إذا لم تكن أسوا. لقد كان هذا الجيل نتاجًا لعمليات التنشئة الاجتماعية لأطفالنا والتى مارسناها كأمهات وآباء، كمربين وتربويين، كإعلاميين ومسئولين، مارسناها فى بيوتنا، ومدارسنا، ومساجدنا وكنائسنا ونوادينا ومكاتبنا. مارستها صحافتنا وإذاعتنا وتليفزيوننا. مارستها السلطة والمعارضة. مارسناها جميعًا دون استثناء. مارسناها بالفعل ومن لم يستطع مارسها بالقول، ومن لم يستطع مارسها بالصمت ولعلة الأشد خطرًا.
لقد تكاتفنا جميعًا لدفع أطفالنا إلى ما يتنافى مع فطرتهم التلقائية الطبيعية. الطفل بفطرته محاور، دفعناه إلى الصمت، الطفل بفطرته متسائل، دفعناه إلى تقبل التلقين. الطفل بفطرته مفاوض فعال، دفعناه إلى الجمود العدواني. الطفل بفطرته تلقائي، دفعناه إلى التصنع والمداهنة. الطفل بفطرته تلقائي، دفعناه إلى التصنع والمداهنة. الطفل بفطرته ميال للمشاركة، دفعناه إلى الجمود العدواني. الطفل بفطرته تلقائي، دفعناه إلى التصنع والمداهنة. الطفل بفطرته ميال للمشاركة، دفعناه إلى الانطواء والتوجس من الآخرين. كنا فى ذلك كله نسبح ضد التيار، تيار الفطرة السليمة.
وللحقيقة فإن نوايانا كانت ومازالت طيبة، وحبنا لأطفالنا حقيقة لا يمارى فيها أحد. ولكن ذلك وحده لا يكفى، لقد أدت تنشئتنا لأطفالنا إلى حيث لا يجد الطفل أمامه لمواجهة مواقف الحياة إلا واحدًا من سبيلين لا ثالث لهما: إما التصدى بالعنف لإزالة ما يحول ببينه وبين ما يريد، ذلك إذا ما استطاع فإذا لم يستطع وكانت العقبة أقوى من إمكاناته، لم يعد أمامه إلا السبيل الآخر وهو الاستسلام دون شروط هجرة أو مرض نفسى أو انطفاء سلبي.
لقد أردنا لأطفالنا القوة فى عالم يسوده الأقوياء، وأردنا لهم السلامة فى عالم يسوده العنف. أردنا أن نجنبهم مغبة التمرد والمخالفة فى عالم يدفع فيه المتمردون ثمنًا باهظًا من مستقبلهم ومن حريتهم بل من حياتهم أحيانًا. أردنا أن نصونهم من مخاطر التلقائية والصراحة فى عالم يشجع التصنع والمداهنة. أردنا أن نحميهم من المضى بتساؤلاتهم إلى غايتها فى عالم يضع حدودًا صارمة لما يجوز وما لا يجوز التساؤل عنه. أردنا أن ندربهم على الطاعة فى عالم يسوده الانصياع والمجاراة.
لقد أردنا لأطفالنا الخير.. كل الخير.. فما الذى حدث؟.
ما حدث هو أننا أغفلنا عددًا من الحقائق الأساسية لعل أهمها:
أولاً: أن محاولة إزالة العقبات بالقوة، أو مواجهة المعتدى بالعنف، قد تكون الوسيلة الأكثر فاعلية وسرعة، ولكنها تفترض أن يكون طفلى هو الأقوى والأقدر، وإلا هزم، وازداد المعتدى إمعانًا فى ممارسة اعتداءاته، ولا يصبح أمام طفلنا إلا الاستسلام للعنف إذا ما تكرر، والعجز أمام العقبات إذا ما واجهها. فالفشل فى هذه الأحوال يؤدى إلى مزيد من الفشل.
ثانياً: أن أنواع العقبات والاعتداءات عديدة متنوعة، قد تكون العقبة زميلًا أو أخًا منافسًا، أو مدرسًا يبدو متشددًا، أو قد تكون حتى أبًا يراه الطفل قاسيًا، أو أمًا يراها الطفل منحازة، وقد يكون الاعتداء الذى يواجهه الطفل بدنيًا أو لفظيًا، مباشرًا أو ضمنيًا. وقد يكون موجهًا إلى الممتلكات أو الأخوة أو الأصدقاء، بل حتى قد يكون موجهًا صوب المشاعر والأفكار، ومواجهة كافة أنواع العقبات والاعتداءات بأسلوب واحد هو القوة أو العنف أمر قد لا يعنى سوى تكريس العنف كأسلوب أوحد للتعامل فى كافة مواقف الحياة دون تمييز.
ثالثاً: أن المواجهة الفعالة لمواقف الحياة ينبغى أن تشمل إلى جانب إمكانية العنف أو القوة عددًا لا نهاية له من البدائل تتضمن مهارات القدرة على الحوار والمناقشة، وتفنيد الآراء وطرح البدائل، وجمع وتحليل المعلومات، والتفاعل مع الآخرين، وتأجيل الأشباع، والتفاوض... إلى آخره.
إننا فى حاجة ماسة لتعديل أساليب التنشئة الاجتماعية التى نمارسها حيال أطفالنا.. الخطر داهم، والأحداث تتسارع، ولم يعد مجديًا الاكتفاء بتوجيه النداء إلى المسئولين أو من يعنيهم الأمر، الأمر يعنينا جميعًا والأطفال أطفال الجميع والكل فى نفس الخندق. قد يصعب علينا نحن الكبار تعديل ما اعتدناه من أساليب فى التنشئة، وقد نستسهل إلقاء المسئولية على فريق منا دون فريق. وقد يزيد من صعوبة مهمتنا أن الأمر قد يتطلب إحداث تغيير أساسى فى نمط العلاقات المتبادلة بيننا نحن الكبار. وقد يزيد من صعوبة مهمتنا أيضًا ذلك الميل الطبيعى لدى البشر جميعًا لمقاومة الاعتراف العلنى بالخطأ. وقد يزيد من صعوبة تلك المهمة كذلك أننا قد نواجه بنية اقتصادية سياسية اجتماعية راسخة يستفيد أصحابها على المدى القصير من الوضع الراهن.
وليس من شك فى أن مواجهة ما يجرى بأقصى درجات الشدة والحكمة أمر لا يختلف عليه أحد. ولا شك، كذلك فى أن تقصى الجذور التاريخية الاجتماعية الاقتصادية السياسية الفكرية لذلك الذى يجرى، أمر لازم أيضا لأى معالجة جادة. ولا بأس كذلك إذا ما لزم الأمر من محاولة تحديد على عاتق من تقع مسئولية ما حدث، ولكن تبقى بعد ذلك بل قبل ذلك مهمة عاجلة ينبغى البدء فى انجازها الآن وفورًا، فلقد تأخرت طويلًا، وفضلًا عن صعوبتها، فإن إنجازها يتطلب وقتًا، والأحداث تتسارع من حولنا، إنها مهمة محاولة استنقاذ الأجيال القادمة من أطفالنا لكيلا يتكرر ما حدث، ولا أقول لكيلا يستمر.
إن أولئك الذين يمارسون العنف الآن، كانوا فى غالبيتهم أطفالًا منذ زمن قريب، بل لعل بعضهم مازال كذلك بمعنى ما. وإذا ما استمرت أساليب تنشئتنا لأطفالنا على ما هى عليه، فإن الأجيال القادمة لن تختلف كثيرًا عن جيل ممارسى العنف الراهن، إذا لم تكن أسوا. لقد كان هذا الجيل نتاجًا لعمليات التنشئة الاجتماعية لأطفالنا والتى مارسناها كأمهات وآباء، كمربين وتربويين، كإعلاميين ومسئولين، مارسناها فى بيوتنا، ومدارسنا، ومساجدنا وكنائسنا ونوادينا ومكاتبنا. مارستها صحافتنا وإذاعتنا وتليفزيوننا. مارستها السلطة والمعارضة. مارسناها جميعًا دون استثناء. مارسناها بالفعل ومن لم يستطع مارسها بالقول، ومن لم يستطع مارسها بالصمت ولعلة الأشد خطرًا.
لقد تكاتفنا جميعًا لدفع أطفالنا إلى ما يتنافى مع فطرتهم التلقائية الطبيعية. الطفل بفطرته محاور، دفعناه إلى الصمت، الطفل بفطرته متسائل، دفعناه إلى تقبل التلقين. الطفل بفطرته مفاوض فعال، دفعناه إلى الجمود العدواني. الطفل بفطرته تلقائي، دفعناه إلى التصنع والمداهنة. الطفل بفطرته تلقائي، دفعناه إلى التصنع والمداهنة. الطفل بفطرته ميال للمشاركة، دفعناه إلى الجمود العدواني. الطفل بفطرته تلقائي، دفعناه إلى التصنع والمداهنة. الطفل بفطرته ميال للمشاركة، دفعناه إلى الانطواء والتوجس من الآخرين. كنا فى ذلك كله نسبح ضد التيار، تيار الفطرة السليمة.
وللحقيقة فإن نوايانا كانت ومازالت طيبة، وحبنا لأطفالنا حقيقة لا يمارى فيها أحد. ولكن ذلك وحده لا يكفى، لقد أدت تنشئتنا لأطفالنا إلى حيث لا يجد الطفل أمامه لمواجهة مواقف الحياة إلا واحدًا من سبيلين لا ثالث لهما: إما التصدى بالعنف لإزالة ما يحول ببينه وبين ما يريد، ذلك إذا ما استطاع فإذا لم يستطع وكانت العقبة أقوى من إمكاناته، لم يعد أمامه إلا السبيل الآخر وهو الاستسلام دون شروط هجرة أو مرض نفسى أو انطفاء سلبي.
لقد أردنا لأطفالنا القوة فى عالم يسوده الأقوياء، وأردنا لهم السلامة فى عالم يسوده العنف. أردنا أن نجنبهم مغبة التمرد والمخالفة فى عالم يدفع فيه المتمردون ثمنًا باهظًا من مستقبلهم ومن حريتهم بل من حياتهم أحيانًا. أردنا أن نصونهم من مخاطر التلقائية والصراحة فى عالم يشجع التصنع والمداهنة. أردنا أن نحميهم من المضى بتساؤلاتهم إلى غايتها فى عالم يضع حدودًا صارمة لما يجوز وما لا يجوز التساؤل عنه. أردنا أن ندربهم على الطاعة فى عالم يسوده الانصياع والمجاراة.
لقد أردنا لأطفالنا الخير.. كل الخير.. فما الذى حدث؟.
ما حدث هو أننا أغفلنا عددًا من الحقائق الأساسية لعل أهمها:
أولاً: أن محاولة إزالة العقبات بالقوة، أو مواجهة المعتدى بالعنف، قد تكون الوسيلة الأكثر فاعلية وسرعة، ولكنها تفترض أن يكون طفلى هو الأقوى والأقدر، وإلا هزم، وازداد المعتدى إمعانًا فى ممارسة اعتداءاته، ولا يصبح أمام طفلنا إلا الاستسلام للعنف إذا ما تكرر، والعجز أمام العقبات إذا ما واجهها. فالفشل فى هذه الأحوال يؤدى إلى مزيد من الفشل.
ثانياً: أن أنواع العقبات والاعتداءات عديدة متنوعة، قد تكون العقبة زميلًا أو أخًا منافسًا، أو مدرسًا يبدو متشددًا، أو قد تكون حتى أبًا يراه الطفل قاسيًا، أو أمًا يراها الطفل منحازة، وقد يكون الاعتداء الذى يواجهه الطفل بدنيًا أو لفظيًا، مباشرًا أو ضمنيًا. وقد يكون موجهًا إلى الممتلكات أو الأخوة أو الأصدقاء، بل حتى قد يكون موجهًا صوب المشاعر والأفكار، ومواجهة كافة أنواع العقبات والاعتداءات بأسلوب واحد هو القوة أو العنف أمر قد لا يعنى سوى تكريس العنف كأسلوب أوحد للتعامل فى كافة مواقف الحياة دون تمييز.
ثالثاً: أن المواجهة الفعالة لمواقف الحياة ينبغى أن تشمل إلى جانب إمكانية العنف أو القوة عددًا لا نهاية له من البدائل تتضمن مهارات القدرة على الحوار والمناقشة، وتفنيد الآراء وطرح البدائل، وجمع وتحليل المعلومات، والتفاعل مع الآخرين، وتأجيل الأشباع، والتفاوض... إلى آخره.
إننا فى حاجة ماسة لتعديل أساليب التنشئة الاجتماعية التى نمارسها حيال أطفالنا.. الخطر داهم، والأحداث تتسارع، ولم يعد مجديًا الاكتفاء بتوجيه النداء إلى المسئولين أو من يعنيهم الأمر، الأمر يعنينا جميعًا والأطفال أطفال الجميع والكل فى نفس الخندق. قد يصعب علينا نحن الكبار تعديل ما اعتدناه من أساليب فى التنشئة، وقد نستسهل إلقاء المسئولية على فريق منا دون فريق. وقد يزيد من صعوبة مهمتنا أن الأمر قد يتطلب إحداث تغيير أساسى فى نمط العلاقات المتبادلة بيننا نحن الكبار. وقد يزيد من صعوبة مهمتنا أيضًا ذلك الميل الطبيعى لدى البشر جميعًا لمقاومة الاعتراف العلنى بالخطأ. وقد يزيد من صعوبة تلك المهمة كذلك أننا قد نواجه بنية اقتصادية سياسية اجتماعية راسخة يستفيد أصحابها على المدى القصير من الوضع الراهن.