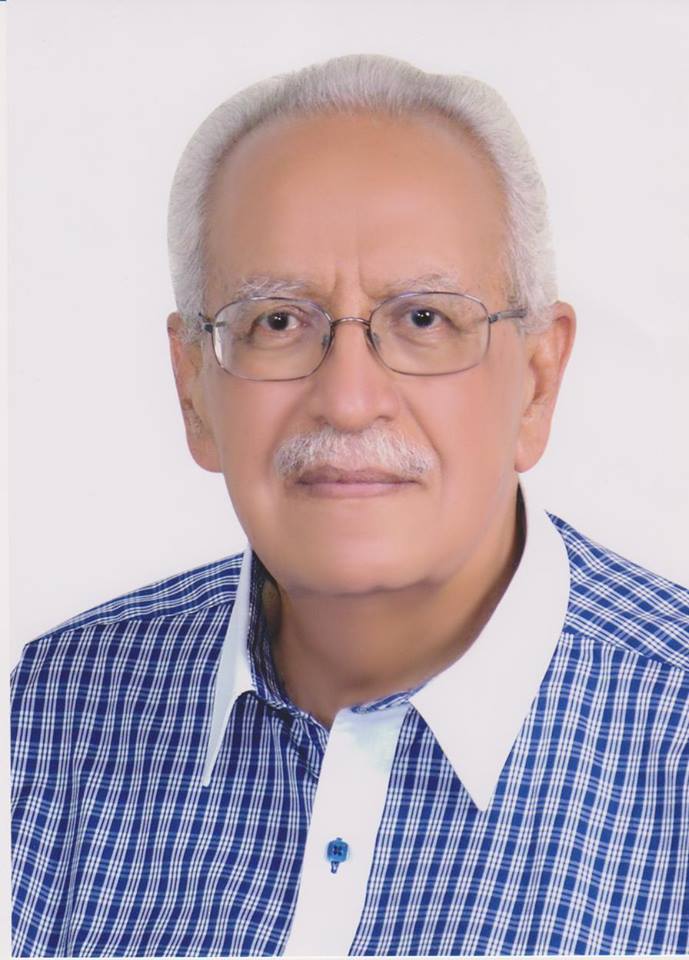التقيت فى مستهل دراستى لعلم النفس، بمصطلح مثير هو «العصاب التجريبى»، وتعرفت من خلال دراسة ذلك الموضوع، على مجموعة من التجارب أجراها علماء النفس على فئران التجارب، بهدف التعرف على مسببات اختلال الجهاز العصبى الذى تتبدى مظاهره فى مجموعة مترابطة من الاضطرابات السلوكية، تشمل الخوف والعزوف عن الحركة والهياج عند الاستثارة والعدوانية إلى آخره.
ما زلت أذكر ذلك الفأر المسكين الجائع، الذى يتم تدريبه لكى يتعرف على الطريق الذى ينبغى أن يسلكه ليجد طعامه، وأن يتجنب الطريق الآخر الذى يؤدى إلى صدمة كهربائية مؤلمة. وبعد أن يطمئن القائم بالتجربة على إتقان الفأر للتمييز بين «طريق السلامة» و«طريق الندامة»، وأنه ـ أى الفأر ـ أصبح يتجه مباشرة إلى حيث الطعام، تبدأ التجربة الحقيقية بأن يتم تبديل مواقع الثواب والعقاب، بحيث إن الفأر إذا ما اتجه إلى الطريق الذى اعتاده للحصول على المكافأة فوجئ بالعقاب، إلى أن يكتشف بالمصادفة أن طريق الندامة قد أصبح طريق السلامة، فيأخذ فى التعود عليه بصعوبة وما إن تستقر أحواله حتى يكرر القائم بالتجربة عملية تبديل مواقع الثواب والعقاب مرة أخرى، حتى يفقد الفأر توقعاته وتختلط عليه الأمور، وحينئذ نجد الفأر رغم جوعه قد انكمش فى زاوية بعيدة من قفص التجربة، فاقدا شهيته، عازفا عن الحركة، يلوذ بالفرار إذا ما اقترب منه أى كائن حتى لو كان من جنسه، وإذا عجز عن الفرار اندفع مهاجمًا بكل عنف، وقد يظل الفأر المسكين أسيرا لذلك «العصاب التجريبى» إلى أن يفارق الحياة.
تذكرت ذلك منذ سنوات خلال قراءتى لسيرة ذاتية كتبها أحد رواد العلوم الاجتماعية، أشار فيها إلى أنه بذل جهدا غير عادى لإنجاز واحد من المشروعات الموكلة إليه، وتوقع أن يحتل اسمه صدر كشوف المكافآت، وإذا بتلك الكشوف تخلو من اسمه تمامًا، وانتابه الحزن وقرر أن يكف عن بذل أى جهد إضافى، فإذا به يتلقى مكافأة مجزية، وبدا له أن القاعدة هى ألا تعمل فتكافأ، فإذا به يكتشف الحقيقة: لا توجد قاعدة أصلًا!!
أدركت آنذاك أن ما تعلمناه فى دروسنا الأولى فى علم النفس لم يكن قاصرا على سلوك الفئران، ولم تكن أهم تطبيقاته ـ كما فهمنا آنذاك ـ تنحصر فى مجال علم النفس المرضى، بل إن هناك من الأفراد من يلعبون بوعى أو بدون وعى، دور صاحبنا الذى كان يجرى تجاربه على الفئران. الفارق هو أنه كان يجريها بوعى وبهدف العلم والمعرفة، وبدون أن يعنيه أمر الفئران بشكل شخصى، أما غيره فإنهم يفعلون ما يفعلون بهدف إشباع نزعة عارمة لديهم فى التفرعن أو التأله، أو بهدف التدمير النفسى المقصود للآخر.
ومضت السنون لألتقى بنماذج مشابهة عديدة: آباء وأمهات يحرصون على حرمان أبنائهم من نعمة التوقع، جلادون محترفون يحرصون على تدمير مخطط مقصود لتوقعات ضحاياهم. خبراء فى الحرب النفسية يضعون خططًا علمية محكمة بهدف تدمير «جهاز التوقعات» لدى الخصم لدفعه للانكماش والاستسلام. أنظمة اجتماعية كاملة تقوم على حرمان الرعايا من تكوين توقعات للمستقبل القريب أو البعيد على حد سواء. يشتركون جميعًا فى النفور ممن يسألهم تبريرا لأفعالهم، أو عرضا لخططهم المستقبلية، بل قد يقدمون على أبشع أنواع العقاب لمن يجرؤ على اقتراف تلك الخطيئة، خطيئة محاولة معرفة الأسباب، وما يترتب على تلك المعرفة من إمكانية التوقع.
إن القدرة على التوقع تعد من أهم الخصائص التى تميز الكائنات الأرقى عن الكائنات الأقل رقيًا، إنها جوهر عملية التعلم والتفكير وحل المشكلات؛ بل إننا لا نبالغ إذا ما قلنا إنها سر الحياة وبالتحديد سر حياة البشر. وقد يبدو الأمر للوهلة الأولى كما لو كان به قدر من المبالغة، ترى ألا يؤدى بعض الاضطرابات العقلية إلى اختلال القدرة على التوقع لدى أصحابها بدرجة خطيرة ومع ذلك يظلون أحياء؟ والإجابة نعم بكل تأكيد، ولكنهم فى تلك الحالة يصبحون «فاقدى الأهلية» ومن ثم يصبحون فى حاجة لمن يدير لهم حياتهم، أى فى حاجة لمن يمارس التوقع نيابة عنهم، فى حاجة إلى «وكيل» يتولى عنهم مسئولية اتخاذ قراراتهم اليومية، أى مسئولية إعاشتهم وحمايتهم وفقا لما يراه.
وهنا مربط الفرس كما يقولون، إن صناعة ذلك النوع من الجنون تستهدف القضاء على أهلية الآخر الذى قد يكون ابنًا أو ابنة أو زوجة أو سجينًا أو أسيرًا أو مرءوسًا أو حتى مواطنًا عاديًا. صناع الجنون يستهدفون فى النهاية ابتلاع الآخر. قد تكون نواياهم طيبة أو شريرة، وقد يكونون على بينة من نتائج أعمالهم، أو قد تكون تلك النتائج خافية عن بصيرتهم؛ غير أن ذلك لا يغير بحال من النتيجة المرعبة.
إلا أن الصورة لا تكون دائمًا حالكة السواد، فالبشر ـ أفرادا وجماعات ـ يقاومون الجنون، إنها حقيقة من حقائق الطب النفسى الراسخة، قد تفشل المقاومة حينًا ولكنها تنجح فى أغلب الأحيان. وكثيرًا ما يعتمد الطبيب النفسى إلى جانب العقاقير على تلك الرغبة الغالبة لدى الفرد فى الشفاء والتخلص من الجنون.
أما على مستوى الجماعات، فالأمر أكثر تعقيدا، لقد تطورت صناعة الجنون مع تطور المجتمع فأصبحت صناعة ضخمة لها مؤسساتها الإعلامية والقمعية والفكرية، وظل الهدف ثابتا لا يتغير: إلغاء أهلية المواطنين وتحويلهم إلى رعايا لا يملكون من أمرهم شيئا، ولكن من خلال إقناع الضحايا أنفسهم بذلك الهدف، بحيث يصبح العزوف عن اتخاذ قراراتهم بأنفسهم قيمة إيجابية تحكم تصرفاتهم تلقائيًا، ويصبح التساؤل عن الأسباب تهمة ينبغى نفيها والاعتذار عنها، ويصبح الأمر كله لأولى الأمر يتولون عن الجميع مهام الإعاشة والحماية كما يرون وبالشكل الذى يروق لهم وبالقدر الذى يتفق مع مصالحهم.
ما زلت أذكر ذلك الفأر المسكين الجائع، الذى يتم تدريبه لكى يتعرف على الطريق الذى ينبغى أن يسلكه ليجد طعامه، وأن يتجنب الطريق الآخر الذى يؤدى إلى صدمة كهربائية مؤلمة. وبعد أن يطمئن القائم بالتجربة على إتقان الفأر للتمييز بين «طريق السلامة» و«طريق الندامة»، وأنه ـ أى الفأر ـ أصبح يتجه مباشرة إلى حيث الطعام، تبدأ التجربة الحقيقية بأن يتم تبديل مواقع الثواب والعقاب، بحيث إن الفأر إذا ما اتجه إلى الطريق الذى اعتاده للحصول على المكافأة فوجئ بالعقاب، إلى أن يكتشف بالمصادفة أن طريق الندامة قد أصبح طريق السلامة، فيأخذ فى التعود عليه بصعوبة وما إن تستقر أحواله حتى يكرر القائم بالتجربة عملية تبديل مواقع الثواب والعقاب مرة أخرى، حتى يفقد الفأر توقعاته وتختلط عليه الأمور، وحينئذ نجد الفأر رغم جوعه قد انكمش فى زاوية بعيدة من قفص التجربة، فاقدا شهيته، عازفا عن الحركة، يلوذ بالفرار إذا ما اقترب منه أى كائن حتى لو كان من جنسه، وإذا عجز عن الفرار اندفع مهاجمًا بكل عنف، وقد يظل الفأر المسكين أسيرا لذلك «العصاب التجريبى» إلى أن يفارق الحياة.
تذكرت ذلك منذ سنوات خلال قراءتى لسيرة ذاتية كتبها أحد رواد العلوم الاجتماعية، أشار فيها إلى أنه بذل جهدا غير عادى لإنجاز واحد من المشروعات الموكلة إليه، وتوقع أن يحتل اسمه صدر كشوف المكافآت، وإذا بتلك الكشوف تخلو من اسمه تمامًا، وانتابه الحزن وقرر أن يكف عن بذل أى جهد إضافى، فإذا به يتلقى مكافأة مجزية، وبدا له أن القاعدة هى ألا تعمل فتكافأ، فإذا به يكتشف الحقيقة: لا توجد قاعدة أصلًا!!
أدركت آنذاك أن ما تعلمناه فى دروسنا الأولى فى علم النفس لم يكن قاصرا على سلوك الفئران، ولم تكن أهم تطبيقاته ـ كما فهمنا آنذاك ـ تنحصر فى مجال علم النفس المرضى، بل إن هناك من الأفراد من يلعبون بوعى أو بدون وعى، دور صاحبنا الذى كان يجرى تجاربه على الفئران. الفارق هو أنه كان يجريها بوعى وبهدف العلم والمعرفة، وبدون أن يعنيه أمر الفئران بشكل شخصى، أما غيره فإنهم يفعلون ما يفعلون بهدف إشباع نزعة عارمة لديهم فى التفرعن أو التأله، أو بهدف التدمير النفسى المقصود للآخر.
ومضت السنون لألتقى بنماذج مشابهة عديدة: آباء وأمهات يحرصون على حرمان أبنائهم من نعمة التوقع، جلادون محترفون يحرصون على تدمير مخطط مقصود لتوقعات ضحاياهم. خبراء فى الحرب النفسية يضعون خططًا علمية محكمة بهدف تدمير «جهاز التوقعات» لدى الخصم لدفعه للانكماش والاستسلام. أنظمة اجتماعية كاملة تقوم على حرمان الرعايا من تكوين توقعات للمستقبل القريب أو البعيد على حد سواء. يشتركون جميعًا فى النفور ممن يسألهم تبريرا لأفعالهم، أو عرضا لخططهم المستقبلية، بل قد يقدمون على أبشع أنواع العقاب لمن يجرؤ على اقتراف تلك الخطيئة، خطيئة محاولة معرفة الأسباب، وما يترتب على تلك المعرفة من إمكانية التوقع.
إن القدرة على التوقع تعد من أهم الخصائص التى تميز الكائنات الأرقى عن الكائنات الأقل رقيًا، إنها جوهر عملية التعلم والتفكير وحل المشكلات؛ بل إننا لا نبالغ إذا ما قلنا إنها سر الحياة وبالتحديد سر حياة البشر. وقد يبدو الأمر للوهلة الأولى كما لو كان به قدر من المبالغة، ترى ألا يؤدى بعض الاضطرابات العقلية إلى اختلال القدرة على التوقع لدى أصحابها بدرجة خطيرة ومع ذلك يظلون أحياء؟ والإجابة نعم بكل تأكيد، ولكنهم فى تلك الحالة يصبحون «فاقدى الأهلية» ومن ثم يصبحون فى حاجة لمن يدير لهم حياتهم، أى فى حاجة لمن يمارس التوقع نيابة عنهم، فى حاجة إلى «وكيل» يتولى عنهم مسئولية اتخاذ قراراتهم اليومية، أى مسئولية إعاشتهم وحمايتهم وفقا لما يراه.
وهنا مربط الفرس كما يقولون، إن صناعة ذلك النوع من الجنون تستهدف القضاء على أهلية الآخر الذى قد يكون ابنًا أو ابنة أو زوجة أو سجينًا أو أسيرًا أو مرءوسًا أو حتى مواطنًا عاديًا. صناع الجنون يستهدفون فى النهاية ابتلاع الآخر. قد تكون نواياهم طيبة أو شريرة، وقد يكونون على بينة من نتائج أعمالهم، أو قد تكون تلك النتائج خافية عن بصيرتهم؛ غير أن ذلك لا يغير بحال من النتيجة المرعبة.
إلا أن الصورة لا تكون دائمًا حالكة السواد، فالبشر ـ أفرادا وجماعات ـ يقاومون الجنون، إنها حقيقة من حقائق الطب النفسى الراسخة، قد تفشل المقاومة حينًا ولكنها تنجح فى أغلب الأحيان. وكثيرًا ما يعتمد الطبيب النفسى إلى جانب العقاقير على تلك الرغبة الغالبة لدى الفرد فى الشفاء والتخلص من الجنون.
أما على مستوى الجماعات، فالأمر أكثر تعقيدا، لقد تطورت صناعة الجنون مع تطور المجتمع فأصبحت صناعة ضخمة لها مؤسساتها الإعلامية والقمعية والفكرية، وظل الهدف ثابتا لا يتغير: إلغاء أهلية المواطنين وتحويلهم إلى رعايا لا يملكون من أمرهم شيئا، ولكن من خلال إقناع الضحايا أنفسهم بذلك الهدف، بحيث يصبح العزوف عن اتخاذ قراراتهم بأنفسهم قيمة إيجابية تحكم تصرفاتهم تلقائيًا، ويصبح التساؤل عن الأسباب تهمة ينبغى نفيها والاعتذار عنها، ويصبح الأمر كله لأولى الأمر يتولون عن الجميع مهام الإعاشة والحماية كما يرون وبالشكل الذى يروق لهم وبالقدر الذى يتفق مع مصالحهم.