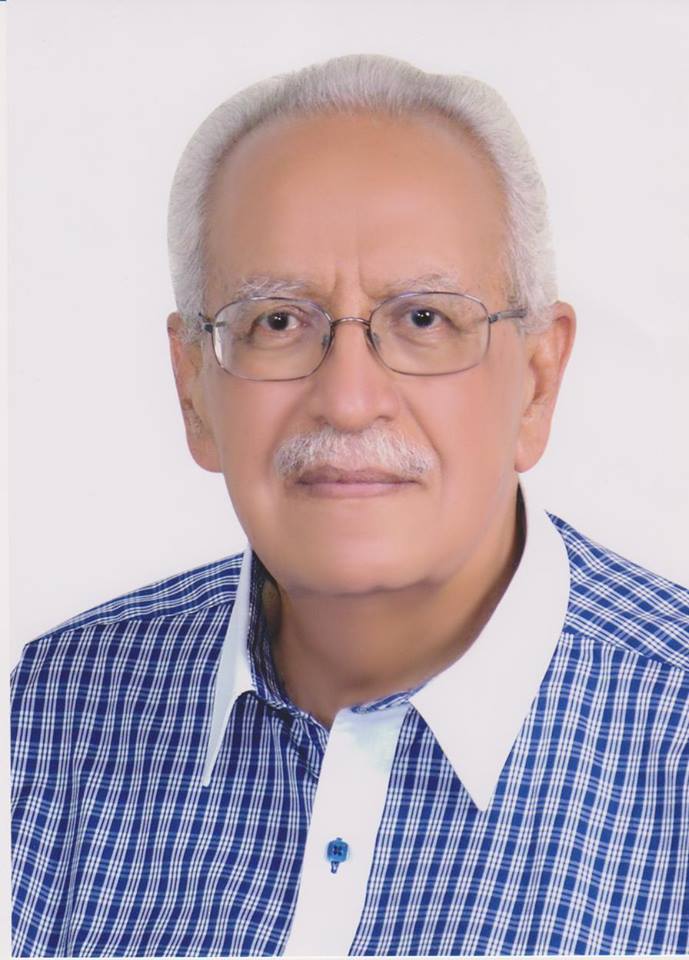سبق أن أشرنا إلى أن الإعلام مهما بلغت قوة تأثيره ليس بالعامل الوحيد فى مجال الوعى بالظلم تزييفًا أو تضخيمًا، بل تشاركه وقد تفوقه تأثيرًا مؤسسات اجتماعية أخرى، قد تكون أشد خطرًا وعلى رأسها الأسرة والمدرسة، حيث يتلقى الطفل منذ فجر طفولته تدريبًا مكثفًا على أساسيات مواجهة الوعى بالظلم أو الحرمان، سواء من موقع المحروم أو من موقع المتهم بالظلم.
إن أطفالنا يتلقون منذ البداية عددًا مهمًا من الدروس، فى مقدمتها أن صاحب القرار ليس ملزمًا بتقديم تفسير لقراراته. إنه ليس مطالبا بالإجابة عن السؤال «لماذا؟» إن مجرد استخدام هذا الأسلوب الاستفهامى قد يعتبر فى حد ذاته إهانة لصاحب القرار، خاصة إذا ما تعلق الأمر بقرار يبدو ظالمًا بصورة أو بأخرى.
إننا ندرب الطفل بل والكبير على أن المطالبة بالشفافية والتفسير تعد نوعًا من الاجتراء على صاحب القرار. ويرسخ هذا المفهوم لدى الجميع سواء من يتخذون القرارات أو من تتخذ حيالهم. والأمثلة حولنا تفوق الحصر. كثيرًا ما نعتبر مجرد التظلم أى التساؤل عن مبرر العقاب أو الحرمان أو عدم المساواة إهانة موجهة لصاحب القرار.
كثيرًا ما نشاهد راشدًا يعاقب طفلًا أو رئيسًا يعاقب مرءوسًا، فإذا ما تساءل الطفل أو المرءوس عن السبب فيما يعتبره ظلمًا أو أبدى عدم اقتناعه بالمبررات المطروحة، استشاط الكبير غضبًا وازداد شدة فى عقابه وتناثرت منه تعبيرات من نوع «كيف تجرؤ على الرد علي؟».
أما إذا ما جرؤ الطفل أو المرءوس على طلب تفسير ما يراه تمييزًا فى المعاملة وطالب بعقاب كل من ارتكب نفس الفعل، فإنها الطامة الكبرى. وسرعان ما تتردد العبارة الشهيرة «لا أحب أن أسمع كلمة اشمعني»، ولقد دخلت تلك الكلمة الأقرب للفصحى والتى تعنى حرفيًا «ما معني»، دخلت فى قائمة التعبيرات غير المهذبة، بل التى يحظر استخدامها اجتماعيًا فى حوار المظلوم - الظالم.
مجتمعاتنا أصبحت تضيق بالشفافية وبالتساؤل عن الأسباب والمبررات، وتصبح الظاهرة أشد خطرًا إذا ما انتشرت لدى من تتخذ حيالهم القرارات فى تعاملاتهم مع بعضهم، ولم تعد مقصورة على من يتخذونها. إن استخدامنا لأداة الاستفهام «لماذا؟» يزداد خفوتًا، وكذلك كلمة «اشمعني»، وإدانة استخدامهما قد تصل إلى حد التجريم بل التحريم، خاصة إذا ما اقتربت من نطاق المحرمات الثلاثة الشهيرة: الجنس والدين وكذلك السياسة بمفهومها الواسع.
إن انتشار التساؤل عن الأسباب يعد بمثابة المحرك لتقدم المجتمعات علميًا واجتماعيًا. لقد كانت التساؤلات المندهشة حيال أمور تبدو طبيعية معتادة بمثابة الومضة الأولى بالنسبة للعديد من أعظم الاكتشافات العلمية التى ننعم باستخدام تطبيقاتها التكنولوجية فى عالم اليوم. كذلك فإن التساؤل عن الأسباب، خاصة أسباب الحرمان، كان عبر التاريخ بمثابة القوة الدافعة للتقدم الاجتماعى، حيث يمثل الشرط الأساسى لاكتشاف المظالم والوعى بها ومن ثم البحث عن سبيل لتجاوزها.
وقد يبدو للوهلة الأولى أن حصول المحروم أو المظلوم على إجابة تفسر السبب لما يشعر به أمر مفيد للمظلومين، الذين يعانون حرمانا فحسب، وحقيقة الأمر أن مثل تلك الشفافية أو المكاشفة تكونان مفيدتين للجميع كأفراد وكمجتمع على حد سواء، فقد لا يكون الظالم واعيًا بظلمه فيتراجع عنه عند اكتشافه تائبًا معتذرًا، فضلًا عن أنه قد يتبين أسباب ارتكابه لذلك الظلم. وفى بعض الحالات قد يتبين المظلوم أن حرمانه أو إخفاقه كان له ما يبرره ومن ثم يتحمل مسئوليته عنه ويعدل بالتالى من سلوكه الخاطئ. يصدق ذلك على الصغار والكبار.
على القرارات القومية الكبرى والقرارات اليومية الأسرية الصغيرة. المكاشفة والتفسير ضمانان لصاحب القرار قبل أن يكونا حقًا للمتظلم.