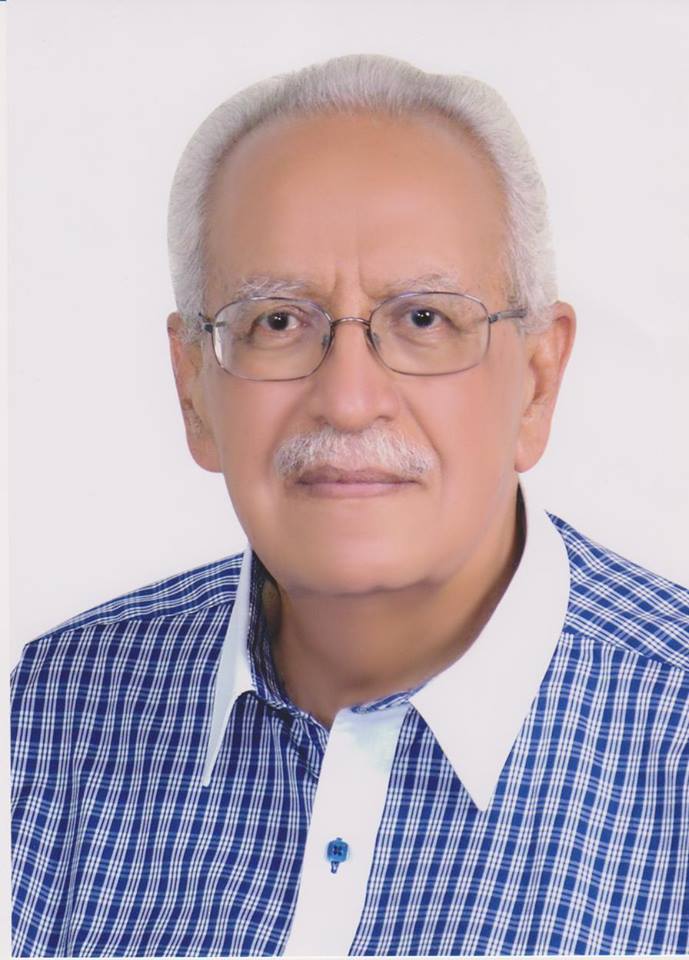ليس من شك فى أن الإنسان، منذ أن وجد على هذه الأرض، وسعى فى مناكبها، وقضية المستقبل تستحوذ على القدر الأكبر من اهتمامه، وإذا ما أمعنا النظر لا يتضح لنا أن اهتمامه هذا بالمستقبل لم يكن ترفًا ولا تزيدًا، فظروف حياة الإنسان البدائى لم تكن تسمح بترف ولا بتزيد. لقد كانت قضية «المستقبل» لديه قضية حياة أو موت؛ أعنى حياته أو موته.
المستقبل أمامه ملىء بالأخطار التى تهدده من كل صوب وفى كل لحظة. كلها أخطار محتملة، أى أنها قد تحدث وقد لا تحدث، فإذا ما حدثت فهو هالك لا محالة، وإذا لم تحدث فلسوف تمضى به الحياة. ولكن أى حياة تلك التى يسودها القلق والترقب ويملؤها الفزع والرعب. أيبقى فى مكانه؟ قد تنهمر عليه السيول فتجرفه، وقد تنفجر من تحته البراكين فتدمره، وقد لا يحدث شيء من ذلك على الإطلاق، أيخرج للصيد؟ قد يكون ذلك الحيوان القادم نحوه وحشًا مفترسًا لا قبل له بمواجهته، وقد يكون صيدًا سهلًا فيه غذاؤه.
أو يأكل هذا النبات؟ قد يكون سامًا فيقضى عليه، وقد يكون طيبًا فيشبعه. قد يكون مرًا حنظلًا لا يُستساغ، وقد يكون مقبولا شهيا فيه فائدة. ومئات من الأسئلة أو لنقل من المشاكل طرحت نفسها على الإنسان منذ وجد، آخذة بخناقه دافعة به إلى دوامة من القلق تهدد وجوده، وتكاد أن تقضى عليه.
ولم يكن من حل أمام الإنسان إلا أن يعرف، أن يعلم. لم يكن أمام الإنسان البدائى لكى يكفل أمنًا لوجوده ولكى يضع بالتالى نهاية لقلقه، إلا أن يعرف ما إذا كان معرضا لسيل جارف أو لبركان مدمر.
أن يعلم أى الحيوانات تصلح لغذائه، وأيها يصلح هو لغذائها. أن يعلم أى النباتات سام وأيها طيب، أيها مر وأيها مستساغ. وبناء على معرفته تلك بالمستقبل يستطيع أن يتخذ قراراته. فإذا أدت به معرفته إلى أن مكانه سوف يتعرض لبركان أو لسيل أو لزلزال.
اتخذ سبيله بعيدا عنه. وإذا أدى به علمه إلى أن ذلك النبات سام سوف يفضى إلى موته إذا ما أكله، أو أن طعمه سوف يكون مرًا، اجتنبه ولم يقربه. وإذا أدت به معرفته إلى أن ذلك الحيوان القادم نحوه سوف يتمكن من افتراسه اتخذ حذره منه.
كان العلم لدى الإنسان البدائى يعنى الأمن والحياة. وما زال الأمر كذلك حتى يومنا هذا. ولو تصورنا جوهر تلك «المعرفة البدائية» أو ذلك «العلم البدائى»، لما وجدناه يختلف، من حيث جوهر العمليات السيكولوجية التى تحكمه، ولا من حيث الدوافع الأصيلة التى تدفعه، ولا حتى من حيث الأهداف التى يسعى إليها، عن المعرفة والعلم فى أى عصر وفى أى مكان.
ولنتأمل كيف حصل ذلك الإنسان البدائى علمه، وما الذى فعله به. لقد حقق الإنسان البدائى علمه بملاحظته لأحداث مضت. أحداث وقعت له أو لغيره ورآها ففسرها وتوصل إلى فهم لها ومعرفة بها.
وتمكن بناء على تلك المعرفة وذلك الفهم من التوصل إلى تنبؤ بما سوف يحدث، وبالتالى أقدم على ما أقدم عليه وهو أكثر اطمئنانًا، وتجنب ما تجنبه وهو أكثر أمنًا.
كانت تلك هى كيفية المعرفة، وهدفها منذ وجد الإنسان. وما زالت تلك هى الكيفية حتى الآن وإن اختلفت الوسائل وتعددت، وما زال ذلك هو الهدف وإن تباينت الصور واتسعت المجالات.
إذن فالعلوم جميعًا مهما اختلفت، وتعددت، وتباينت صورها ومجالاتها، لا تعدو أن تكون فى النهاية استقراء لوقائع حدثت، وتنبؤًا بوقائع سوف تحدث، وقد يتعمد الإنسان أن يحدث تلك الوقائع، ليستخلص منها ما يستخلصه من تنبؤات، كما يحدث مثلا فى بعض تجارب الكيمياء والطبيعة وقد ينتظر حدوث تلك الوقائع ويقوم برصدها ليصل إلى تنبؤاته كما هو الحال فى دراسات علم الفلك، وبعض فروع الطب أيضا، وقد يرجع إلى وقائع حدثت فيما مضى، وانتهت وسجلها آخرون ليعيد تفسيرها واصلًا بذلك إلى تنبؤاته كما يحدث فى علم التاريخ مثلًا، وغير ذلك من السبل كثير يفوق الحصر. ولكن يبقى الخط العام واحدًا. معرفة بما حدث وتفسير له، وتنبؤ بما سيحدث، واستعدادًا له.
ورغم ذلك الارتباط الوثيق بين المعرفة والحياة، فإن البشر لا يتساوون فى سعيهم للمعرفة؛ فالكثيرون يتكاسلون اعتمادا على غيرهم، بل والبعض يقاومون تلك المعرفة العلمية الضرورية مقاومة شرسة. ترى ما الذى يجعل إنسانا يسعى إلى المعرفة وآخر لا يقدم على ذلك السعي؟ ما الذى يجعل إنسانا يحصل علي معرفة خاطئة بينة الخطأ، ومع ذلك يطمئن إليها ويستكين، وآخر يحصل علي معرفة لا تخلو من صواب، ومع ذلك لا يكف عن محاولة تطويرها وإعادة اختبارها وإمعان النظر فيها؟
ليس ثمة ما يفسر ذلك، إلا أن المعرفة فى النهاية عملية صراع. صراع مع الجهل والتجهيل. صراع ـ شأنه شأن أى صراع آخر ـ تكتنفه نذر الإخفاق والفشل، وتلوح له بشائر النجاح والتوفيق.
وإذا كان الجهل خطرا يهدد قوى التنوير بالإخفاق، فإن التجهيل ـ أعنى فرض المجهلة ـ أشد خطورة وتهديدا. فالجهل بالشيء لا يعنى بالضرورة كفًا لمحاولات معرفته، ولا يفرض قيدا على تلك المحاولات، بل لعله يكون دافعا ـ وغالبًا ما يكون كذلك بالفعل ـ لبذل المزيد من محاولة المعرفة. أما التجهيل فتتمثل خطورته فى كونه محاولة مقصودة للإيهام بالمعرفة أو لتوهم المعرفة.
محاولة يتعرض لها الإنسان من قبل الآخرين ممن يحاولون الحيلولة بينه وبين السعى للمعرفة وتحصيلها، فلا يجدون أفضل من إيهامه بأنه يعرف، فينتفى قلقه، ويطمئن لذلك ويستكين. عازفًا عن بذل محاولة جديدة للمعرفة تكلفه جهدًا وقلقًا. ويمضى متمسكًا بما يعرفه، أو بما يتوهم أنه يعرفه رافضًا التخلى عنه.
المستقبل أمامه ملىء بالأخطار التى تهدده من كل صوب وفى كل لحظة. كلها أخطار محتملة، أى أنها قد تحدث وقد لا تحدث، فإذا ما حدثت فهو هالك لا محالة، وإذا لم تحدث فلسوف تمضى به الحياة. ولكن أى حياة تلك التى يسودها القلق والترقب ويملؤها الفزع والرعب. أيبقى فى مكانه؟ قد تنهمر عليه السيول فتجرفه، وقد تنفجر من تحته البراكين فتدمره، وقد لا يحدث شيء من ذلك على الإطلاق، أيخرج للصيد؟ قد يكون ذلك الحيوان القادم نحوه وحشًا مفترسًا لا قبل له بمواجهته، وقد يكون صيدًا سهلًا فيه غذاؤه.
أو يأكل هذا النبات؟ قد يكون سامًا فيقضى عليه، وقد يكون طيبًا فيشبعه. قد يكون مرًا حنظلًا لا يُستساغ، وقد يكون مقبولا شهيا فيه فائدة. ومئات من الأسئلة أو لنقل من المشاكل طرحت نفسها على الإنسان منذ وجد، آخذة بخناقه دافعة به إلى دوامة من القلق تهدد وجوده، وتكاد أن تقضى عليه.
ولم يكن من حل أمام الإنسان إلا أن يعرف، أن يعلم. لم يكن أمام الإنسان البدائى لكى يكفل أمنًا لوجوده ولكى يضع بالتالى نهاية لقلقه، إلا أن يعرف ما إذا كان معرضا لسيل جارف أو لبركان مدمر.
أن يعلم أى الحيوانات تصلح لغذائه، وأيها يصلح هو لغذائها. أن يعلم أى النباتات سام وأيها طيب، أيها مر وأيها مستساغ. وبناء على معرفته تلك بالمستقبل يستطيع أن يتخذ قراراته. فإذا أدت به معرفته إلى أن مكانه سوف يتعرض لبركان أو لسيل أو لزلزال.
اتخذ سبيله بعيدا عنه. وإذا أدى به علمه إلى أن ذلك النبات سام سوف يفضى إلى موته إذا ما أكله، أو أن طعمه سوف يكون مرًا، اجتنبه ولم يقربه. وإذا أدت به معرفته إلى أن ذلك الحيوان القادم نحوه سوف يتمكن من افتراسه اتخذ حذره منه.
كان العلم لدى الإنسان البدائى يعنى الأمن والحياة. وما زال الأمر كذلك حتى يومنا هذا. ولو تصورنا جوهر تلك «المعرفة البدائية» أو ذلك «العلم البدائى»، لما وجدناه يختلف، من حيث جوهر العمليات السيكولوجية التى تحكمه، ولا من حيث الدوافع الأصيلة التى تدفعه، ولا حتى من حيث الأهداف التى يسعى إليها، عن المعرفة والعلم فى أى عصر وفى أى مكان.
ولنتأمل كيف حصل ذلك الإنسان البدائى علمه، وما الذى فعله به. لقد حقق الإنسان البدائى علمه بملاحظته لأحداث مضت. أحداث وقعت له أو لغيره ورآها ففسرها وتوصل إلى فهم لها ومعرفة بها.
وتمكن بناء على تلك المعرفة وذلك الفهم من التوصل إلى تنبؤ بما سوف يحدث، وبالتالى أقدم على ما أقدم عليه وهو أكثر اطمئنانًا، وتجنب ما تجنبه وهو أكثر أمنًا.
كانت تلك هى كيفية المعرفة، وهدفها منذ وجد الإنسان. وما زالت تلك هى الكيفية حتى الآن وإن اختلفت الوسائل وتعددت، وما زال ذلك هو الهدف وإن تباينت الصور واتسعت المجالات.
إذن فالعلوم جميعًا مهما اختلفت، وتعددت، وتباينت صورها ومجالاتها، لا تعدو أن تكون فى النهاية استقراء لوقائع حدثت، وتنبؤًا بوقائع سوف تحدث، وقد يتعمد الإنسان أن يحدث تلك الوقائع، ليستخلص منها ما يستخلصه من تنبؤات، كما يحدث مثلا فى بعض تجارب الكيمياء والطبيعة وقد ينتظر حدوث تلك الوقائع ويقوم برصدها ليصل إلى تنبؤاته كما هو الحال فى دراسات علم الفلك، وبعض فروع الطب أيضا، وقد يرجع إلى وقائع حدثت فيما مضى، وانتهت وسجلها آخرون ليعيد تفسيرها واصلًا بذلك إلى تنبؤاته كما يحدث فى علم التاريخ مثلًا، وغير ذلك من السبل كثير يفوق الحصر. ولكن يبقى الخط العام واحدًا. معرفة بما حدث وتفسير له، وتنبؤ بما سيحدث، واستعدادًا له.
ورغم ذلك الارتباط الوثيق بين المعرفة والحياة، فإن البشر لا يتساوون فى سعيهم للمعرفة؛ فالكثيرون يتكاسلون اعتمادا على غيرهم، بل والبعض يقاومون تلك المعرفة العلمية الضرورية مقاومة شرسة. ترى ما الذى يجعل إنسانا يسعى إلى المعرفة وآخر لا يقدم على ذلك السعي؟ ما الذى يجعل إنسانا يحصل علي معرفة خاطئة بينة الخطأ، ومع ذلك يطمئن إليها ويستكين، وآخر يحصل علي معرفة لا تخلو من صواب، ومع ذلك لا يكف عن محاولة تطويرها وإعادة اختبارها وإمعان النظر فيها؟
ليس ثمة ما يفسر ذلك، إلا أن المعرفة فى النهاية عملية صراع. صراع مع الجهل والتجهيل. صراع ـ شأنه شأن أى صراع آخر ـ تكتنفه نذر الإخفاق والفشل، وتلوح له بشائر النجاح والتوفيق.
وإذا كان الجهل خطرا يهدد قوى التنوير بالإخفاق، فإن التجهيل ـ أعنى فرض المجهلة ـ أشد خطورة وتهديدا. فالجهل بالشيء لا يعنى بالضرورة كفًا لمحاولات معرفته، ولا يفرض قيدا على تلك المحاولات، بل لعله يكون دافعا ـ وغالبًا ما يكون كذلك بالفعل ـ لبذل المزيد من محاولة المعرفة. أما التجهيل فتتمثل خطورته فى كونه محاولة مقصودة للإيهام بالمعرفة أو لتوهم المعرفة.
محاولة يتعرض لها الإنسان من قبل الآخرين ممن يحاولون الحيلولة بينه وبين السعى للمعرفة وتحصيلها، فلا يجدون أفضل من إيهامه بأنه يعرف، فينتفى قلقه، ويطمئن لذلك ويستكين. عازفًا عن بذل محاولة جديدة للمعرفة تكلفه جهدًا وقلقًا. ويمضى متمسكًا بما يعرفه، أو بما يتوهم أنه يعرفه رافضًا التخلى عنه.