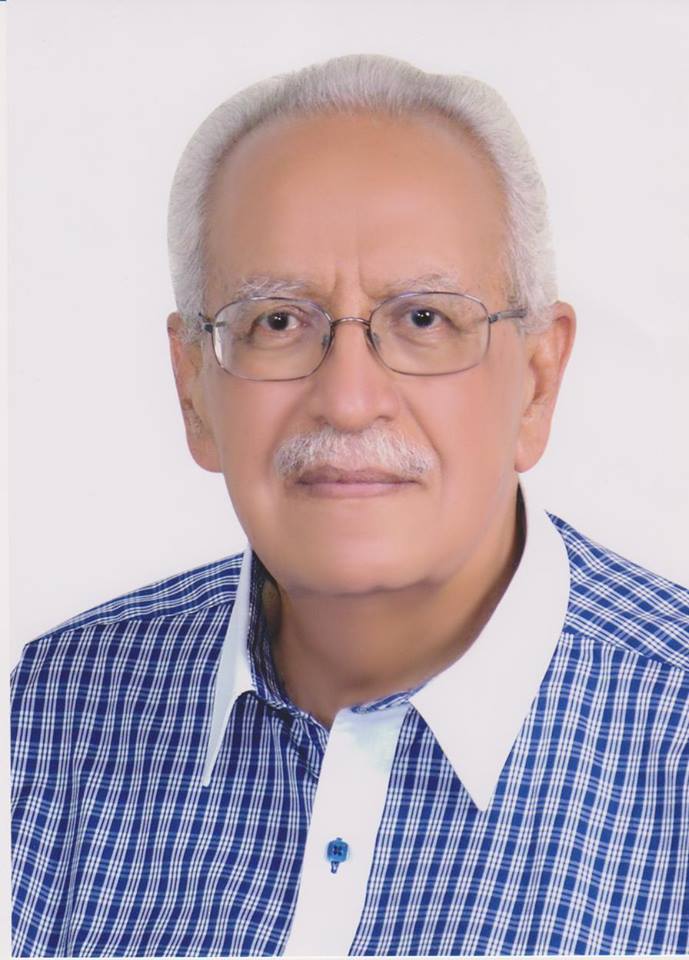تفيض دراسات علم النفس الاجتماعى وعلم النفس السياسى، على السواء بالعديد من الدراسات عن «المنتصر» و«المهزوم»، ولعل أهم ما يعنينا من نتائج تلك الدراسات، نتيجة مؤداها أن المنتصر يحرص على مواجهة المهزوم وتذكيره بهزيمته، وتذكير نفسه بانتصاره عليه، فى حين أن «المهزوم»، كما نقولها فى لغتنا اليومية «لا يستطيع أن يرفع عينيه فى وجه المنتصر».
وإذا كان أهل الاختصاص فى الأمور العسكرية يحسبون الهزيمة والنصر بمؤشراتها المادية ونتائجها الملموسة على الأرض، فإن علماء النفس يتحدثون عن الوعى بالهزيمة مقابل الوعى بالانتصار، واضعين فى اعتبارهم ومن واقع تخصصهم أيضا تأثيرات عمليات تزييف الوعى التى قد ترسخ لدى المهزوم وعيًا مصنوعًا أو زائفًا بالانتصار، كما أنها قد ترسخ لدى المنتصر وعيًا زائفًا بالهزيمة.
تذكرت ذلك حين نشرت صحيفة المصرى اليوم فى عددها الصادر فى ٢ أكتوبر ٢٠٠٤ مقابلة مع واحد من أبطال حرب أكتوبر هو «النقيب يسرى عمارة» الذى يؤكد أن «أعظم أيام حياته كان يوم الاثنين الموافق الثامن من أكتوبر العظيم» تاريخ تمكنه مع زملائه من أسر العقيد عساف ياجورى قائد اللواء المدرع ١٠١ بالجيش الإسرائيلى.
ويمضى ضابطنا المنتصر فى عرض رائع لتفاصيل خبرته، ليقول إنه فوجئ أيام احتفال مصر بمرور ربع قرن على هذا النصر المبين برئيس جامعة القاهرة يدعوه لمقابلته، ولم يتمكن من الحضور فى الموعد ثم علم أن عساف ياجورى أسيره السابق كان يريد مقابلته. ويعلق ضابطنا المنتصر قائلا: «حمدت الله تعالى أنى لم أره، لأننى أكره مقابلته، لكراهيتى لإسرائيل فبعد المعاناة فى ١٩٦٧، والدماء التى سالت ليتحقق النصر، ما كان لى أن أقابل عدوى مهما ادعى السلام وادعى أنه جار، لأن العدو لا يزال عدوًا... إننى لا أوافق على التطبيع الذى يريدونه».
من الطبيعى أن يتبادل المنتصر والمهزوم الكراهية، ومن الطبيعى أن تدفع تلك الكراهية كليهما إلى الحذر من الآخر، ولكن فى النهاية يبقى المنتصر منتصرًا والمهزوم مهزومًا، وتبقى الحقيقة العلمية التى تقول إن خبرة اللقاء المباشر تكون أليمة للمهزوم ولا تكون كذلك بالنسبة للمنتصر. ترى لماذا إذن رفض ضابطنا المنتصر لقاء أسيره السابق؟
إن ضابطنا المنتصر موقن دون شك، ومن واقع خبرته الشخصية المباشرة أنه منتصر، ولكن هل تراه على نفس الدرجة من اليقين أننا انتصرنا. الفارق كبير بين الحالتين. لقد مارس البطل يسرى عمارة خبرة انتصار فعلى. مارسها بيديه، ورأى بعينيه عساف ياجورى يستسلم للأسر.
ولكن السؤال هو: هل أدت هذه الخبرة الشخصية الحقيقية العظيمة إلى انتهاء ثقافة الهزيمة وسيادة ثقافة الانتصار؟
لماذا لم يسع بطلنا لمواجهه عساف ياجورى أسيره السابق، ليقول له مثلا «كيف تدعون السلام وتصنعون ما تصنعون فى فلسطين؟ متي تستوعبون درس أكتوبر؟ منى تعرفون أن القوة مهما بلغت لا يمكن فى النهاية إلا أن تنكسر أمام مقاومة أصحاب الحق؟». لقد نجحنا فى التقليل من حجم انتصارنا، بل وشكك بعضنا فى قيمته، وكان طبيعيًا أن يسعد المهزومون بمن يقدم لهم ثقافة الانتصار على طبق من فضة لنتبادل الأدوار: ليتخلص الإسرائيليون من ثقافة الهزيمة، وهم أصحاب «لجنة أجرونات» التى اعترفت بهزيمتهم فى حرب يوم الغفران، وأصدرت تقريرها المشهور عن التقصير، ولنتمسك نحن أصحاب انتصار أكتوبر بثقافة الهزيمة.
ولكن كيف تمت عملية تبادل الأدوار المصطنعة هذه؟ لقد بدأت نذرها عشية انتهاء الحرب وبداية مفاوضات التسوية، وبدأ تبادل الهمسات بين النخبة بأننا حيال «حرب تحريك» و ليست «حرب تحرير» وتحولت الهمسات إلى صراخ مع زيارة السادات لإسرائيل وانزوت الأضواء عن انتصار أكتوبر لتتجه إلى إدانة نتيجتها المتمثلة فى «التطبيع مع العدو الإسرائيلى»، وابتلعنا طعم «الدعوة للتطبيع» الذى روجت له أجهزة الدعاية الإسرائيلية، ورفعنا فى مقابله «شعار المقاطعة»، وتحول الحذر الواجب من ممارسات إسرائيل إلى ممارسة عملية لثقافة الهزيمة، حتى أنه حين اعترف الضابط الإسرائيلى بيرو بأنه قد أقدم وزملاؤه على دفن الجنود المصريين الأسرى أحياء فى حرب ١٩٦٧ تحرجنا أن نقيم معه اتصالًا مباشرًا يدعم سعينا لإدانة ممارسات إسرائيل دوليًا، وحين يأتينا بعض رموز عرب ٤٨ تتم مقابلتهم فى حدود ضيقة وعلى حذر وخجل متبادل من الطرفين، حرج من جانبنا لأنهم فى النهاية يحملون جوازات سفر إسرائيلية، وحرج من جانب بعضهم أيضا لأننا وقعنا معاهدة كامب ديفيد التى تعترف بإسرائيل.
إن الصراع الحضارى مع إسرائيل سوف يستمر حتى بعد إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية والسورية. إنه صراع الجيران جغرافيًا، المختلفين حضاريًا وسكانيًا. صراع أصحاب التاريخ الطويل الدامى. والطرف الذى لا يمارس دورًا فعالًا فى مثل هذا الصراع، يغامر بفقدان مستقبله المستقل، بل إن الاستمرار غير المتوازن لذلك الصراع الحضارى يحمل فى طياته نذر العنف وتجدد الحرب.
وللحديث بقية