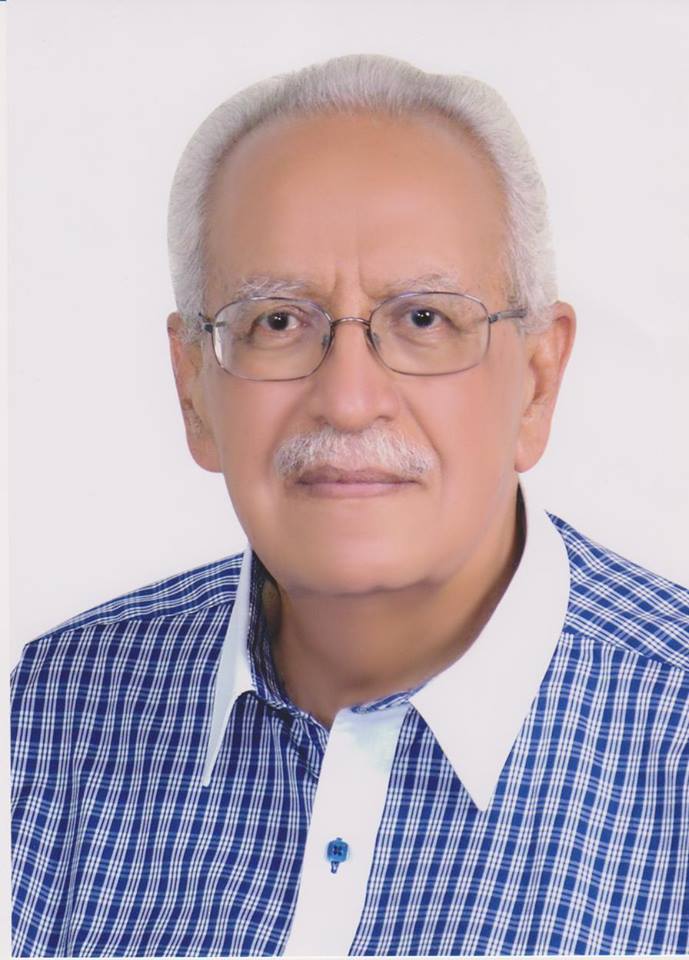لندع الرؤية الإسرائيلية جانبا بشكل مؤقت، ولننظر إلى أنفسنا، لقد كنت شخصيا شاهدا على ما جرى باعتباري متخصصا فى علم النفس وأيضا باعتباري مصريا عربيا مهموما بما يجري للوطن.
منذ هزيمة ١٩٦٧ وحتى الآن لم تنقطع علاقتي بمجريات صراعنا مع إسرائيل.
ما زلت أذكر بكثير من الخجل كيف لم تحتل إسرائيل مركزا بارزا فى اهتماماتي قبل ذلك التاريخ؟ كيف لم أتمكن من رؤية الحجم الحقيقي للخطر؟ وأتذكر أيضا بنفس الخجل مدي تفاؤلي بمجريات مواجهتنا مع إسرائيل فى الأيام الأولي لحرب١٩٦٧، وأذكر كذلك كيف تلاشي ذلك التفاؤل الساذج مع بداية نذر الهزيمة، وكيف تحول الخجل إلى إحساس ثقيل بالتقصير فى الفهم وفى الفعل على حد سواء. وبدأ تساؤل مؤلم يلح علىّ كما ألح على غالبية أبناء جيلي: لماذا لم نفهم؟ لماذا لم نتوقع ما حدث؟ والأهم من ذلك وماذا بعد؟
ومضيت أتابع ما يجري على ساحة الصراع من وقائع حرب الاستنزاف إلى أيام الانتصار فى أكتوبر ١٩٧٣ إلى أن ألقي الرئيس السادات خطابه الشهير الذي أعلن فيه استعداده لزيارة القدس، ثم ما لبث أن تحدد موعد للزيارة. كنت آنذاك أشغل وظيفة مستشار منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) فى دولة البحرين، ولم أستطع البقاء بعيدًا فقبلت دعوة كريمة من الأصدقاء فى مركز التخطيط التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية فى بيروت لمناقشة احتمالات قيام الرئيس السادات بزيارة القدس، وتصادف أن وصلت إلى بيروت صباح يوم زيارة الرئيس السادات للقدس، السبت الموافق ١٩/ ١١/ ١٩٧٧، وشهدنا على شاشات التليفزيون فى مركز التخطيط، نزول الرئيس السادات فى مطار بن جوريون فى إسرائيل. ثم تحولنا إلى التليفزيونات العربية نتابع المظاهرات التي تدين الزيارة، وأصوات المعلقين الإعلاميين يطلقون عليها ما شاءوا من صفات مثل «الصاخبة» و «الهادرة» و«الجماهيرية» و«الغاضبة» ... إلى آخره. وكان إلى جواري صديق العمر رءوف نظمي الذي عرف باسمه الحركي فى الثورة الفلسطينية «محجوب عمر»، وهو من المصريين الذين وهبوا حياتهم للثورة الفلسطينية.
ووجدتني أتساءل: «تري كيف نصنف هذه المظاهرات وفقًا للتصنيف الشائع؟ أهي مظاهرات كادر محترف منظم أم مظاهرات جماهير تلقائية مندفعة؟» وكان الأمر غنيًا عن البيان، فأمامنا مظاهرات تسير فى الشوارع، وعلى الأرصفة يقف على الجانبين الجمهور. وتذكرت على الفور تلك المظاهرات التي شهدتها مصر يوم وفاة عبد الناصر حيث لم يكن هناك متظاهرون، وواقفون على الأرصفة. لقد توقعنا رد فعل أعنف من ذلك بكثير.
عدت إلى البحرين أبحث عن تفسير لما جري ويجري من أحداث، محاولا أن أتابع كغيري ما ينشر عن التحركات الرسمية للمسئولين وكتابات المثقفين المتخصصين، وأتابع فى نفس الوقت من موقعي كمتخصص فى علم النفس ردود فعل الناس فى الشارع العربي. وتتابعت الأحداث إلى أن تم توقيع معاهدة كامب ديفيد فى ٢٦ مارس ١٩٧٩. كنت خلال ذلك الوقت أعيد حساباتي لما جري، مركزًا على المستقبل. وبدأت آنذاك بلورة رؤيتي ومناقشتها فى خطاباتي المتبادلة مع عدد من الأصدقاء المهتمين بالموضوع، وانتهيت من صياغتها فى أكتوبر ١٩٨٢، أي بعد شهور من انسحاب إسرائيل من سيناء. واخترت لها عنوانا يلخص مضمونها وهو «السلام الهجومي».
أشرت فى تلك الورقة القديمة إلى أن توقيع معاهدة كامب دافيد لا يمكن بحال أن يكون نهاية للصراع، بل إنه بداية لمرحلة جديدة من مراحل ذلك الصراع. بداية تختلف اختلافًا جوهريًا عن مراحل الصراع السابقة، ويتمثل هذا الاختلاف الجوهري فى بروز إمكانية جديدة لاكتساب الصراع طابعًا جماهيريًا حواريًا، بعد أن كان قاصرًا أو يكاد على الطابع السلطوي النخبوي العسكري. أي أن التوقيع على معاهدة كامب ديفيد لم يكن قرارًا بإغلاق ملف قضية الصراع العربي الإسرائيلي، ولم يكن حكما نهائيا فيها بل كان قرارا بإحالة القضية برمتها إلى الجماهير.
الأهم من كل ذلك بالنسبة للمستقبل، هو تأثير ما جرى على الجماهير العربية ودورها فى الصراع، وهو دور تميز عبر تاريخ الصراع بغلبة الطابع السلطوي العسكري على الطابع الجماهيري الحواري. كان ذلك هو الأمل آنذاك، وحين أنظر إليه اليوم، ينتابني شعور غريب متناقض، ما زلت مقتنعًا بأساسيات ذلك الأمل، أمل السلام الهجومي، بل وبإمكانية تحقيقه، وفى نفس الوقت، فإنني أدرك أن ذلك الأمل محاصر عربيًا وإسرائيليًا، وأن ثقافة الهزيمة تكاد تلتهم انتصارات أكتوبر. لقد حققنا انتصارًا عسكريًا فى أكتوبر ١٩٧٣، ولكن هل انتهت بذلك الانتصار ثقافة الهزيمة، أعني هزيمة ١٩٦٧؟
وللحديث بقية