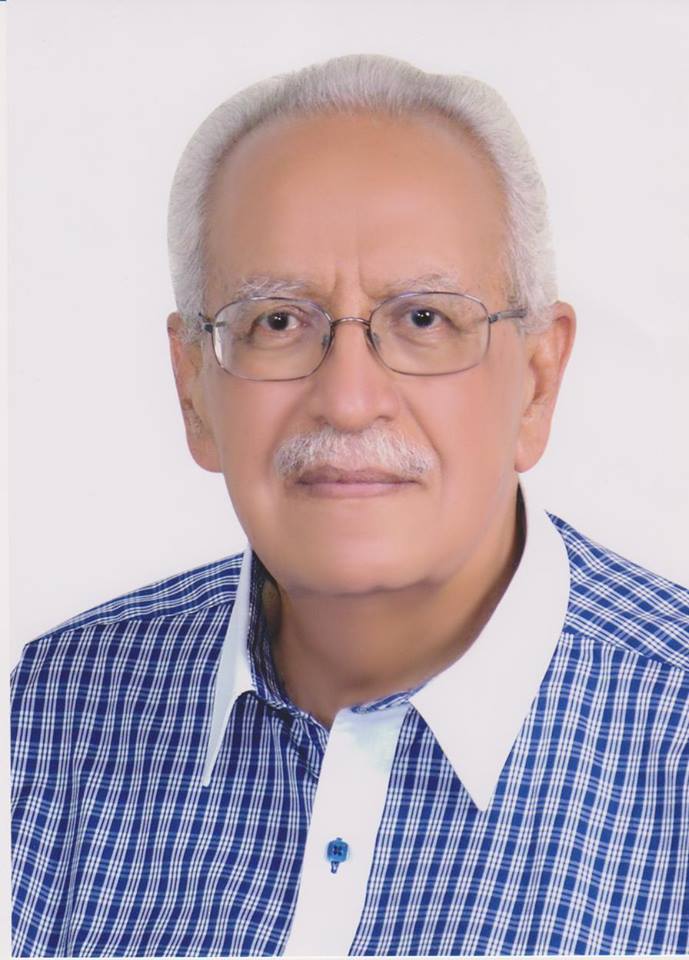حين تلقيت دروسى الأولى فى القياس النفسى، وعندما مارست حرفتى بمصلحة الكفاية الإنتاجية كمتخصص فى تصميم اختبارات ومقاييس القدرات والاستعدادات المهنية، كنا نستخدم عبارة «لقد انكسر الاختبار» للإشارة إلى أن واحدا أو أكثر من التلاميذ قد حصل فيه على الدرجة النهائية، ويصبح علينا تعديل ذلك الاختبار المكسور برفع سقفه - أى بزيادة صعوبته - بحيث يصبح أكثر قدرة على التمييز باعتبار أن من حصلوا على الدرجة النهائية، لا يمكن التمييز بينهم، فضلا عن أن «الدرجة النهائية» تجعلنا من الناحية الفنية غير قادرين على تحديد «الدرجة الحقيقية» التى يستحقها التلميذ.
استعدت تلك الذكرى القديمة حين التقيت منذ سنوات فى إسطنبول بأحد خبراء التربية الأتراك، يسألنى عن أمر بدا له مستعصيًا على الفهم «لقد قرأت فى إحدى الإحصائيات التربوية المصرية أن بعض الطلاب يحصلون على ما يتجاوز ١٠٠٪ من درجات الامتحان، وتأكدت أن الرقم صحيح وليس خطأ مطبعيًا. ترى هل ابتكرتم قاعدة رياضية جديدة تسمح بأن تكون قيمة البسط أكبر من قيمة المقام»؟ وبطبيعة الحال عجزت عن التفسير المنطقى.
استعدت كل ذلك، وأنا أتابع تلك المشاهد التى تكاد تنفرد بها مصر خلال فترة الامتحانات: أمهات يتزاحمن على أبواب المدارس فى انتظار انتهاء بناتهن وأبنائهن من أداء الامتحانات، وخاصة امتحانات الثانوية العامة. وعناوين الصحف تحمل صور أبنائنا وبناتنا يصرخون من صعوبة الامتحانات ويطالبون بالرحمة فى التصحيح. وغالبا ما تصدر تأكيدات المسئولين سنويا بأن «الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط» بما يعنى أن الطالب فوق المتوسط يستطيع أن «يكسر الامتحان». وإذا كان من ملمح إيجابى فى تلك الصورة فهو أن الأسرة المصرية وخاصة محدودة الدخل تقاتل من أجل حصول أبنائها على أعلى الشهادات، والشهادة تعنى لغويا أن الموقع عليها يشهد بأن صاحبها قد توافر لديه القدر المطلوب من الخبرة فى مجال معين، أو بعبارة أخرى أنه مؤهل لإتقان عمل معين.
ولعل ذلك الموقف يعود بذاكرة أبناء جيلى إلى سنوات بعيدة حين كانت الأسرة محدودة الدخل تدفع بابنها إلى «أسطى» يتعلم على يديه حرفة معينة، وكثيرا ما كانت الأسرة تلوم الأسطى إذا لاحظت أن عمل ابنها يقتصر مثلا على تنظيف الدكان وإحضار الطعام للعمال؛ فإذا ما احتج الأسطى بأنه يجاملهم ولا يريد إرهاق ابنهم، تكون توصية الأسرة حفز الأسطى على تدريبه حتى لو اقتضى الأمر عقابه ومن هنا انتشرت ظاهرة «الولد بلية» أو مشروع الأسطى الصغير الذى سرعان ما يصبح أسطى ويستقل بورشته الصغيرة. الأسرة فى هذه الحالة لم تسع لحصول ابنها على مجرد شهادة من الأسطى، بل كان الهدف أن يتقن الصنعة بالفعل.
ترى لماذا أصبحت تلك الأسرة حين أتيح لها أن تدفع بابنها إلى التعليم تطالب بامتحان سهل وتصحيح أسهل؟ أظن أن ما تغير هو المناخ الاجتماعى السياسى المحيط بسوق العمل.
لقد كانت الدولة فى حقبة الستينات تتولى مسئوليتى التعليم والتوظيف: من يحصل على شهادة يتم تعيينه فى وظيفة يستحيل بعدها أن يفصل إلا إذا انخرط فى نشاط سياسى معادٍ للنظام، ويظل يترقى فى وظيفته بصرف النظر عن مدى إتقانه لعمله، وكان من المنطقى آنذاك أن يكون الهدف النهائى هو الحصول على شهادة. ورغم ذلك فقد كانت الشهادة آنذاك أكثر مصداقية حيث كانت قاعات الدراسة أقل كثافة وكان التعليم أكثر انضباطا وجدية.
ولكن دوام الحال من المحال. لقد توقفت الدولة عن توظيف الخريجين، وتقلص القطاع العام، وأصبح القطاع الخاص هو المسيطر على غالبية فرص العمل. وللقطاع الخاص فلسفته الخاصة فى اختيار العاملين بحيث يحقق أعلى ربحية ممكنة، ولذلك فإنه يهتم أول ما يهتم بدرجة إتقان العامل لعمله، وليس بالمستوى الذى تقرره الشهادة التى يحملها. ومع تزايد ازدحام الفصول، وما طرأ على العملية التعليمية من قصور لسنا بصدد تفصيل القول فيه، ومع الإلحاح الجماهيرى والاستجابة الحكومية لتيسير الامتحانات؛ اتسعت الفجوة بين الحصول على الشهادة وإتقان العمل. لقد أصبح حصول الطالب على الشهادة لا يعنى بالضرورة إتقانه للتخصص الذى تدل عليه تلك الشهادة.
وبدأنا فى مواجهة عدة ظواهر مترابطة:
زيادة أعداد خريجى الجامعات الذين لا يجدون عملًا، حيث تضاءلت فرص التعيين فى وظائف الحكومة والقطاع العام، وفى نفس الوقت فإنهم غير مؤهلين للعمل فى القطاع الخاص.
تدهور «قيم العمل» التى تتمثل فى الحرص الذاتى على الإتقان، والالتزام الدقيق بالوقت، وتكريس كامل وقت العمل، للعمل فحسب، والاتجاه الإيجابى نحو العمل، والتوافق مع تعديل أوقات وظروف العمل، فضلا عن القابلية لتعلم الجديد، والثقة فى الذات، والحرفية المهنية، والولاء للمؤسسة.
السعى الحثيث لاستيراد العمالة الأجنبية التى تقبل بشروط العمل فى القطاع الخاص، وتتوافر فيها «قيم العمل» وعلى رأسها الحرص على الإتقان.
ترى هل يمكن أن تكون لدينا شجاعة مصارحة أبنائنا بأن تيسير الامتحانات والتصحيح رغم ما ينجم عنه من سعادة فإنها سعادة وقتية زائفة، وأن الشهادات التى نمنحها لهم وفقا لذلك النظام لا تزيد كثيرا علي رخصة قيادة مزيفة يحصل عليها بطريقة أو بأخرى من لا يعرف القيادة، ومن ثم لا يكون أمامه إذا ما صدق الشهادة التى يحملها إلا أن يقدم على كارثة قد تدمره شخصيًا.
استعدت تلك الذكرى القديمة حين التقيت منذ سنوات فى إسطنبول بأحد خبراء التربية الأتراك، يسألنى عن أمر بدا له مستعصيًا على الفهم «لقد قرأت فى إحدى الإحصائيات التربوية المصرية أن بعض الطلاب يحصلون على ما يتجاوز ١٠٠٪ من درجات الامتحان، وتأكدت أن الرقم صحيح وليس خطأ مطبعيًا. ترى هل ابتكرتم قاعدة رياضية جديدة تسمح بأن تكون قيمة البسط أكبر من قيمة المقام»؟ وبطبيعة الحال عجزت عن التفسير المنطقى.
استعدت كل ذلك، وأنا أتابع تلك المشاهد التى تكاد تنفرد بها مصر خلال فترة الامتحانات: أمهات يتزاحمن على أبواب المدارس فى انتظار انتهاء بناتهن وأبنائهن من أداء الامتحانات، وخاصة امتحانات الثانوية العامة. وعناوين الصحف تحمل صور أبنائنا وبناتنا يصرخون من صعوبة الامتحانات ويطالبون بالرحمة فى التصحيح. وغالبا ما تصدر تأكيدات المسئولين سنويا بأن «الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط» بما يعنى أن الطالب فوق المتوسط يستطيع أن «يكسر الامتحان». وإذا كان من ملمح إيجابى فى تلك الصورة فهو أن الأسرة المصرية وخاصة محدودة الدخل تقاتل من أجل حصول أبنائها على أعلى الشهادات، والشهادة تعنى لغويا أن الموقع عليها يشهد بأن صاحبها قد توافر لديه القدر المطلوب من الخبرة فى مجال معين، أو بعبارة أخرى أنه مؤهل لإتقان عمل معين.
ولعل ذلك الموقف يعود بذاكرة أبناء جيلى إلى سنوات بعيدة حين كانت الأسرة محدودة الدخل تدفع بابنها إلى «أسطى» يتعلم على يديه حرفة معينة، وكثيرا ما كانت الأسرة تلوم الأسطى إذا لاحظت أن عمل ابنها يقتصر مثلا على تنظيف الدكان وإحضار الطعام للعمال؛ فإذا ما احتج الأسطى بأنه يجاملهم ولا يريد إرهاق ابنهم، تكون توصية الأسرة حفز الأسطى على تدريبه حتى لو اقتضى الأمر عقابه ومن هنا انتشرت ظاهرة «الولد بلية» أو مشروع الأسطى الصغير الذى سرعان ما يصبح أسطى ويستقل بورشته الصغيرة. الأسرة فى هذه الحالة لم تسع لحصول ابنها على مجرد شهادة من الأسطى، بل كان الهدف أن يتقن الصنعة بالفعل.
ترى لماذا أصبحت تلك الأسرة حين أتيح لها أن تدفع بابنها إلى التعليم تطالب بامتحان سهل وتصحيح أسهل؟ أظن أن ما تغير هو المناخ الاجتماعى السياسى المحيط بسوق العمل.
لقد كانت الدولة فى حقبة الستينات تتولى مسئوليتى التعليم والتوظيف: من يحصل على شهادة يتم تعيينه فى وظيفة يستحيل بعدها أن يفصل إلا إذا انخرط فى نشاط سياسى معادٍ للنظام، ويظل يترقى فى وظيفته بصرف النظر عن مدى إتقانه لعمله، وكان من المنطقى آنذاك أن يكون الهدف النهائى هو الحصول على شهادة. ورغم ذلك فقد كانت الشهادة آنذاك أكثر مصداقية حيث كانت قاعات الدراسة أقل كثافة وكان التعليم أكثر انضباطا وجدية.
ولكن دوام الحال من المحال. لقد توقفت الدولة عن توظيف الخريجين، وتقلص القطاع العام، وأصبح القطاع الخاص هو المسيطر على غالبية فرص العمل. وللقطاع الخاص فلسفته الخاصة فى اختيار العاملين بحيث يحقق أعلى ربحية ممكنة، ولذلك فإنه يهتم أول ما يهتم بدرجة إتقان العامل لعمله، وليس بالمستوى الذى تقرره الشهادة التى يحملها. ومع تزايد ازدحام الفصول، وما طرأ على العملية التعليمية من قصور لسنا بصدد تفصيل القول فيه، ومع الإلحاح الجماهيرى والاستجابة الحكومية لتيسير الامتحانات؛ اتسعت الفجوة بين الحصول على الشهادة وإتقان العمل. لقد أصبح حصول الطالب على الشهادة لا يعنى بالضرورة إتقانه للتخصص الذى تدل عليه تلك الشهادة.
وبدأنا فى مواجهة عدة ظواهر مترابطة:
زيادة أعداد خريجى الجامعات الذين لا يجدون عملًا، حيث تضاءلت فرص التعيين فى وظائف الحكومة والقطاع العام، وفى نفس الوقت فإنهم غير مؤهلين للعمل فى القطاع الخاص.
تدهور «قيم العمل» التى تتمثل فى الحرص الذاتى على الإتقان، والالتزام الدقيق بالوقت، وتكريس كامل وقت العمل، للعمل فحسب، والاتجاه الإيجابى نحو العمل، والتوافق مع تعديل أوقات وظروف العمل، فضلا عن القابلية لتعلم الجديد، والثقة فى الذات، والحرفية المهنية، والولاء للمؤسسة.
السعى الحثيث لاستيراد العمالة الأجنبية التى تقبل بشروط العمل فى القطاع الخاص، وتتوافر فيها «قيم العمل» وعلى رأسها الحرص على الإتقان.
ترى هل يمكن أن تكون لدينا شجاعة مصارحة أبنائنا بأن تيسير الامتحانات والتصحيح رغم ما ينجم عنه من سعادة فإنها سعادة وقتية زائفة، وأن الشهادات التى نمنحها لهم وفقا لذلك النظام لا تزيد كثيرا علي رخصة قيادة مزيفة يحصل عليها بطريقة أو بأخرى من لا يعرف القيادة، ومن ثم لا يكون أمامه إذا ما صدق الشهادة التى يحملها إلا أن يقدم على كارثة قد تدمره شخصيًا.