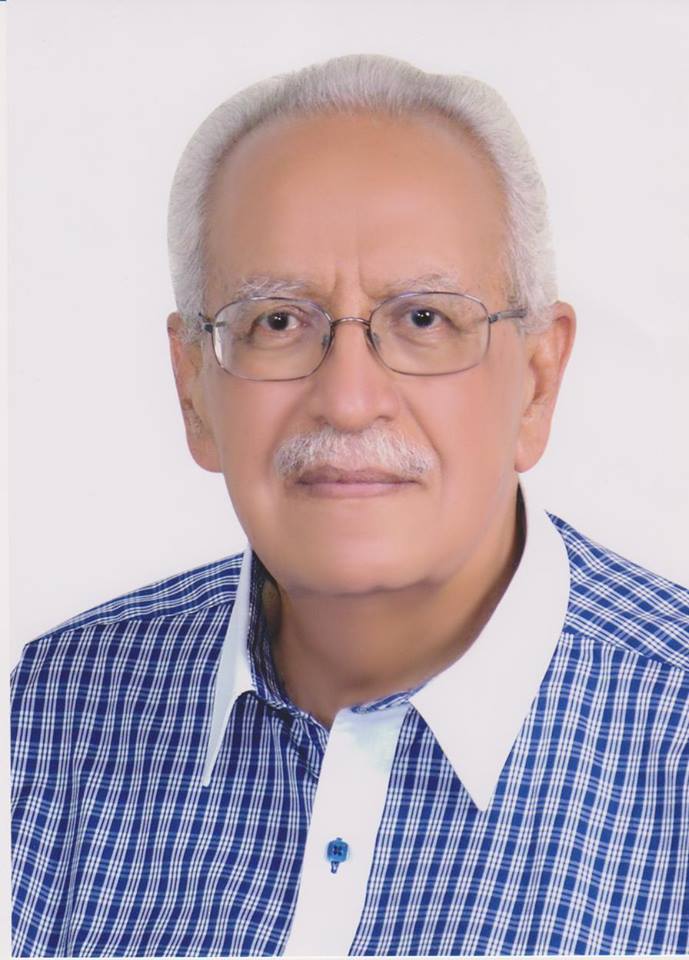لقد أعددنا أبناءنا - وليس الأزهريون باستثناءٍ فى هذا الصدد - على التلقى دون تيقن، فأفقدناهم ميزة إعمال العقل، ثم تناقضت أقوالنا مع أفعالنا فاهتزت مصداقيتنا لديهم فلم يعد لديهم سوى الاستسلام وهو ما لم يستطيعوه والأمر متعلق بالمقدسات الدينية، ولم يعد أمامهم سوى العنف وهو ما مارسوه دون تردد.
نحن إذن حيال رسالة تستدعى واقعة تاريخية، تعنى باختصار أن الإسلام فى خطر، وأن إنقاذه يتطلب عملًا فدائيًا استشهاديًا، وأن هذا العمل لا تستثنى منه إلى هنا والأمر لا يعدو أن يكون صيحة ينقصها من يقول لبيك. وقد لبتها بناتنا ثم لباها أبناؤنا طلاب الأزهر. ترى لماذا كانوا هم بالذات الأقرب للتلبية ؟ إنهم ببساطة الأقرب إلى فهم النداء بحكم تخصصهم، ومن ناحية أخرى فإنهم بحكم إقامتهم فى المدينة الجامعية فى مناخ يكفل قدرًا أكبر من التفاعل الاجتماعى المكثف، وفى ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية يعانى منها الشباب بعامة، وتلك الشريحة الشبابية بشكل خاص. فى ظل هذه الظروف تطور الأمر إلى ما تطور إليه. لقد التقط أبناؤنا الأزهريون الرسالة، وكانت استجابتهم الفورية التظاهر العنيف؟ وإذا كانت الاستجابة الغاضبة فى حد ذاتها ليست بالأمر المستغرب، فإن ثمة تساؤلات تطرح نفسها:
أولًا : ترى لماذا صدق أبناؤنا على الفور ودون تردد صاحب صيحة «من يبايعنى على الموت؟» ، دون بذل أى جهد للتيقن منها؟ إن ضرورة التيقن مما نسمع تتزايد بتزايد أهمية ذلك الذى نسمعه، وخطورة ما نحن بصدد الإقدام عليه نتيجة لذلك. فماذا إذا ما تعلق الأمر بالمقدسات الدينية، والدعوة للفداء فى سبيلها؟ أليس التيقن أوجب فى هذه الحالة؟ والتيقن من صحة ما نسمع لا يقتضى بطبيعة الحال المعاينة المباشرة للموضوع، بمعنى أنه لم يكن مطلوبًا أن يتم توزيع الرواية محل الجدل على الطلاب ليكونوا فيها رأيًا، فأساليب التيقن من صدق أية قضية متعددة معروفة ولسنا فى مجال عرضها تفصيلًا. منها مثلًا التيقن من مصداقية المصدر، ومن معقولية الرسالة، واللجوء إلى أكثر من مصدر لاستجلاء الموضوع إلى آخره.
ثانيًا: وحتى فى حالة التيقن من أن ثمة مساسًا بالمقدسات، لماذا كان العنف هو أول الخيارات وليس آخرها؟ لماذا لم يجربوا مثلًا المدرج المعروف من الاحتجاجات السلمية بدءًا من الرأى المضاد المكتوب، والاعتصام بدرجاته المختلفة، والإضراب بأنواعه المتعددة، والإعلان الجماهيرى عن الاحتجاج وصوره لا حصر لها؟
ولكن ترى هل نجرؤ على تحميلهم مسئولية ذلك أم أننا فى الحقيقة المسئولون قبلهم؟ لقد أعددنا أبناءنا - وليس الأزهريون باستثناءٍ فى هذا الصدد - على التلقى دون تيقن، فأفقدناهم ميزة إعمال العقل. ثم تناقضت أقوالنا مع أفعالنا فاهتزت مصداقيتنا لديهم، فلم يعد لديهم سوى الاستسلام وهو ما لم يستطيعوه والأمر متعلق بالمقدسات الدينية، ولم يعد أمامهم سوى العنف وهو ما مارسوه دون تردد.
واختتمت مقالى القديم مرددا:
«لقد كان العنف محدودًا هذه المرة وأمكن محاصرته والتقليل من حجم الخسائر المتوقعة. وساعد على ذلك أن بقية طلاب الجامعات منشغلون بامتحاناتهم. وأن المظاهرات لم تصل إلى أماكن تجمع سكانى. ولكن جذور ما حدث مازالت قائمة، وتكرار ما حدث بصورة أو بأخرى فى قطاع أو آخر من قطاعات الشباب أو غيرهم مازال واردًا. وكلما مضى الوقت ازدادت الاحتمالات ورودًا، وازدادت إمكانات الحل صعوبة، وازدادت المواجهة تكلفة».
لقد نبهت - ونبه غيرى - منذ سنوات طويلة إلى خطورة مثل تلك الانفجارات العنيفة التلقائية المفاجئة، منذ ما عرف باسم الأحداث المؤسفة فى بداية ١٩٧٤ والتى شاركت مع فريق من خبراء المركز القومى للبحوث الاجتماعية فى دراستها موضوعيًا، واقتراح سبل علاجها، إلى أحداث الزاوية الحمراء، إلى أحداث ميت نما، إلى الأحداث الأخيرة.
إن الخطر داهم تشير إليه الدراسات فضلًا عن الانطباعات، أعنى خطر الانفجارات العنيفة غير المخططة، وهى فيما أرى أشد خطرًا من الإرهاب المخطط، وهو خطر يهددنا جميعًا دون أن يستثنى أحدًا حتى ممارسيه أنفسهم. ومواجهة هذا الخطر مازالت ممكنة. وهى مواجهة قد لا تكلفنا أموالًا، ولكنها تقتضينا الكثير من معاناة القلق الحقيقى على مستقبل هذه الأمة، ومعاناة القبول بالتنازل عن الكثير من الطمأنينة الزائفة لمصداقيتنا لدى الأجيال الجديدة، ومعاناة الاعتراف بتقصيرنا والمواجهة الصادقة لأسباب هذا التقصير.
واختتمت مقالى باقتراح أن تعهد الدولة إلى لجنة من المتخصصين تتفرغ لوضع استراتيجية متكاملة لعلاج الجذور والأسباب، وأن تكون تلك الاستراتيجية المقترحة بعد مناقشتها بشكل ديموقراطى موسع ملزمة لجميع أجهزة الدولة المعنية.
وكانت العبارة الأخيرة التى اختتمت بها المقال: «ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد».
ولم يجد مقالى طريقه إلى النشر، حيث كان قرار الدولة إيقاف تناول الموضوع بدعوى التهدئة، ومرت سنوات طوال وظل فيها مقالى قابعًا حيث هو، وأصبحت المواجهة أكثر تكلفة.