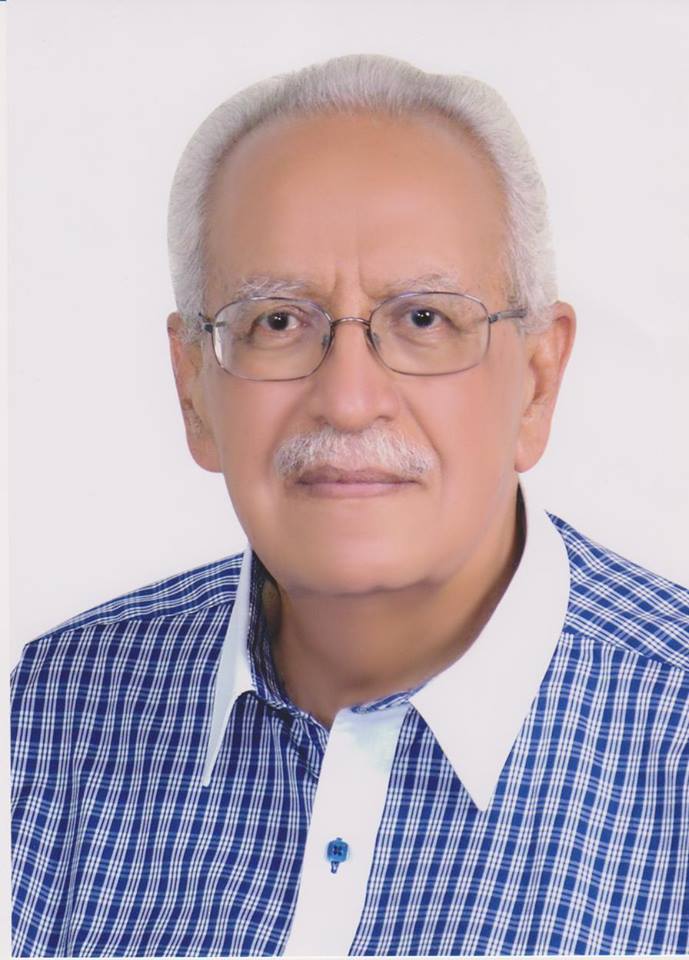حلت هذا الشهر ذكرى ثورة ٢٣ يوليو؛ ويحمل هذا الشهر ذكرى شخصية ترتبط بملمح من ملامح حقبة عبد الناصر؛ ففى ٢٥ يوليو ١٩٦٣ خرجت من المعتقل ومعسكر التعذيب لأواجه الحياة من جديد بعد ما يقرب من أربع سنوات. كان الاعتقال مختلفا آنذاك. لم نكن قد سمعنا عن مؤسسات حقوق الإنسان ولا عن ضرورة العرض على النيابة إلى آخره. كانت التفرقة واضحة صارمة آنذاك بين «المسجون السياسي» الذى صدر بحقه حكم قضائى ويخضع للائحة السجون التى تسمح بالزيارات واللجوء للقضاء تظلما، و«المعتقل السياسي» المحروم من جميع تلك الحقوق، حتى أنه لم يكن فى مقدور أسرته معرفة مكان احتجازه. وكلما هلت ذكرى يوليو وجدت نفسى أواجه سؤالا مهما: كيف يمكن تقييم «عصر عبد الناصر»؟ ذلك العصر الذى مازالت جماهير غفيرة من المصريين تحمل صور عبد الناصر كلما ضاقت بهم الحياة.
من الناحية المنهجية ينبغى الحذر من أن يندفع المرء تحت وطأة معاناته الشخصية وإدانته لسلبيات حقبة تاريخية إلى تجريد تلك الحقبة من أية إيجابية أو تلويث تلك الإيجابيات؛ ومن ناحية أخرى لا ينبغى أن يندفع المرء مدافعا عن الجماعة السياسية أو الفكرية التى ينتمى إليها إلى حد ألا يرى أخطاءها وأن يبرر خطاياها. مثل ذلك الموقف لا يعتبر خطأ منهجيا فحسب، بل هو أيضا خطيئة سياسية حيث يؤدى عمليا إلى تكريس تقديس رموز بشرية تاريخية، ومن ثم تبرير تكرار نفس الخطايا فى المستقبل. الدفاع عن الناصرية لا يعنى تبرير انتهاك الحريات وتعذيب المعتقلين إلى حد القتل، ومن ناحية أخرى فإن رفض الناصرية لا يعنى إدانة الانحياز للفقراء وبناء السد العالى إلى آخره.
المرء غير ملزم بالدفاع عن تاريخ جماعته التى ينتمى إليها وتنقية صفحتها مهما شهد ذلك التاريخ من مظالم. ليس علينا لكى ندافع مثلا عن تاريخنا الفرعونى ونفخر به، أن يقتصر حديثنا على ما يحفل به التاريخ الفرعونى من منجزات علمية وحضارية باهرة، دون أن نشير إلى تأليه أجدادنا لحكامهم. ولا يفرض علينا انتماؤنا للتاريخ الإسلامى أو المسيحى أن نركز على روحانية الدين وسمو القيم التى نادت بها الأديان وأن نطمس على تلك الدماء التى سالت فى معارك بين بشر يحملون رايات دينية ويزعمون أو حتى يؤمنون بأن قتالهم إنما هو دفاع عن التفسير الصحيح للعقيدة؟ بعبارة أخرى هل ثمة ما يبرر تنزيه بشر عن الخطأ بل وعن الخطيئة؟
لقد كانت تلك الحقبة الناصرية حافلة بالإنجازات والانكسارات. إنها الحقبة التى شهدت قرارات الإصلاح الزراعى وتأميم قناة السويس ثم تأميم الشركات الكبرى وبناء السد العالى، وهى أيضا الحقبة التى كرست سلطة الحزب الواحد، وهى ذات الحقبة التى شهدت للمرة الأولى فى تاريخ مصر تكريسا رسميا لفصل الذكور عن الإناث فى التعليم الجامعى بإنشاء كليات جامعة الأزهر وكلية البنات، وهى الحقبة التى شهدت قيام الوحدة المصرية السورية كما شهدت انهيارها، وهى الحقبة التى شهدت أعنف حملات اعتقالات تعذيب للمنتمين لجميع التيارات السياسية المعارضة، وهى الحقبة التى شهدت واحدة من المرات النادرة التى خرج فيها الجيش المصرى ليقاتل وتسيل دماؤه خارج حدوده الوطنية فى اليمن، حيث فقدنا ما يزيد علي ١٥ ألف شهيد، وهى الحقبة التى شهدت أيضا اختيار عبد الناصر لأنور السادات نائبا له بعد هزيمة ١٩٦٧ التى سالت فيها على أرض سيناء دماء ما يقرب من ١٠ آلاف شهيد. إنها حقبة شهدت ما هو إيجابى وما هو سلبى وما هو مثير للجدل؛ وكانت الحقبة بكل ما فيها تحمل اسم عبد الناصر وتحت مسئوليته.
ترى ماذا بقى من عبد الناصر بعد كل تلك السنوات يلهب حماس الجماهير، ويجعلها ترفع صورته وتهتف باسمه وتردد أغانى عصره فى كل مناسبة احتجاجية. لقد مضى عبد الناصر وانتهى عصره، ولم يعد ثمة إغراء بمنصب ولا تخويف بعصا، بل إن بعضًا ممن يهتفون باسمه ويرفعون رايته حتى اليوم أصابهم من عنت السلطة الناصرية الكثير.
ترى كيف حدث ذلك؟
لعل الاقتراب من هتافات المحتجين يكشف بيسر أنهم يرون فيه رمزا للعدل الاجتماعى ولطهارة اليد وللاستقلال الوطنى وللانحياز للفقراء بحيث تخفت لديهم ملامح الدكتاتور المتسلط.
ويبقى السؤال قائما: ترى ألم يكن ممكنا بناء السد العالى وتأميم قناة السويس والسعى نحو العدل الاجتماعى دون قهر أو تعذيب؟ وهل استمرار توهج صورة عبد الناصر يعنى أننا ما زلنا على استعداد لتقديم حريتنا قربانا للعدل الاجتماعى والتحرر الوطني؟ وهل تلك المقايضة حتمية؟ أى أننا لا نستطيع أن نحقق العدل الاجتماعى والتحرر الوطنى والحرية السياسية معا؟ هل ما زال الحلم بشعارات ثورة ٢٥ يناير ممكنا؟
أظن أن الحلم مازال ممكنا، واضعين فى الاعتبار أن مواجهتنا الشرسة للإرهاب وهى مواجهة موقوتة مهما طالت، قد تفرض علينا تأجيل الحلم دون نسيانه مع استمرار التذكير به من أجل المستقبل.
ينبغى الحذر من أن يندفع المرء تحت وطأة معاناته الشخصية وإدانته لسلبيات حقبة تاريخية، إلى تجريد تلك الحقبة من أية إيجابية أو تلويث تلك الإيجابيات.