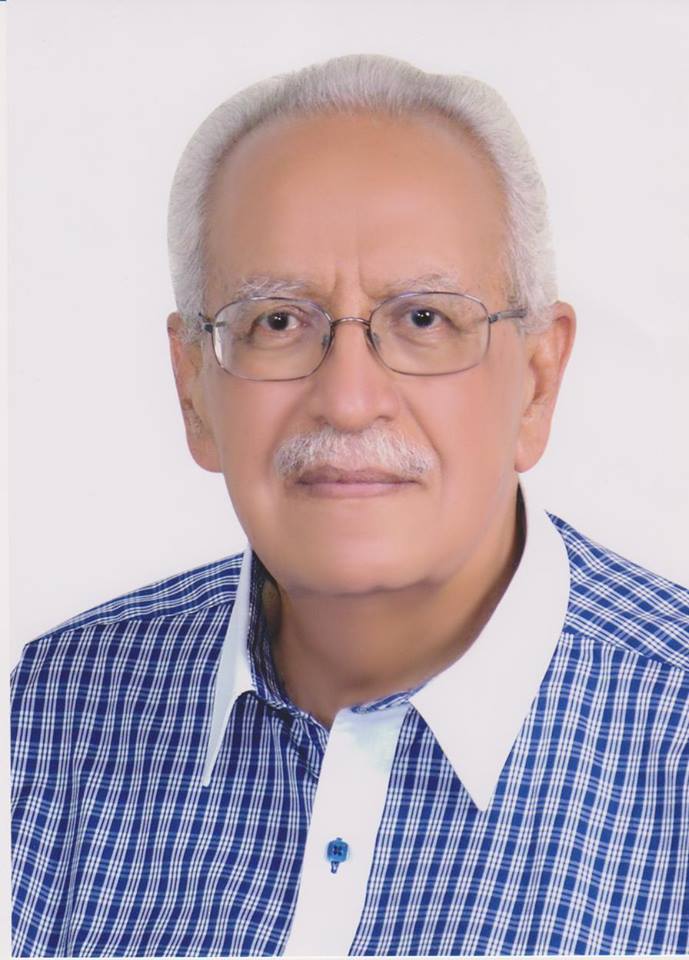لم يخل التاريخ البشري مطلقا من صراع حول الحرية، فلم يكف المحرومون من الحرية عن السعي لتحقيقها، وبالمقابل لم يكف أعداء الحرية عن مقاومتها، ولقد أحرز النضال الطويل من أجل الحرية مكسبا أساسيا، حيث أصبحت الحرية قيمة إيجابية لا يستطيع كائنا من كان أن يفصح عن عدائه لها مهما كانت درجة ذلك العداء، وأصبح أعداء الحرية يرددون في خضم ادعاءاتهم بالحرص عليها العديد من الحجج التي تؤدي جميعها في النهاية إلي وأد تلك الحرية.
وتتعدد تلك الحجج وتتباين فينادي البعض بضرورة أن نتفق أولا على المقصود بتعبير الحرية على وجه الدقة قبل أن نخطو خطوة واحدة في النضال من أجلها بحيث لا ننجرف إلي حيث لا نعرف أو لا نريد: ترى هل نقصد الليبرالية أم الديمقراطية أم الشوري؟ أو لعل في الأمر خبيئا فيكون المقصود العلمانية, وهل المقصود بالحرية حرية الفكر أم حرية الفعل؟ وهل هي حرية مطلقة بلا حدود أم حرية منضبطة منظمة، ومن الذي توكل إليه مهمة التنظيم والضبط؟
وقد يستمر ذلك الجدل المرهق زمنا طويلا و يستنزف من الجهد ما يضعف السعي من أجل الحرية أيا كان تعريفنا لها.
فإذا ما نجح المحرومون من الحرية في تجاوز منزلق الجدل حول التعريف, واجهتهم مشكلة أشد تعقيدا: إذا كانت الحرية مطلبا إنسانيا يتوق إليه البشر, فإنه بطبيعة الحال ليس المطلب الوحيد، فهناك أيضا مطلب لا يقل عنه إلحاحا هو العدل الاجتماعي. ومن هنا يبدأ الجدل الذي يدخل من خلاله أعداء الحرية طارحين تساؤلا قد يبدو بسيطا: ترى هل ينبغي البدء بالنضال من أجل الحرية, أم أن الأجدي هو السعي لتحسين الحياة من مشرب ومأكل وتعليم، ثم بعد ذلك يصبح الحديث عن الحرية ممكنا؟!.
ولعل ذلك الفكر هو أخطر التبريرات التي يتستر خلفها أعداء الحرية, حيث يؤكدون استحالة الحديث عن الحرية والنضال من أجلها إلا بعد أن يتم إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين, فالفقراء والجياع والمحرومون من التعليم ليسوا مؤهلين لممارسة الديمقراطية, فهم مشغولون دوما وأساسا بلقمة العيش, ولا يجدون فسحة من الوقت للحديث عن الحرية أو للاستماع لمن يتحدث عنها, فضلا عن عجزهم الموضوعي عن النضال من أجلها أو الدفاع عن منجزاتها. ومن ثم فدعوتهم للنضال من أجل الحرية لا تعدو أن تكون تضليلا لا يؤدي سوي إلي فوضي مجنونة مدمرة تتفتت معها الأمة إلي أحزاب تضلل الفقراء وتتاجر بآلامهم.
وغني عن البيان أنه مادام الأمر كذلك فلا مناص من البحث عن ديكتاتور يحقق العدل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، باعتبار أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا في مناخ يسوده النظام والاستقرار والهدوء بل الصمت, ويخلو من المهيجين ومثيري الشغب والاحتجاجات والمظاهرات, وفي يوم معلوم يقوم ذلك الديكتاتور العادل بمنح الحرية في الوقت الذي يراه مناسبا, والذي علمنا التاريخ أنه لا يأتي أبدا.
ولعلنا لا نبالغ إذا ما قلنا إن الديكتاتورية هي المدخل لجميع أنواع الظلم, وإن العدل هو القيمة الحاكمة لبقية القيم التي تضمن حياة البشر بل تحدد نوعية حياة الجماعات البشرية واستمرارها, وأن افتقاد الشعور بالعدل نذير لا يخطئ بأن الجماعة مهددة بالفناء, وليس بمستغرب إذن أن يكون هلاك الأمم والدول يرتبط بافتقاد العدل والانحياز لأصحاب القوة المادية أو المعنوية أو العددية في مقابل الدهماء والفقراء والضعاف والمهمشين
و لعلنا نتذكر في هذا المقام قولة ابن تيمية إن الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة, ولا يقيم الظالمة وان كانت مسلمة وإن الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام, ولو نظرنا إلي تاريخ الأمم البائدة, وتأملنا ما يجري في عالمنا لتأكدت لدينا حقيقة أن حيوية الأمم وصمودها واستقرارها ترتبط بدرجة ممارسة أبنائها للحرية وإحساسهم بالعدل.
العدل هو الطريق الأمثل للمعالجة الجادة لأخطر مشكلاتنا وعلي رأسها الفقر والفساد وتهديدات الوحدة الوطنية و الإرهاب. إن علاج تلك المشكلات وغيرها يقوم علي الالتزام بقواعد عادلة شفافة لاختيار الأكفأ, لشغل الوظائف, والالتزام بتلك القواعد في جباية موارد الدولة وتوزيعها, والالتزام بتطبيق عادل للقوانين دون انحياز للأكثر ثراء أو عددا أو نفوذا إلي آخره.
خلاصة القول إن العدل هو الحل, ولكن تظل الحرية هي السبيل لتحقيق العدل ولضمان استمراره وتصويب أي انحرافات تشوب تطبيقه, من خلال ضمان التعبير السلمي عن الإحساس بالظلم, وتنمية القدرة علي مقاومته بالوسائل السلمية.